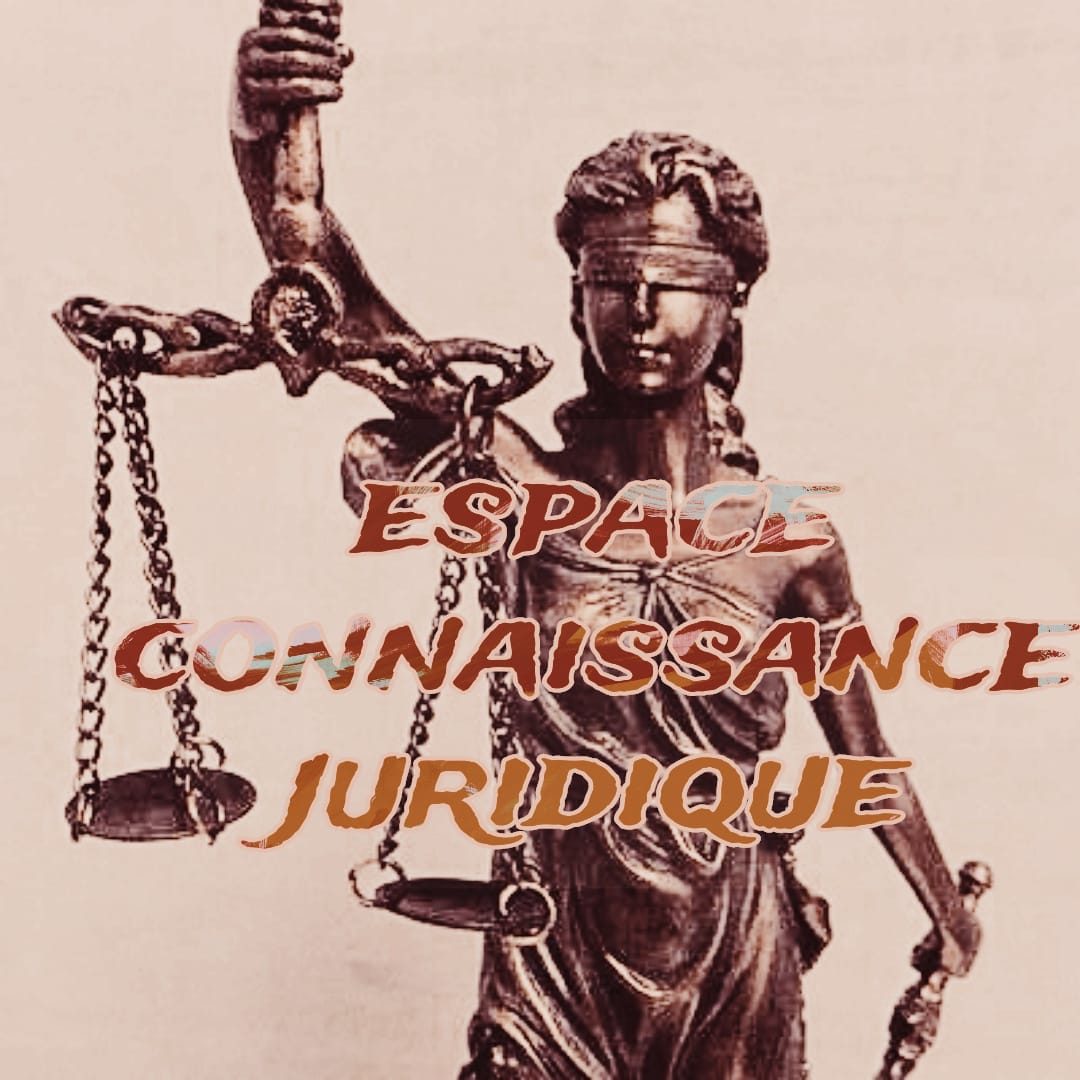دعوة للتطوير[**]
الأستاذ محمد القدوري
محام بهيئة الرباط
المراد بالمرافعة كل تدخل من المحامي في سبيل الدفاع عن قضية موكله أمام القضاء، سواء كان ذلك بالكتابة أو بالقول أو بالإشارة، وهي بهذا المعنى نوع من الخطابة، إلا أنها خطابة قضائية؛ ولهذا ينبغي أن تتصف بالتدقيق والوضوح والبيان وقوة الإقناع، دون إغفال للجانب القانوني للقضية، ومع الإحاطة بجانبها الإنساني.
ويتوقف إعداد المرافعة وإحكامها على إتقان أمرين هامين احدهما هو وقائع الدعوى، وثانيهما هو التكييف القانوني الذي ينبغي أن يعطى لها والنصوص التي يجب أن تنطبق على هذه الوقائع.
وعلى المحامي وهو يلخص وقائع الدعوى أن يركن في ذلك إلى امرين أو عنصرين:
العنصر الأول: هو الموكل الذي ينبغي للمحامي أن يشمع له بصبر وأناة ويحاول فهم ما يفضى به إليه؛ ومعاناتنا نحن المحامين في هذا المجال مضنية ومتعبة، لأن المحامي حين يستجوب موكله لا يفعل ذلك بشكل عشوائي، بل إنه يستحضر في ذهنه، قبل أن يلقي عليه أي سؤال، واثر تلقي أي جواب، الأفكار القانونية والفقهية المحيطة بالنازلة، ويستحضر العناصر القانونية للقضية، والاحتمالات التي يمكن أن تخضع لها أو أن تفضي إليها.
وربما اختلفت طريقة معالجة الوقائع في الدعوى الجنائية عنها في الدعوى المدنية، ففي الأولى يسمح بنوع من الفضفضة في الكلام مما يجعل على عاتق المحامي أن يتسلح بالصبر حتى ينتهي موكله من إفراغ ما يخالج صدره من الأحاسيس، ولا ضير عليه إن هو أنفق شيئا من وقته في هذا السبيل، وهذا على العكس من الدعاوي المدنية التي له أن يدعو فيها موكله إلى الاختصار وتجنب مالا جدوى منه من الأحداث والوقائع.
وغالبا ما لا يحسن الزبون سرد وقائع الدعوى فيعمد إلى خلطها بشكل فوضوي يتطلب من المحامي معاناة كبيرة من أجل ترتيبها وإعادة تركيبها حسبما يتطلبه الموقف.
وعلى المحامي أن يحذر من افتراض وقائع غير كائنة ومن القيام مقام موكله في الإفضاء بواقعة ما، بل عليه أن يترك أمر الوقائع إلى الزبون، حتى ما إذا كانت هناك واقعة في غير صالحه في الدعوى أحاطه علما بذلك ليتخذ الزبون بنفسه حيالها الموقف الذي يراه، فمن الخطأ أن ينوب للمحامي عن زبونه في خلق وقائع الدعوى.
العنصر الثاني: الذي يستخلص منه المحامي وقائع القضية هو وثائق الدعوى التي يتعين عليه أن يدرسها وثيقة وثيقة ويسبر أغوارها، ويقارن بينها وبين ما يفضى به إليه موكله حتى تكون أقوال الزبون مطابقة لوثائقه وحججه وكتاباته، والا فإن التناقض بين وقائع الدعوى ووثائقها سيؤدي إلى فساد القضية.
وغالبا ما يؤدي “استنطاق” الوثائق إلى اكتشاف أمور حاسمة في الدعوى، ربما لا يحسن الزبون التعبير عنها؛ بل ولربما لم يدركها.
وبصدد الوقائع ينبغي للمحامي أن يكون سرده لها واضحا لا غبار عليه، وعليه أن يرتبها ترتيبا زمانيا أو ترتيبا موضوعيا حسب ما يقتضيه مقام الدعوى، ويقتضيه سياق الشرح والتوضيح والبرهنة.
ومن المفيد التنبيه إلى الفرق بين وقائع الدعوى كما حصلت فعلا وبين إجراءاتها؛ ذلك أن البعض لا يكتب أو لا يملي وقائع الدعوى، وإنما يكتب أو يملي إجراءاتها؛ وهذه الطريقة غالبا ما تؤدي إلى التعقيد وسوء تصور النازلة، وقصور عن فهمها.
أما الجانب القانوني في إعداد المرافعة فهو الذي يقتضي من المحامي أن يدرس النازلة بعد أن يتصور وقائعها… ويغوص في التحليلات الفقهية والقضائية كي يستخلص الوصف الذي يليق بها، ليلبسها اللباس القانوني المناسب لها، وعليه أن يبذل في ذلك من المعاناة والمكابدة والصبر ما يجعل الحل القانوني يرتسم في ذهنه ارتساما يجعله متمكنا من القضية تمكنا يؤهله ليقنع بها غيره.
وهنا تجب ملاحظة أنه لا تلازم بين أهمية الدعوى وقيمتها المالية من جهة وبين أهميتها القانونية من جهة أخرى، فقد تحتاج دعوى بسيطة إلى دراسة قانونية معقدة ومستفيضة، والعكس صحيح، وعلى المحامي أن يخص كل قضاياه، بنفس الاهتمام ويبدد نظرية بعض الزبناء الذين قد يظنون أن اهتمام المحامي بقضاياه إنما يكون بقدر الأتعاب التي يتقاضاها عنها.
ومتى تم للمحامي هذان العنصران، أعني العنصر الواقعي والعنصر القانوني، صار عندئذ أهلا لخوض غمار معركة المرافعة قولا وإشارة أو كتابة، وتمكن حينئذ من المدافعة والاستنصار والإقناع؛ ومن أجل تحقيق الغاية المتوخاة من المرافعة لابد من عناصر أهمها: الصدق، وحسن التعبير، وجميل التحليل القانوني والواقعي والعلمي والاجتماعي.
- فأول ما يجب على المحامي أن يكون صادقا، لا يطرق بابا لكذب ولا ينهج سبيله، وهذا هو المنهج أو هذه الصفة واجبة في القضايا المدنية بشكل لا تهاون فيه، وكذا في القضايا الزجرية إلى حد كبير.
ذلك أنه في القضايا الزجرية لا يمكن أن يكون المحامي إلا في إحدى وضعيات ثلاث: إما مقتنعا ببراءة موكله، أو مومنا على النقيض من ذلك بإدانته، أو شاكا في الأمر.
ففي حالة اقتناعه بالبراءة عليه أن يستميت في نقل اقتناعه هذا إلى هيئة القضاء.
أما في حالة إيمانه بالإدانة فما عليه إلا أن يجنح إلى التماس ظروف التخفيف دون مراوغة، إلا أن يلوذ المتهم بالإنكار الصريح القاطع فإن المحامي في هذه الحال لا يستطيع أن يقر عوضا عن موكله، بل ينبغي له أن يلتمس براءته، لأن واجبه والتزامه بالسر المهني يحتمان عليه ذلك، ويجعل طلب تمتيعه بظروف التخفيف طلبا احتياطيا.
أما في حالة الشك فما على المحامي إلا أن يقنع المحكمة بما هو واقع فيه من التردد والحيرة، وفي ذلك براءة لموكله عملا بمبدأ وجوب تفسير الشك لصالح المتهم.
- وأما السمو أو النبل فهي صفة تفرض على المحامي أن يكون لبقا في عباراته متجنبا الفحش من القول والمستهجن من الكلام، باذلا أقصى غايته لاحترام موكله واحترام خصمه واحترام زملائه واحترام هيئة القضاء واحترام الجمهور كذلك.
ليس من شك في أن طبيعة الخطابة قد تجر المحامي إلى نوع من السخرية في بعض الأحيان أو إلى جانب من التلميح والتعريض أحيانا أخرى، ولكن ذلك ينبغي أن لا يخرج عن نطاق المروءة وحدود اللياقة والمعقول، ودائرة الضرورة.
وفي كل هذا، أي في جانبي السمو والسخرية، على المحامي أن يتحلى بنفس طويل وبلاغة رصينة.
- أما جانب التحليل القانوني أو الجدل المقنع فهي الخاصية التي توجب على المحامي أن يفسر الشيء بضده ويسوق الدليل تلو الدليل ليسمو بالهيئة القضائية إلى الاقتناع والرسوخ وليعمل على إعانة القضاة لاقتناص الحقيقة واقع الدعوى.
وعلى المحامي أن يبتعد عن الاصطناع والتمثيل والمراوغة ويلوذ بالرزانة والرصانة ويكون مثالا في حسن الخلق وفي حسن الأداء، وأن يكون ذكيا بالقدر الذي يؤهله للتقلب دفاعا عن مصالح موكله وفق ما توجبه عوارض الدعوى.
وعليه أن لا يتقمص دائما شخصية موكله فيبرز من كلامه بعض ما قد يكنه ذلك الموكل من عداء لخصمه، بل عليه دائما أن يتحلى برباطة الجأش وهدوء البال والعقل، وعلى المحامي النبيه أن يختار الأسلوب والألفاظ التي يعبر بها عن مقاصده ومراميه، وأن يستعمل اللغة الفصحى إن وجد من لسانه المطاوعة ومن سامعيه حسن التتبع ومزيدا من الرغبة في الاستماع، كما لا عليه أن يلجأ إلى الأسلوب العامي الدارج إن وجده أكثر إقناعا أو لم يأنس من لسانه المطاوعة على حسن التعبير.
ومما لا ينبغي أن ينساه المحامي أن تدخله يجب أن لا يخلو من الإشارة إلى بعض الحكم والأمثال وأن لا يغفل التحليلات القانونية التي ينبغي له أن يبذل في سبيلها أقصى جهد ممكن بأن يقتطف من أمهات المراجع الفقهية والقضائية أحدث الثمرات ليزين بها مرافعاته؛ فالمرافعة بدون قانون تظل جوفاء.
وعلى المحامي أن يعلم أنه يتحمل مسؤولية تطوير الفقه والقضاء والدفع بعجلتهما إلى الأمام، ويستفرغ كل طاقاته في إعانة القضاء على حسن فهم الدعوى وحسن تطوير العمل القضائي.
واذا كانت القضية التي يرافع فيها المحامي تتصل بجانب اجتماعي أو تاريخي أو سياسي أو علمي أو تقني فعليه أن يخوض غمار الجانب الذي تهمه ويغوص في أعماقه ليستخلص منه ما يدافع به عن قضيته ويكون في ذلك سالكا مسلك الباحث المتفاني الذي لا يقنع بمجرد التصميم واستعراض العناوين بل عليه أن يتعمق في البحث حتى يتمكن من الموضوع الذي هو بصدده غاية التمكن ويمسك بزعامه، حتى يحقق قول أحد القضاة (في حق المحامين) إنهم كتب حية تمشي على الأرض تهدي إلينا معارفها دون حاجة إلى أن نتصفحها، ومن هنا يبدو أن أهم صفات المحامي أن يكون ذا تكوين ثقافي وتربوي ولغوي سليم ومحيطا بأبواب القانون ملما بمختلف العلوم الإنسانية، مواكبا للتطور الفقهي والقضائي، سائرا في طليعة الباحثين.
وهذه الصفات غالبا ما تكون مواهب يتمتع بها بعض الأفراد، ولذلك قيل “يولد المحامي محاميا، أما القاضي فتكونه الأيام” غير أنه يجب التأكيد على أن السليقة وحدها ليست كفيلة بتكوين المحامي الكفء، بل لابد من المران والمعاناة، والدرس الدؤوب، فمما لاشك فيه أن المعاناة والدراسة المستفيضة المتأنية والتتبع للقضايا، من شأنه أن يكون المحامي البارع.
ومن خصائص المرافعة الشفوية: العفوية، وسرعة البديهة، وفصاحة اللسان، وحذاقة العقل، وحصافة الرأي.
ذلك أن المحاكمة الشفوية كثيرا ما تأتي بأمور قد لا تكون بالحسبان، مما يستدعي من المحامي مناورة سريعة وفي الوقت المناسب.
كما أن من خصائص المحاكمة الشفوية أن تأتي بالمفاجآت وبحجج تثار عفوا أو قد تكون معدة من قبل الخصم وهو ما يستدعي الرد السريع والإقحام المقنع.
وعلى المحامي أن يعلم أن خطابه يوجه إلى القضاء لا إلى غيرهم، فعليه إذا أن يخصهم بالخطاب ويستعمل ما يليق بهم من الكلمات ويناسب مقامهم من العبارات والألفاظ.
ولكن لا ينبغي أن ننسى أن القاضي، خاصة في المحاكمة الجنائية، قد يتأثر بتأثر الجمهور فيقتنع من خلاله وعبر اقتناعه، ومن أجل هذا لا ضير على المحامي إن هو وجه خطابه بصورة غير مباشرة إلى الجمهور ليقنعه ويذكي فيه روح الحماس والتعاطف متى وجد أن في انفعال الجمهور وتجاوبه وسيلة لإقناع القضاء، فبهذا النوع من التأثير يستطيع المحامي أن يؤثر في القضاة من خلال الجمهور.
ومتى كان المحامي بهذه الصفات من التمكن من الدعوى واقعا وقانونا، ومن سلوكه طريق الصدق والوضوح فيها فإنه يستطيع أن يجعل مستمعيه على درجة من الفهم والتعاطف بحيث يصيرون وكأنهم يشاهدون ما يسمعون، وهذه درجة سامية من التعبير.
وأخيرا على المحامي أن لا ينسى أنه قد يفوز في قضيته ويكسبها بنكتة بلاغية، أو بقاعدة أصولية، أو بلطيفة نحوية، تماما كما يصل إلى ذلك ويفوز فيه بناء على قاعدة قانونية على درجة من الدقة أو التعقيد.
والتاريخ حافل بأمثلة من الإقناع البلاغي، والإقناع الاجتماعي العقلي، والإقناع العاطفي، والإقناع القانوني.
ولعل من المفيد هنا، على وجه التدليل إيراد أمثلة من تأثير للتعبير، وان كان الأمر لا يتعلق بمرافعة أمام مجلس للقضاء، وإنما بدفاع عن قضايا شخصية.
ففي أعقاب معركة حنين الشهيرة في كتب السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم بين المجاهدين واقتضت حكمته صلى الله عليه وسلم أن يخص الحديثي العهد بالإسلام بحصص أكبر تأليفا لقلوبهم وتطييبا لخواطرهم، إيمانا منه صلى الله عليه وسلم بأن المجاهد لا يطمع في الغنائم مثلما يطمع إلى الفوز بشرف الاستشهاد، وهكذا خص عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس بحصص تفوق ما أعطاه لعباس بن مرداس، وهو أقدم منهما، وتفوق ما منحه لفرسه “العبيد”؛ وهو ما لم يرض عباس بن مرداس فجادت قريحته بقصيدة يخاطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يعاتبه على هذه التفرقة في مقدار الغنيمة، ومما جاء فيها:
أتجعل نهبي ونهب العبيد دون عينيه والأقرع؟
فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع
وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع
وقد كنت في الحرب ذا تدرأ فلم أعط شيئا ولم أمنع
فقال صلى الله عليه وسلم: اقطعوا لسانه أي زيدوه في العطاء ليسكت.
فهذه مرافعة مؤثرة جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتنع بحجة صاحبها وينزل عن رأيه ويزيد له في العطاء استجابة له واقتناعا بعدالة مطلبه وحصافة حجته.
وروى ابن إسحق، وغيره من كتاب السيرة النبوية، كما نقل ذلك ابن شهام أنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل النضر بن الحارث، أحد أسرى غزوة البدر، وأنفذ فيه القط، بكته أخته قتيلة بنت الحارث بقصيدة مما قالت فيها:
أمحمد يا خير ضنء كريمة في قومها والفحل فحل معرق
ما كان ضرك لو مننت؟ وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق
أو كنت قابل فدية فلينفقن بأعز ما يغلو به ما ينفق
فالنضر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق
قال ابن هشام ([1]) “فيقال والله أعلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الشعر قال: لو بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه”، فهذه مرافعة أثرت في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكادت، لولا قدر الله وقضاؤه، تقلب ميزان الأمور، وتفضي إلى عفو على أسير قضي بقتله؛ وهذا أبلغ ما يمكن أن تصل إليه تأثير الكلام الجيد.
وتروي كتب التاريخ أن امرأة، وكانت سيدة قومها، شاركت في إحدى المعارك بزوجها وابنها وأخيها، فأسروا جميعهم، فبعث إليها قائد الجيش المنتصر بأن تختار أحدهم ليخلي سبيله تقديرا لها، ويبقى الآخرين، فأجابت على الفور “الزوج موجود، والابن مولود، والأخ مفقود”. فكان هذا الرد – الدفاع، سببا في إطلاق سراحهم جميعا.
كما تحدثنا كتب الأدب عن المرافعة الشعرية التي بعثها الشاعر الحطيئة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سجنه في أمر هجائه الناس، ومما جاء فيها:
باسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله، أما بعد يا عمر
ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ؟ حمر الحواصل لا ماء ولا شجر
ألقيت كاسيهم في قعر مظلمة فامنن عليك سلام الله يا عمر
أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقت إليك مقاليد النهى البشر
لم يوثروك بها إذ قلدوك لها لكن لأنفسهم لهم بها أثر
وامنن على صبية في الرمل مسكنهم حول الأباطح يغشاهم بها القزر
أنت رأس قريش وابن سيدها والرأس فيه يكون السمع والبصر
نعم ألفتي عمر في كل نائلة نعم الفتى عمر نعم الفتى عمر
وقد أتت هذه المرافعة الشعرية أكلها فأطلق عمر بن الخطاب سراح الحطيئة.
ويذكر مؤرخو الأدب العربي للفترة العباسية أن بعض الوشاة أوقعو في نفس سيف الدولة أن شاعره المتنبي كثير الإعجاب بنفسه ويرى أنه في مرتبة تعلو مرتبة الأمير، وذلك حسدا منهم ومحاولة للحط من منزلة الشاعر عند الخليفة الذي لم يكد يلتفت إلى هذه الوشاية، إلى أن جاءت مناسبة إلقاء المتنبي، بين يدي الأمير، قصيدته الميمية الشهيرة التي يقول فيها:
ما لي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم
فلما وصل إلى قوله فيها:
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم
أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم
سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا أنني خير من تسعى به قدم
اغتاض سيف الدولة، وتأكد له قول الوشاة في المتنبي، فرماه بدواة كانت بيده فشج جبهته.
وعنذ ذاك أدرك المتنبي الأمر فحاول تدارك النتيجة بمرافعة شعرية ألقاها ارتجالا، متمما بها قصيدته السالفة، التي كان بصدد إلقائها، قال فيها:
إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح، إذا أرضاكم، ألم
فكان هذا البيت الشعري كافيا لجبر خاطر سيف الدولة وإصلاح نفسه وإعادة مكانة المتنبي إلى قلبه وتكذيب وشاته، وإغداق الهدايا على الشاعر المقتدر الحكيم، جزاء وفاقا على مرافعته الذكية.
هذه أمثلة من مرافعات أربعة كان لها أبلغ الأثر في نفوس سامعيها، وما ذلك إلا لفصاحة ألفاظها وبلاغة أسلوبها، وتأثير عباراتها.
فهل نستطيع أن نكون كذلك في مرافعاتنا؟.. إن ذلك ليس أمرا مستحيل المنال، ولكنه يتطلب الدرس والجهد والتمكن من وسائل الدفاع علما وأسلوبا، دون مجرد الوقوف على سطحيات الأمور؛ كما قال الإمام الشاطبي، في مقدمة كتابه “الموافقات”: “إياك وإقدام الجبان، والوقوف مع الطرق الحسان والإخلاد إلى مجرد التصميم من غير بيان، وفارق وهن التقليد راقيا إلى يفاع الاستبصار، وتمسك من هديك بهمة تتمكن بها من المدافعة والاستنصار، إذا تطلعت الأسئلة الضعيفة والشبه القصار، والبس التقوى شعارا والاتصاف بالإنصاف دثارا، واجعل طلب الحق لك نحلة، والاعتراف به لأهله ملة، لا تملك قلبك عوارض الأعراض، ولا تغر جوهرة قصدك طوارق الأعراض، وقف وقفة المتخيرين لا وقفة المتحيرين، إلا إذا اشتبهت المطالب ولم يلح وجه المطلوب للطالب، فلا عليك من الإحجام وان لج الخصوم، فالواقع في حمى المشتبهات هو المخصوم، والواقف دونها هو الراسخ المعصوم، وإنما العار والشنار على من اقتحم المناهي فأوردته النار؛ لا ترد مشرع العصبية ولا تأنف من الإذعان إذا لاح وجه القضية، أنفة ذوي النفوس العصية، فذلك مرعى لسوامها وبيل، وصدود عن سواء السبيل”.
[**] يتعلق الأمر بكلمة ألقيتها باعتباري مدير ندوة التمرين في الجلسة الافتتاحية للندوات التي عقدت مساء 24 مارس 2009 بقاعة الجلسات الكبرى لمحكمة الاستئناف بالرباط راجع:
Dictionnaire encyclopédique Alpha, volume 16, Alpha éditions, Paris, p. 1920.
- باينة عبد القادر، التنظيم الإداري بالمغرب، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 1991، ص 84-85.
- رضوان بوجمعة، المقتضب في القانون الإداري العام، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1999، ص 91.
- المسعودي أمنية، الوزراء في النظام السياسي المغربي من حكومة 1955 إلى حكومة 1985، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، كلية الحقوق أكدال، الرباط، 1999، ص 423.
[1]السيرة النبوية، تحقيق جمال ثابت، ومحمد محمود، وسيد إبراهيم، الطبعة الأولى، 1966، دار الحديث، القاهرة، ج 2 ص 244.