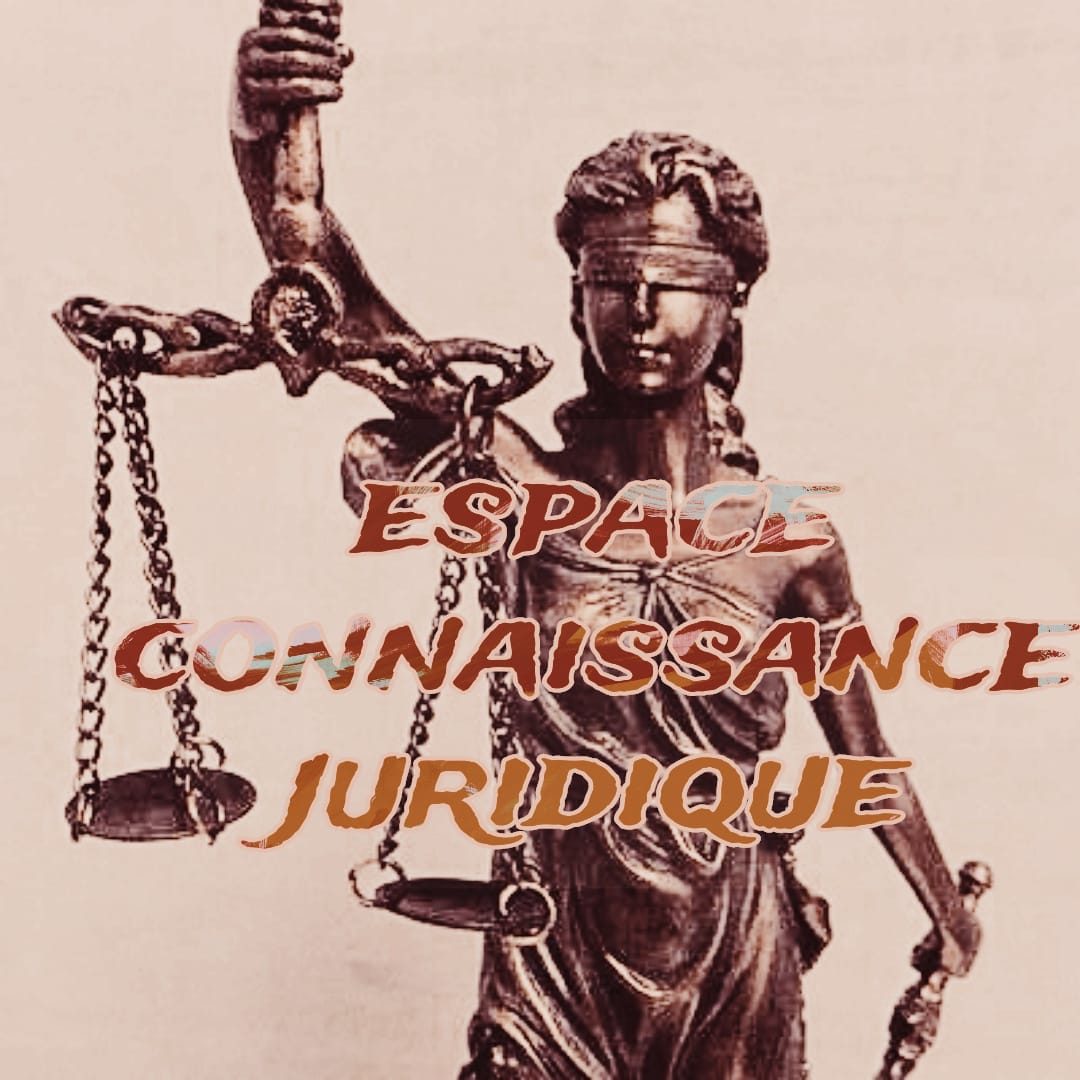قراءة في الشكل والمضمون
الأستاذ / محمد القدوري
محام بهيئة المحامين بالرباط
عضو اللجنة العلمية للمناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة
من المعلوم أنه بتاريخ 2011/11/24 نشر بالجريدة الرسمية عدد 5998 ظهيران بالأمر بتنفيذ قانونيين هامين:
- أحدهما: هو الظهير الشريف رقم 1. 11. 177المؤرخ 25-حجة 1432 (2011/11/22)
بتنفيذ القانون رقم 07. 14 بشأن تغيير وتتميم ظهير 9 رمضان 1331 (12 /08 1913/ )، - والثاني: هو الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر في 25 حجة (2011/11/22) 1432 بتنفيذ القانون 08.39 بشأن مدونة الحقوق العينية.
وقد جاء القانونان المذكوران بمقتضيات جديدة، تقتضي ملاحظات شكلية وجوهرية.
أولا: ففيما يخص أهم مستجدات القانون 07/14بشأن تتميم وتغيير قانون التحفيظ العقاري
إن المستجدات التي جاء بها القانون 07/14، هي الواردة في المواد: 1 و2 و3 و4 التي يتألف منها القانون المذكور، وتتجلى فيما يلي:
- إعطاء الفصل الأول من ظهير التحفيظ (المعدل) معنى جديدا للتحفيظ،
- إلغاء الفصول: 2 و3 و4 و5 و28 و33 و46و49و53و56و57و79و80و81و92و98و99 من ظهير 12 غشت 1913،
- نسخ وتعويض الفصول:11و 12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و30 و31 و32 و37و45 و47 و64و65 مكرر و70 و71 و73 و82 و83و 86 و87و95و96و100و108و109 من الظهير ا لمذكور،
- تغيير وتتميم الفصول 20: و21و22و23و24و25و26و27و35و38و40و41و42 و43 و44 و48 و50و51 و52 و54 و55 و60 و61و62و63و65و66و67و68و69و72 74و 75 و76 و77و78 و84و85 و87 و88 و89 و90و93و94و97و101و102و103و 104 و 105و 107،
- إضافة الفصول: 37 مكرر 1-51 و51-2 و51-3و 4-51و5-51 و6-51 و7-51 و8-51 و9-51 و10-51و11-51 و12-51 و13-51و14-51و15-51و16-51و17-51و18-51و19-51و 52 مكرر و86 مكرر و105 مكرر و110.
وأهم ما يلاحظ بشأن التغييرات والإضافات التي جاء بها الظهير، أنها:
- سلبت من وكيل الملك حق فتح أجل استثنائي للتعرض على مطالب التحفيظ،
- حصرت حق فتح آجل استثنائي للتعرض على مطلب التحفيظ، على المحافظ على الأملاك العقارية،
- جعلت قرار المحافظ بشأن فتح آجال استثنائية للتعرض على مطالب التحفيظ نهائية غير قابلة لأي طعن،
- ألزمت السلطة المحلية بإنجاز “شهادات إدارية للملكية” للمالكين في المناطق المشمولة بالتحفيظ الإجباري، الذين لا يتوفرون على وثائق، أو الذين تكون وثائقهم غير كافية،
- غيرت شكليات ومدد سريان التقييد الاحتياطي،
- أخضعت الطعون في الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ للآجال المقررة في قانون المسطرة المدنية،
- نصت (في الفصل 109) على أن الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ لا تقبل الطعن إلا بالاستئناف أو النقض، وهو تكريس لقاعدة كانت معروفة وجاريا بها العمل، ولكن ذلك وضع إشكالا فيما يخص طلبات إعادة النظر في قرارات محكمة النقض.
ثانيا: وفيما يخص أهم مستجدات القانون 39/ 087 بشأن مدونة الحقوق العينية:
- من الناحية الشكلية إن مدونة الحقوق العينية كلها جديدة، كنص قانوني، واجب التطبيق على المنازعات العقارية التي لم يرد بشأنها نص خاص.
- ومن الناحية الموضوعية، فإن أهم المقتضيات التي جاءت بها مدونة الحقوق العينية تبدوا واضحة في النواحي الأتية:
- فيما يخص النصوص المطبقة على المنازعات العقارية:
أخضعت مدونة الحقوق العينية المنازعات العقارية:
- لنصوصها (أي نصوص مدونة الحقوق العينية) بالدرجة الأولى؛
- ثم التشريعات الخاصة، الأخرى، في الدرجة الثانية؛
- ثم نصوص قانون الالتزامات والعقود، في الدرجة الثالثة؛
- ثم المبادئ والقواعد المقررة في الراجح، والمشهور، وما جرى به العمل في مذهب الإمام مالك، في الدرجة الربعة.
- في مجال القوة الإثباتية للتقييدات:
- إمكانية إبطال التقييدات على الرسم العقاري، ولو في حق المقيد حسن النية، عندما يتعلق الأمر بتقييد نجم عن تدليس، أو زور؛ بشرط تقديم الدعوى داخل 4 سنوات (المادة 2).
- وفي مجال شكليات التصرفات الواردة على العقار:
- وجوب إنجاز التصرفات بشأن العقار بعقود رسمية، أو عقود ثابتة التاريخ يحررها محام مقبول أمام محكمة النقض (المادة4 ).
- وفي مجال التبرعات:
- إثبات حيازة التبرعات بالتقييد على الرسم العقاري، أو بإدراج مطلب تحفيظ؛ دون توفر معاينة الحوز الفعلي،
- عدم الاعتداد بوفاة الواهب، كمانع لنفاذ الهبة، إلا من يوم تقييدها على الرسم العقاري (المادة 2/279)،
- تقييد إمكانية اعتصار الهبة بحضور الموهوب له وموافقته، أو بصدور حكم بالفسخ (المادة 286)،
- تخويل القاصر حق قبول الهبة بنفسه، ولو مع وجود نائب شرعي له؛ وعدم اشتراط وجود (أو تعيين) نائب لغرض القبول إلا بالنسبة لفاقد الأهلية (المادة276 -)
- في مجال الشفعة:
- تحديد آجال الشفعة في:
- 30 يوما من تاريخ التوصل بإنذار من المشتري بعد تقييد شرائه على الرسم العقاري، أو إيداع شرائه بمطلب التحفيظ (المادة(1/304
- سنة واحدة من يوم التقييد على الرسم العقاري إن لم يوجه المشتري إنذارا (المادة 2/304)،
- أربع سنوات من تاريخ العقد، في كل الأحوال، إن لم يتحقق العلم (المادة 3/304).
- إخضاع الشفعة لشرط عرض وإيداع الثمن سواء كان العقار موضع طلبها محفظا، أو في طور التحفيظ، أو غير محفظ (المادة 306)،
- منع الشفعة في البيع بالمزاد العلني،
- إخضاع الشفعة في العقار غير المحفظ والذي في طور التحفيظ لنفس القيود والشروط المقررة بشأن العقار المحفظ، بما في ذلك وجوب عرض وإيداع الثمن والمصاريف (المادة 306)،
- تقييد طلب شفعة العقار الذي هو في طور التحفيظ بتقييد تعرض على مطلب التحفيظ (المادة 305)،
- منع الشفعة في البيع بالمزاد العلني،
- إخضاع الشفعة في العقار غير المحفظ والذي في طور التحفيظ لنفس القيود والشروط المقررة بشأن العقار المحفظ، بما في ذلك وجوب عرض وإيداع الثمن والمصاريف (المادة (306،
- تقييد طلب شفعة العقار الذي هو في طور التحفيظ بتقييد تعرض على مطلب التحفيظ (المادة 305)،
- بطلان التصرفات التي يجريها المشتري على الحصة المشفوعة، إن تعلق الأمر بعقار غير محفظ (المادة310 -).
- في مجال القسمة:
- اشتراط توجيه دعوى القسمة ضد سائر الشركاء (المادة 316)،
- اشتراط تقييد دعوى القسمة تقييدا احتياطيا (المادة316 )،
- اشتراط توجيه دعوى القسمة ضد كل أصحاب الحقوق العينية (المادة .(317 –
- في مجال إحياء الموات، والحيازة:
- إخضاع “إحياء الأرض الموات” لإذن السلطة،
- جعل الحيازة مكسبة للملك تارة، واعتبارها مجرد قرينة عليه تارة أخرى.
ثالثا: وفيما يخص تفصيل بعض الملاحظات بشأن مدونة الحقوق العينية:
- تمهيد عام بشأن تاريخ المنازعات العقارية من حيث النصوص المطبقة عليها:
- من المعلوم أن النزاعات القائمة حول الحقوق العينية العقارية ظلت تتأرجح بين إخضاعها لقواعد الفقه المالكي الجاري به العمل في المغرب، وبين إخضاعها لقانون الالتزامات والعقود، وبعض المبادئ القضائية التي قررتها محاكم المملكة، محط نقاش، وذلك منذ صدور قانون الالتزامات والعقود المغربي، وكان النقاش بشأن ما ذكر يشتد عندما يتعلق الأمر بعقار في طور التحفيظ، إلى أن وضع حد للجدل المذكور بمقتضى المادة الأولى من القانون 08.39 المأمور بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.11 .178. الصادر في 25حجة 1432 الموافق 22 / 11 / 2011، المنشور بالجريدة الرسمية عدد5998 الصادرة يوم 27 حجة 1432 الموافق 24/11/2011 (ص 5587)، التي نصت في فقرتها الأولى على أن “تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية، ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار، ونصت في فقرتها على أن “تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12)1331 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون، فإن لم يوجد نص، يرجع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي”. وهكذا وضعت هذه المادة حدا للجدل الذي كان قائما حول النصوص التي تخضع لها النزاعات المتعلقة بالعقار، بأن أصبحت النصوص الواجب الإعمال بشأن النزاعات المذكورة هي:
- نصوص مدونة الحقوق العينية، بالدرجة الأولى؛
- ثم التشريعات الخاصة، الأخرى، في الدرجة الثانية؛
- ثم نصوص قانون الالتزامات والعقود، في الدرجة الثالثة؛
- ثم المبادئ والقواعد المقررة في الراجح، والمشهور، وما جرى به العمل في مذهب الإمام مالك، في الدرجة الربعة.
- وقد يكون من شأن عبارات المادة الأولى سالفة الذكر أن تفضي إلى اختلافات ونقاشات حول المراد من “التشريعات الخاصة بالعقار” وهل يشمل ذلك النصوص الخاصة الموجودة حاليا أو يقتصر على النصوص التي ستصدر بمناسبة تطبيق مدونة الحقوق العينية أو بمناسبة أخرى، أو أن التعبير المذكور يعم القوانين الموجودة والتي ستصدر لاحقا، من جهة؛ وكذا حول التفسيرات التي ستعطى لبعض نصوص قانون الالتزامات والعقود المستمدة من مبادئ الفقه المالكي؛ وما أكثرها.
ومما يزيد في تعقيد المسألة، الترجمة غير الدقيقة أو الغامضة والاقتباسات المقتضبة تارة وغير الدقيقة تارة أخرى من قواعد الفقه المالكي التي اعتمدها واضعو قانون الالتزامات والعقود.
وهذا الأمر أصبح يدعو أكثر من أي وقت مضى، إلى ضرورة الاستعانة بمبادئ الفقه المالكي في أصولها الصحيحة، من أجل تكميل وتفسير نصوص مدونة الحقوق العينية، ونصوص قانون الالتزامات والعقود، والنصوص الأخرى المتصلة بالموضوع.
وهو الأمر الذي ينعقد الأمل معه على المشتغلين في حقل القانون -من أساتذة، ومحامين ومحافظين على الأملاك العقارية وقضاة -في أن يبذلوا من الجهد والتأمل العميق ما من شأنه أن يساعد على النهوض بفقه العقار وتطويره بما يلائم مصلحة الأفراد والمجتمع، في ظل قواعد واضحة ومنصفة، ويشكل انطلاقة صحيحة وسليمة وفعالة في الطريق الصحيح لفهم وتطبيق وتأويل نصوص مدونة الحقوق العينية، والنصوص المتصلة بها وبموضوع العقار.
- ومن الأسئلة التي يطرحها دخول مدونة الحقوق العينية حيز التنفيذ التساؤل حول ما إن كانت النصوص التي وضعت لتطبيق قانون 02/06/1915، ومنها على سبيل المثال القرار الوزيري الصادر في15/06/ 1915بشأن تفاصيل تطبيق النظام العقاري، قائمة، رغم أن مدونة الحقوق العينية نسخت ظهير 02/06/1915 الذي كان يتضمن التشريع المطبق على العقارات المحفظة، أم أن تلك النصوص الخاصة ستبقى نافذة في ظل المدونة المذكورة.
- ولعله يكون من المفيد الإشارة إلى أن مدونة الحقوق العينية تتألف 334 مادة موزعة على ثلاثة “أجزاء”:
الجزء الأول: سمي فصل تمهيدي، ويتضمن المواد من 1 إلى 7.
الجزء الثاني: سمي الكتاب الأول، ويضم المواد من 8 إلى 22؛ وهو مقسم إلى3 أقسام.
القسم الأول (المواد من 14إلى 141) وهو مخصص للحقوق العينية العقارية، وهو مقسم إلى عشرة أبواب؛ تناول الأول منها: أحكام حق الملكية؛ وتناول الثاني الارتفاقات والتكاليف العقارية؛ والثالث حق الانتفاع؛ والرابع حق العمري؛ والخامس حق الاستعمال؛ والسادس حق السطحية؛ والسابع حق الكراء الطويل الأمد؛ والثامن حق الحبس؛ والتاسع حق الزينة؛ والعاشر حق الهواء والتعلية.
القسم الثاني: (المواد من 142 إلى 213) وهو مخصص للحقوق العينية التبعية وهو مقسم إلى ثلاثة أبواب. تناول الأول منها للامتيازات؛ والثاني للرهن الحيازي؛ والثالث للرهون الرسمية.
والقسم الثالث: (المواد من 214 إلى 221) وهو مخصص للحجز والبيع الجبري للعقارات.
الجزء الثالث سمي الكتاب الثاني؛ ويتألف من المواد من 222 إلى 334 ويتألف من قسمين:
القسم الأول: (المواد من 222 إلى 312) خصص لأسباب كسب الملكية، وهو يتألف من بابين؛ خصص الأول لإحياء الأراضي الموات والحريم، والالتصاق، والحيازة، والميراث والوصية (اللذين أحال بشأنهما على مدونة الأسرة)؛ وخصص الباب الثاني: للمغارسة، والهبة، والصدقة، والشفعة.
القسم الثاني (المواد من 313 إلى334) وهو يبحث أمرين:
الأمر الأول: القسمة، وقد خصصت لها المواد من 313 إلى. 332
الأمر الثاني يتضمن مادتين، هما: المادة 333 التي نسخت ظهير19 رجب 1333 (1915/06/02) بشأن التشريع المطبق على العقارات المحفظة؛ والمادة 334 التي نصت على أن مدونة الحقوق العينية تدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية (علما بأن مدونة الحقوق العينية صدر الأمر بتنفيذها بالظهير الشريف رقم 178.
11. 1 الصادر في 25 حجة 1432 ( 2011/11/22 ) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5958 الصادرة في 24/ 11/2011، وبذلك يكون منطلق العمل بها هو يوم 24 / 05 / 2012.
- هذا وإن آفاق تطبيق مدونة الحقوق العينية تستدعي ملاحظات بشأن عدة مواضع
من مدونة الحقوق العينية.
- ما يخص تنظيم الحيازة:
- وأول وأهم ملاحظة تتعين إثارتها بشأن نصوص مدونة الحقوق العينية بشأن الحيازة أنها تتأرجح بين الأخذ بنظرية ابن رشد، الراجحة لدى الفقهاء، القائمة على أن الحيازة المستوفية للشروط المقررة إنما هي مجرد دليل على الملك وليست سببا فيه، وبين النظرية المقابلة، المرجوحة، القائلة إن الحيازة المستوفية للشروط المقررة في بابها مكسبة للملك وناقلة له وليست مجرد دالة عليه.
ويبدوا ذلك جليا من تأمل المادة 3 من المدونة المذكورة، ومواد الفصل الثالث من الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الثاني منها المتعلق بأسباب كسبب الملكية، المخصص للحيازة، المشتمل من 25مادة، وهي المواد من 239 إلى المادة 263، الموزعة عبر أربعة فروع، خصص الفرع الأول منها (المواد من 239 إلى 249) للأحكام العامة للحيازة، والثاني (المواد من 250 إلى 259) لمدة الحيازة والثالث (المواد من 260 إلي262 ) لأثار الحيازة، والرابع (المادة 293) إثبات الحيازة وحمايتها.
ذلك أن مدونة الحقوق العينية، باستثناء المدة 3، أدرجت المواد التي خصصتها لأحكام الحيازة، ضمن أسباب كسب الملكية، ومن ذلك يمكن القول إنها أخذت بالنظرية القائلة بأن الحيازة من أسباب كسب الملكية، وذلك ما كرسته المادة 3 منها من أنه يترتب على الحيازة المستوفية للشروط القانونية اكتساب الحائز ملكية العقار غير المحفظ أو الحق العيني محل الحيازة، وما نصت عليه المادة 239 من أن “تقوم الحيازة الاستحقاقية على السيطرة الفعلية على الملك بنية اكتسابه وما نصت عليه 260 من أنه “يترتب على الحيازة المستوفية لشروطها اكتساب الحائز ملكية العقار، وما أشارت إليه المادة 261 من أنه “لا تكتسب بالحيازة أملاك الدولة…”، وما نصت عليه الفقرة 5 من المادة 243 من أنه “يمكن لفاقد الأهلية أو ناقصها أن يكتسب الحيازة إذا باشرها نائبه الشرعي نيابة عنه، وما نصت عليه المادة 250 من أنه “إذا حاز شخص أجنبي غير شريك ملكا حيازة مستوفية لشروطها… فإنه يكتسب بحيازته ملكيه العقار” وما جاء في المادة 253 من الاعتداد “بنية تملكه”.
والنظرية السابقة، القائلة بأن الحيازة مكسبة للملك، هي نظرية مرجوحة، والنظرية الراجحة هي نظرية ابن رشد القائمة على أن الحيازة إنما هي دليل على الملك، وليست سببا فيه، أي أنها مظنة الملك وليست سببا فيه، ولذلك لا يمكن تصنيفها ضمن أسباب كسب أو انتقال الملكية؛ ومن أدلة ذلك أن فقهاء المالكية يبحثون الحيازة في باب الشهادات (الإثبات) أو في باب القضاء، وليس في باب أسباب اكتساب الملكية أو انتقالها.
على أنه يؤخذ من قول المادة 3 من مدونة الحقوق العينية “إلى أن يثبت العكس”، أنها اعتنقت النظرية القائلة إن الحيازة مجرد دليل على الملك وليست سببا فيه، وهو ما تؤيده الفقرة الثانية من المادة 239 من المدونة المذكورة الناصة على أن “لا تقوم… الحيازة لغير المغاربة مهما طال أمدها”، وهو ما يزكيه قول المادة 241 من أنه (لا تقوم الحيازة إذا بنيت على عمل غير مشروع)، وهو نفس المعنى الذي يؤخذ من المادة 242 الناصة على أن “لا يكلف الحائز ببيان وجه مدخله إلا إذا أدلى المدعي بحجة على دعواه” ومن المادة 246 القاضية بأن “لا تقوم الحيازة ولا يكون لها أثر إذا ثبت أن أصل مدخل الحائز غير ناقل للملكية”.
ومن هنا يتبين أن مدونة الحقوق العينية أخذت -في آن واحد-بنظريتين متعارضتين من نظريات الحيازة وعلاقتها بسبب التملك، وهما: نظرية ابن رشد التي تبعها ابن القاسم، القائمة على أن الحيازة إنما هي دليل على الملك، وليست سببا فيه، وهي النظرية الراجحة لدى جمهرة الفقهاء المالكية؛ وذلك في مقابل النظرية المرجوحة القائلة بأن الحيازة سبب من أسباب كسب الملكية. وهو مسلك كان جديرا بمدونة الحقوق العينية أن تتجنبه وأن تعتنق بوضوح النظرية السائدة في الفقه القائمة على أن الحيازة إنما هي قرينة على الملك وليست سببا فيه، وأن الحيازة إنما هي، كما يقول الفقهاء، بمثابة العفاص والوكاء في اللقطة، لا تنفع صاحبها متى ثبت أن سبب دخوله إلى العقار المحوز غير مشروع.
ومن المناسب هنا، الإشارة إلى أن الفقهاء المعاصرين الذين اهتموا بموضوع الحيازة في الفقه المالكي يفضلون الأخذ بنظرية ابن رشد، ويستندون في ذلك إلى مجموعة من النصوص والآراء، منها:
- ما ورد في مدونة الإمام مالك “في الشهادة على الحيازة” مما “يؤيد الرأي القائل بأن الحيازة وحدها لا تنقل المال المحاز، ولكنها تدل على الملك، أو تعتبر قرينة على ملكية الحائز للمال المحاز، ولكنها ليست قرينة قاطعة”([1]).
- ما ورد في شرح الحطاب لقول خليل، في باب الاستحقاق “وإن حاز أجنبي غير شريك..” من أن “الحيازة لا تنقل الملك، عن المحوز عنه إلى الحائز باتفاق، ولكنها تدل على الملك، كإرخاء الستور، ومعرفة العفاص والوكاء، وما أشبه ذلك، فيكون القول معها قول الحائز، مع يمينه”([2])
- ما أجمع عليه الفقهاء وحذاق الموثقين من أن الحيازة لا تفيد الملك إلا بشرط أن يدعي الحائز الملك، بسبب من أسباب اكتساب أو نقل الملكية، أو يدعي جهل أصل الملك ويحلف، وأما تمسكه بمجرد الحيازة فلا ينفعه لرد حجة خصمه ([3]).
- وثاني ملاحظة يمكن مؤاخذتها على مدونة الحقوق العينية أنها أخذت، في المادتين 253و 254 بقاعدة تلقيف الحيازة بين الخلف الخاص والخلف العام، مع أن جانبا مهما من الفقه يفرق في التلفيق بين حيازة السلف وحيازة خلفه العام، وفيها يضم مدة حياة السلف إلى مدة حيازة السلف؛ وبين حيازة السلف وحيازة خلفه الخاص، وفيها لا يقول بضم مدة حيازة المشتري إلى مدة حيازة البائع؛ وهي قاعدة أخذ بها القانون السوداني صراحة ([4]).
- وثاني ملاحظة أن من حسنات مدونة الحقوق العينية أنها تعرضت لحيازة الأشخاص المعنوية، في الفقرة الثالثة من المادة 43، وهو موضوع قل من تكلم عنه ممن كتب في مجال الحيازة ([5])، وهذه من حسنات المدونة المذكورة.
- وفيما يخص الترجيح بين الحجج:
يواخذ على مدونة الحقوق العينية أنها، أثناء الحديث في المادة 3 على أسباب الترجيح بين الأدلة قررت “تقديم البينة السابقة على البينة اللاحقة تاريخا” مع أن القاعدة المتفق عليها فقها المقررة قضاء أن العبرة في الترجيح بالتاريخ إنما هي لطول مدة الحيازة، وليس لمجرد أخر تاريخ إحدى الحجتين على تاريخ الأخرى ([6]).
رابعا: فيما يخص الترابط بين نصوص مدونة الحقوق العينية ونصوص قانون التحفيظ:
يلاحظ بشأن وسائل إثبات الحيازة أن قانون التحفيظ سن وسيلة من وسائل إثبات الملكية، غير التي قننتها المادة 263 من مدونة الحقوق العينية، وتمت الإشارة إليها عرضا في المادة 3 من نفس المدونة، وذلك من خلال إحداث قانون التحفيظ، في الفصل 6.51، وسيلة لإثبات الملكية، في مجال التحفيظ الجماعي، وهي الشهادة التي تنجزها السلطة المحلية، وهذه وسيلة إثبات قلما تناولها مؤلف من المؤلفات في مجال الحيازة ([7])، ويبدو أن الدافع إلى سنها هو التخفيف على ملاك الأراضي الخاضعة لنظام التحفيظ الجماعي؛ ولا بد من القول إن مثل الشهادة المذكورة لا يمكن أن تعدل الشهادة العدلية الصحيحة المستوفية للشروط المقررة، عندما يقع التنازع بين الحجج.
خامسا: فيما يخص النصوص الواجبة التطبيق بالموازاة مع مدونة الحقوق العينية:
يلاحظ أنه بالإضافة إلى القوانين التي نصت المدونة صراحة على تطبيقها، وهي قانون الالتزامات والعقود، الذي أصبح يحتل الدرجة الثانية بعد نصوص المدونة، في تنظيم المنازعات العقارية.
علما بأن هنالك مواد تناولها “قانون الالتزامات والعقود”، ولم تتكلم عنها مدونة الحقوق العينية، فأضحى القانون المذكور هو النص المطبق على تلك المنازعات، في الدرجة الأولى (ومن ضمن ما انفرد قانون الالتزامات والعقود بتنظيمه، ولم تتناوله مدونة الحقوق العينية: البيوع (الفصول 478 إلى 613)، والمعاوضة (الفصل 619) والوكالة (الفصول 879إلى 943) والاشتراك (الفصول 909 إلى 1083)، والصلح (الفصل 1098)، والرهن الحيازي للعقارات (الفصول 1170 إلى (1183].
سادسا: فيما يخص قواعد الفقه التي يجب تطبيقها عند عدم وجود نص قانوني:
نظرا لأن مدونة الحقوق العينية أحالت على الراجح والمشهور وما جرى بع العمل، في مذهب الإمام مالك، فقد بات من اللازم التعريف بالمصطلحات المذكورة، بإيجاز:
- فالراجح هو ما قوي دليله، وقيل ما كثر قائله، وعلى هذا القول الأخير يكون الراجح مرادفا للمشهور؛ لكن المعتمد أن الراجح ما قوي دليله ([8])، وأن المشهود هو ما كثر قائله وقيل هو ما قوي دليله، وقيل هو قول ابن القاسم في المدونة.
- و “ما جرى به العمل، هو ما تقرر العمل به من نصوص الفقه الموسومة بالضعيفة أو الشاذة، مما يخالف الراجح أو المشهور، وذلك إما لضرورة أو عرف جار أو نحو ذلك؛ فهو ضرب من الاجتهاد المذهبي ([9]).
مع الإشارة إلى أن “العمل” ينقسم إلى عمل مطلق ([10])، وهو الذي يعم العمل به أقطار المغرب (تونس والجزائر والمغرب)، وعمل خاص، وهو ما يقتصر على قطر واحد مثل العمل الفاسي الذي كان يجري به العمل في الأندلس والمغرب ([11]).
- وأما المشهور، وهو -كما سبق -ما كثر قائله، وإن اختلف المتأخرون في معناه، بين قائل هو ما كثر قائله، وقائل هو ما قوي دليله، وقائل إنه قول ابن القاسم في المدونة.
فعلى القول الأول لابد أن يزيد نقلته عن ثلاثة؛ ويسميه الأصوليون بالمستفيض أيضا؛
ذكر ابن فرحون، في كشف النقاب ([12])، أن “مسائل المذهب تدل على أن المشهور ما قوي دليله، وأن مالكا رحمه الله كان يراعي من الخلاف ما قوي دليله، لا ما كثر قائله فقد أجاز الصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وأكثرهم على خلافه…، وأجاز أكل الصيد إذا أكل منه الكلب ولم يراع في ذلك خلاف الجمهور،) ([13]).
وقد نظم المرحوم سيدي أبو الشتاء بن الحسن الغازي الصنهاجي بشأنها الأبيات التالية:
| إن يكن الدليل قد تقوى | فراجح عندهم يسمى | |
| والقول إن كثر من يقول به | يسمى بمشهور لديهم فانتبه | |
| عملنا هو الذي به حكم | قضاة الاقتداء رعيا للحكم | |
| مشهورهم لراجح تعارض | يقدم الراجح وهو المرتضى | |
| وقدم العمل حيث ما جرى | على سواه مطلقا بلا مرا |
هذا، وإن مجال القواعد والمبادئ المقررة في مجال الراجح والمشهور وما جرى به العمل من فقه الإمام مالك مجال واسع، يمكن الرجوع بشأنه على المؤلفات والمصادر المعتمدة في المذهب، التي جرى القضاء على اعتمادها والأخذ بها، ومنها: “الرسالة” لأبي زيد القيرواني، و”المعونة” للقاضي عبد الوهاب، و”فصول الأحكام” للباجي، و”جامع الأمهات” لابن الحاجب، و”عقد الجواهر الثمينة” لابن شاس، و”القوانين الفقهية” لابن جزي، و”المختصر” للشيخ خليل، و”التحفة” لابن عاصم، و”لامية الزقاق ” لعلي بن قاسم التجيبي.
سادسا: فيما يخص النصوص القانونية الخاصة التي يجب الرجوع إليها، إلى جانب مدونة الحقوق العينية، في مجال المنازعات العقارية فهي متعددة، ويندرج ضمنها ما يتصل بموضوع الحيازة في:
- ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 12 غشت 1913، كما وقع تتميمه وتغييره بالقانون 84. 11 المأمور بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 181. 11. 1 الصادر في 25 حجة 1324 (22/ 11 /2011) المنشور بالتزامن مع مدونة الحقوق العينية.
- مدونة الأوقاف،
- القوانين المتعلقة بأملاك الدولة، والجماعات،
- النصوص المتعلقة بالتعمير، وبالاستثمار الفلاحي، وبنزع الملكية من أجل المنفعة العامة،
- النصوص الخاصة الأخرى،
- قانون المسطرة المدنية.
- وفيما يخص باقي الأبواب، يلاحظ:
- أن مدونة الحقوق العينية أخذت بآراء مخالفة لما هو مستقر عليه فقها في عديد من الأمور، منها: حيازة العطايا، ولا سيما ما نصت عليه المادة 106 من عدم ضرورة اشتراط معاينة الحوز في “العمري”، والشفعة التي قيدتها بشروط لم تكن مألوفة في مجال العقار غير المحفظ والذي في طور التحفيظ.
- وفيما يخص المسطرة المتبعة في بعض المنازعات العقارية:
يمكن تقسيم المنازعات العقارية التي تطرأ بشأن العقارات تنقسم إلى نوعين منازعات ناتجة عن التعرض على مطالب التحفيظ، تعرض على المحاكم نتيجة لإحالة مطالب التحفيظ الواردة عليها تعرضات كلية أو جزئية، يفضي بها من يعنيهم الأمر مباشرة، أو تنجم عن تداخل مطلبي تحفيظ أو أكثر؛ ومنازعات تهم العقارات غير المحفظة، أو العقارات المحفظة، وتعرض على المحاكم بواسطة مقال افتتاحي يتقدم به من له المصلحة. ولكل نوع من نوعي المنازعات المذكورة مسطرة خاصة وطرق طعن خاصة:
- فأما المناعات العادية التي تفتتح بمقال، فإنه تخضع لسائر القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، سواء أثناء سير الدعوى، أو بعد انتهائها بحكم؛ وهكذا يمكن لأطراف النزاع أن يمارسوا جميع إجراءات عوارض الدعوى، من طلب إدخال الغير، أو تدخل في الدعوى، أو طلب مقابل،..؛ كما يمكن لذوي الشأن أن يمارسوا ضد الأحكام الصادرة في مثل هذه المنازعات جميع طرق الطعن العادية وغير العادية، متى توفرت شروطها: من تعرض، واستئناف، وتعرض من خارج الخصومة، وإعادة نظر، ونقض.
- وأما المنازعات التي تثار بشأن قضايا التحفيظ العقاري، التي تفتتح ملفاتها نتيجة إحالة مطالب التحفيظ الواردة عليها تعرضات على المحاكم، فإنها لا تخضع إلا للإجراءات وطرق الطعن المنصوص عليها في قانون التحفيظ العقاري، وذلك أن أطراف الدعوى في المسطرة في مادة التحفيظ تتحدد بما يرد في مطلب التحفيظ فقط، أي طالب أو طلاب التحفيظ كمدعى عليه؛ والمتعرض أو المتعرضين، كمدعين. ولا يمكن إضافة أي شخص آخر خلال جريان المسطرة، لأن مسطرة التحفيظ لا تعرف لا التدخل في الدعوى ولا إدخال الغير. كما أن الأحكام الصادرة في المادة المذكورة لا تقبل الطعن إلا بالاستئناف والنقض (ولا تعرف باقي طرق الطعن من تعرض، وتعرض من خارج الخصومة، وإعادة النظر).
- هذا، وقد وجد المشرع -لغاية ما -أن ينص في الفصل 109 من ظهير التحفيظ، المعدل، على أن الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ لا يقبل الطعن إلا بالاستئناف والنقض، وهذا التنصيص يقتضي كلمة في هذا الشأن، خصوصا فيما يهم قرارات محكمة النقض الصادرة في مادة التحفيظ، وما إن كانت مشمولة بحكم منصوص عليه في المادة 109 سالف الذكر أم لا.
يبدو أن أحد أقسام الغرفة الأولى من محكمة النقض سارع إلى إصدار قرار بعدم قبول طلب إعادة النظر في مادة التحفيظ العقاري.
غير أن هذا الاتجاه لا يبدو سليما، وذلك لأن الطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى كان منظما قبل صدور قانون المسطرة المدنية الحالي بالفصل 37 من ظهير 1957/09/27 بشأن إنشاء المجلس الأعلى، الذي كان ينص على أن قرارات المجلس الأعلى قابلة للطعن بالمراجعة (إعادة النظر) ولما صدر قانون المسطرة المدنية الحالي الصادر بظهير 28شتنبر 1974 نظم في الفصل 379 منه طرق الطعن التي يمكن أن تمارس ضد قرارات المجلس الأعلى، ونص على أن تلك القرارات تقبل، دون تمييز، الطعن بإعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في الفصل المذكور، الذي حل محل الفصل 37 من ظهير تأسيس المجلس الأعلى، الذي هو نص خاص في المجال.
ولما كان الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية سالف الذكر حل محل نص خاص، فإنه يأخذ حكم النص الخاص (بتنظيم الطعن في قرارات المجلس الأعلى [محكمة النقض]) وبذلك يتعين الأخذ به، وعدم تخصيصه بنص الفصل 109 من قانون التحفيظ العقاري.
ولعل من مؤيدات هذا التوجه، أن الفصل 109 المذكور يتكلم عن الأحكام، وهو لفظ ينصرف إلى أحكام محاكم الموضوع، كما ينص على أن الأحكام التي يتكلم عليها هي الصادرة في مادة التحفيظ، ولفظ مادة التحفيظ ينصرف إلى المنازعات القائمة بين المتعرضين وطلاب التحفيظ.
كما أن من مؤيدات التوجه المذكور مبدأ عدم التضييق في الحقوق المخول للمتقاضين، مما نص عليه قانون المسطرة المدنية من إعطاء الحق لأطراف الدعوى في الطعن بالنقض في كل القرارات التي لم يستثنها قانون المسطرة المدنية من إمكانية الطعن فيها بالنقض (كما فعل بالنسبة للأحكام غير النهائية، والأحكام الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالواجبات الكرائية).
[1] مدونة الإمام مالك، ج 13، ص. 41 و42.
[2] شرح الحطاب على خليل، في باب الاستحقاق
[3] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 4، ص ص 207.
[4] نفس المرجع، الصحيفة 57 وما بعدها.
[5] انظر محمد القدوري، حيازة العقار كدليل على الملك وسبب فيه، الطبعة الثانية 2009، الصحيفة 128 رقم 8.
[6] انظر نفس المرجع، الصفحة 58 و86.
[7] بشأن هذا النوع من وسائل الإثبات انظر المرجع السابق الصفحة 77.
[8] محمد القدوري، معجم المصطلحات الفقهية.
[9] نفس المرجع؛ وانظر الحجوي، الفكر السامي، ج 2.
[10] ومن أهم النصوص بشأن العمل المطلق، منظومة (العمل المطلق،) التي نظمها وشرحها العلامة سيدي محمد بن أبي القاسم الفيلالي، وهي مطبوعة على الحجر.
[11] من أهم النصوص في العمل الفاسي 1. “نظم العمل” لسيدي عبد الرحمن الفاسي، وهي تتألف 453 بيتا، من أشهر شراحها: شرح سيدي المهدي الوزاني، في “تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس”، وشرح سيدي محمد بن القاسم السجلماسي المشهور بالرباطي. 2. ونظم “لامية الزقاق” لسيدي على الفاسي التجيبي، وهي تتألف من 262 بيتا، وعليها عدة شروح.
[12] كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب، دراسة وتحقيق حمزة أبو فارس، وعبد السلام الشريف دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1980، ص 62 وص 88.
[13] نفس المرجع، ص 62، 63؛ وأصول الفتوى، ص 474 و489.