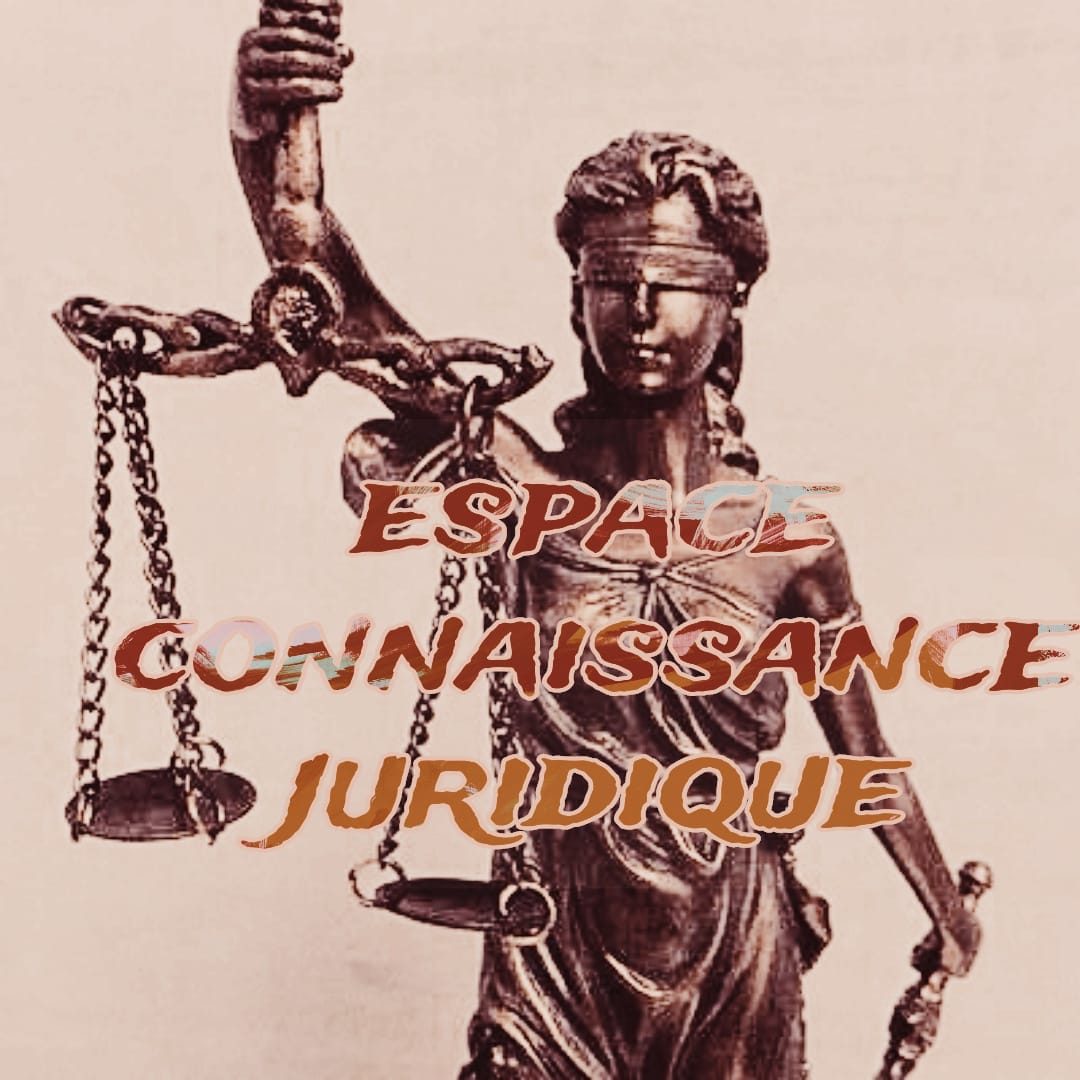محاولة تأصيل في ضوء الفقه والقانون
الوضعي والظروف والحاجيات الواقعية
الأستاذ محمد القدوري
محام بهيئة المحامين بالرباط
إن معالجة “الخطاب” على الوثائق العدلية يقتضي التعريف بالخطاب من الوجهة الفقهية والقانونية، والنظر إلى ما حققه من نتائج وأهداف، وذلك قبل التفكير فيما إن كانت هذه المؤسسة تقتضي البقاء أو التغيير. وهذا ما يقتضي تقسيم هذه المداخلة إلى ثلاث فقرات.
الفقرة الأولى: الخطاب على الوثائق العدلية بين مقتضيات الفقه والقانون
يكاد الفقه المالكي ينفرد بإفاضة بحث مصطلح “الخطاب على الرسوم العدلية” إذ لا يكاد يعرف لهذا المصطلح وجود في فقه المذاهب الأخرى، وإن كان النص عليه عليه في المذاهب الأخرى.
والمراد بمصطلح “الخطاب” الكتاب الذي يوجهه قاضي بلد إلى قاضي بلد آخر ليعلمه بما ثبت لديه من حق لصاحب الوثيقة المخاطب عليها، المقيم في بلد القاضي المخاطب (بالكسر) تجاه أو في ذمة شخص آخر يقيم في بلد القاضي المخاطب (بالفتح) وذلك بغاية أن يقوم القاضي المخاطب باعتماد الوثيقة أو الشهادة التي ثبتت لدى القاضي المخاطب. ويشمل الخطاب بهذا المعنى: الإخبار بالحكم، والإخبار برسوم الإثبات.
وتتناول كتب الفقه المالكي هذا المبحث في باب القضاء([2]).
والخطاب عام، مبدئياً، في سائر الوثائق العدلية: الأصلية منها والاسترعائية.
ذلك أن الشهادات العدلية، ثلاثة أنواع:
- شهادة أصلية: وهي التي يمليها المشهود عليه على العدلين مباشرة، مثل إشهاد المتعاقدين بالبيع أو بالزواج أو بغير ذلك من العقود الشرعية،
- وشهادة عدلية استرعائية: وهي التي تتضمن شهادة عدلين بما في علمهما بشأن المشهود فيه، مثل الشهادة بالعسر أو باليسر أو بالأهلية أو بالحجر أو بالغيبة أو غير ذلك،
- وشهادة لفيفية استرعائية: وهي التي تتضمن سماع عدلين، نيابة عن القاضي، شهادة عدد من الناس وتضمينها في وثيقة لترفع إلى القاضي بقصد العمل بها، وهو ما يطلق عليه شهادة اللفيف. والخطاب يعم أنواع هذه الشهادات كلها، إلا أن شكله وعباراته تختلف من شهادة لأخرى.
فصيغة الخطاب بالنسبة للشهادات الأصلية والاسترعائية تكون بعبارة مفادها أن الشهادة ثبتت لدى القاضي المخاطب (بالكسر) وغالباً ما يكون ذلك بعبارة في أسفل الوثيقة بصيغة “الحمد لله أشهد الفقيه…قاضي مدينة…بثبوت الرسم أعلاه، الثبوت التام بواجبه، وهو حفظه الله بحيث يجب له ذلك من حيث ذكر، وفي…(التاريخ) ولا مانع من أن يرد الخطاب في ذيل الوثيقة المخاطب عليها، أو في وثيقة ملصقة بها، أو ملحقة بها مستقلة عنها؛ وأما صيغة الخطاب على الشهادات اللفيفية فتكون غالباً بعبارة “شهدوا لدى من قدم لذلك لموجبه فثبت وأعلم به”.
فالمراد من الخطاب إذن، حسب ما يؤخذ من المقتضيات الفقهية المشار إليها، إعطاء الوثيقة المخاطب عليها قوة ثبوتية لدى غير القاضي الذي خاطب عليها من القضاة، وإجازة الاعتماد عليها من قبلهم باعتبارها وثيقة ثابتة من حيث الشكل، سليمة المبنى والمعنى.
غير أن دور وأهمية الخطاب على الوثائق لم يقف عند هذا الحد، بل بولغ في الاهتمام به إلى درجة أن الفقهاء جعلوه “روح الشهادة”، وبدونه لا يعتدون بها ويعتبرونها لغواً، ومع توالي الزمن ترسخ المبدأ المذكور وصارت كل وثيقة غير مخاطب عليها فاقدة لأية قيمة، وهو ما يقتضي إلقاء نظرة عن “الخطاب” في المؤلفات الفقهية، ثم تتبع تطوره في نصوص القانون.
أولاً: الخطاب من الوجهة الفقهية
تتناول مؤلفات الفقه المالكي أحكام الخطاب على الوثائق والأحكام في باب القضاء، وقد تولى بحثها أغلب الفقهاء، كما تناولته العديد من المؤلفات الفقهية([3])؛ ويؤخذ من كتب الفقه والنوازل المعتمدة أن الخطاب حق للمشهود له، إن طلبه كان على القاضي أن يجيبه إليه، وأن يمكنه مما يفيد ثبوت الوثيقة المنجزة في دائرة ولايته لدى القاضي الذي يجري التخاصم أمامه اعتماداً على تلك الوثيقة، وإن لم يطلب من يهمه الأمر من القاضي الخطاب على الوثيقة ظل الخطاب أمراً جوازياً. ومن المؤلفات التي تعرضت لهذه الأحكام:
- مختصر الشيخ خليل، بقوله، في باب القضاء “وأنهي لغيره بمشافهة إن كان كل بولايته، وبشاهدين مطلقا، واعتمد عليهما وإن خالفا كتابه، وندب ختمه، وأديا، وإن عند غيره وأفاد”([4])،
- تحفة ابن عاصم، في مستهل “فصل في خطاب القضاة وما يتعلق به”، عند قوله: “ثم الخطاب للرسوم إن طلب حتم على القاضي، وإلا لم يجب”([5])،
- جاء في شرح سيدي محمد ميارة للبيت المذكور ما نصه “إن خطاب القاضي للرسوم إن طلبه منه صاحبها فهو واجب عليه وإن لم يطلبه منه لم يجب عليه ذلك”([6])،
- وجاء في شرح العلامة التوزري للبيت سالف الذكر “إن الإنسان إذا كان له حق بشهادة عدول بلده على آخر في غير عمل قاضي بلده…وأراد صاحب الحق السفر إلى بلد من له عليه الحق ليخاصمه هناك…وخاف…إذا قام على المطلوب لدى قاضي بلده ينكر دعواه، فإذا ستظهر برسمه يطلبه القاضي المترافع لديه بإثباته…، فإذا طلب صاحب الرسم من قاضي بلده الخطاب، بأن يكتب إلى قاضي بلد خصمه بما ثبت عنده من صحة ما شهد به شهود بلده في ذلك الرسم لعدالتهم، وجب عليه ذلك، وإن لم يطلبه فلا يجب عليه”([7]).
ويؤخذ من هذه الأقوال والنقول الفقهية أن الخطاب حق لصاحب الوثيقة المعنية، إن شاء طلبه، وإن لم يحتج إليه تركه؛ وأنه مهما طلبه صار على القاضي المطالب به أن يجيبه لطلبه،
- غير أن سيدي أحمد الرهوني التطواني في على لامية الزقاق، المسمى “حادي الرفاق إلى فهم لامية الزقاق” ذهب، أثناء الحديث عن شهادة اللفيف، أن بعض العدول “…يقتصرون على تسجيل القاضي، ولا يؤدي القاضي عدول التسجيل، وهو أمر عام عندهم في جميع الرسوم المسجلة على القضاة، يقتصرون فيها على وضع علاماتهم في البياض ولا يكتبون أداء الرسم عقبه؛ وفيه تساهل عظيم، لأن بقاء هذا الرسم بدون أداء يصيره كالعدم، إذ الأداء هو روح الشهادة([8])، والشهادة بدونه محض زمام، كما اتفقوا عليه”([9])، الأمر الذي يفيد أن الخطاب على الرسم العدلية أمر واجب وليس مجرد إجراء جوازي لا يصير واجباً إلا إذا طلبه من له مصلحة فيه؛ مع ملاحظة أن هذا النص ورد بشأن الخطاب على الرسوم اللفيفية، التي يتلقى فيها العدول شهادة اللفيف، ولم يرد بشأن الرسوم الأصلية التي يتلقاها العدول من المشهود عليهم مباشرة، مما يمكن معه القول إن الفقه لا يختلف في أن الخطاب على الأحكام والرسوم المتضمنة شهادات أصلية، هو أمر جوازي.
ثانياً: الخطاب في التشريع الوطني
- لعل أول نص قانوني مغربي تناول مصطلح “الخطاب” هو النص العربي للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، بقوله، في المقطع رقم 1 من فقرته الثانية “وتكون رسمية أيضاً: 1. الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم”؛ مع ملاحظة أن قانون الالتزامات والعقود صدر باللغة الفرنسية ولم تظهر له ترجمة عربية إلا بعد صدور قانون التوحيد والتعريب والمغربة، الذي وافق عليه مجلس المستشارين بالإجماع في 6 صفر 1384 (17/06/1964) ثم صدر الأمر الملكي بتنفيذه في 22 رمضان 1384 (26/01/1965) ([10]) وذلك عندما نشرت وزارة العدل، لأول مرة، صيغة عربية لقانون الالتزامات والعقود، وذلك في العدد 76/78 من مجلة القضاء والقانون (فبراير/إبريل 1965) مع ملاحظة أن النص الفرنسي للمقطع 1 من الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقد، ورد بالصيغة الآتية:
“Sont également authentiques: 1. Les actes reçus officiellement par les tribunaux cadis en leur….”
ويبدو من تأمل هذا النص أن مصطلح “الخطاب” جاء كترجمة للكلمة الفرنسية “reçus”، مما يبعث على الشك فيما إن كان المقصود من الكلمة المذكورة يوم وضع نص الفصل 418 المذكور هو فعلاً مصطلح الخطاب، أو هو مجرد المعنى اللغوي لكلمة “reçu”، التي تعني، من الوجهة اللغوية: استقبل، أقر، تسلم، تلقى، تناول، حصل، قبل؛ والذي يمكن أن يعطي له معنى قانوني من هذه الكلمات إنما هو “أقر” و”قبل”. مما ينبغي معه أن تكون الترجمة الدقيقة للعبارة الفرنسية سالفة الذكر هي “الأوراق التي يقرها القضاة في محاكمهم” أو “الأوراق التي يقبلها القضاة في محاكمهم”، ولا يمكن التسليم بأن المقصود من كلمة “reçu” هو الخطاب بمعناه الاصطلاحي. وأمام هذا لا نستطيع الجزم بأن قانون الالتزامات والعقود هو أول نص قانوني يستعمل مصطلح الخطاب.
- وعندما تم تقنين التوثيق في القانون الوضعي احتلت مسألة الخطاب مرتبة هامة في سائر النصوص التي توالت، وذلك منذ صدور منشور وزارة العدل عدد 6410 بتاريخ 10 رمضان 1366(29/07/1947) بشأن منع القضاة من الخطاب على الرسوم قبل إدخالها لكناش الجيب المنظم([11])، ثم منشور وزارة العدل عدد 14714 الصادر في 2 جمادى الأولى 1379 (03/11/1959) بشأن كيفية تأسيس الوثيقة وتحريرها([12]). ويبدو أن مقتضيات المنشور 6410 التي منعت الخطاب على مختلف الرسوم العدلية إلا بعد تضمنيها وفق الضوابط المتعلقة بحفظ وتضمين الشهادات، غيرت من مفهوم الخطاب، من مجرد إخبار من القاضي الذي حررت الوثيقة في دائرته إلى غيره من القضاة، وجعلته – أي الخطاب- يعني حفظ الشهادة في سجلات وكنانيش تمكن من له الحق والمصلحة في الرجوع إليها للإطلاع والمقارنة وأخذ النسخ.
غير أنه بتتبع النظام الذي أوجبته الضوابط العدلية لحفظ الوثائق، بدء من كناش الجيب، وكناش التحصين([13])، وكنانيش التضمين([14])، وانتهاء بمذكرة الحفظ (التي حلت محل كناش الجيب) وما أصبح يجري به العمل من الاقتصار على كنانيش التضمين (والاستغناء عن كناش التحصين)…كل ذلك يوحي بشكل واضح أن مهمة حفظ الوثائق العدلية مستقلة عن مسألة الخطاب.
إلا أن هناك إشكالية إدارية تتجلى في أن عملية تضمين الوثائق العدلية بكنانيش الحفظ لا تتم، من الوجهة العملية، إلا بعد أن تكون الرسوم المعنية بالتضمين مخاطباً عليها من قبل القاضي، مما يجعل الخطاب وكأنه مرحلة من مراحل التضمين، أو شرطاً من شروط القيام به، فأصبحت الغاية منه بناء على ما ذكر تتعدى الخطاب، إلى كونه مقدمة من مقدمات التضمين.
- وعند تقنين خطة العدالة بالقانون رقم 81.11 بشأن تنظيم خطة العدالة وتحريرها، الصاد الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.882.81 الصادر في 11 رجب 1402 (06/05/1982)، نص على ضرورة الخطاب على الرسوم العدلية.
- ثم إنه عند إلغاء القانون المذكور، بالقانون رقم 03.16 بشأن تنظيم خطة العدالة، المأمور بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 56.06.1 الصادر في 15 محرم 1427 (14/02/2006)، نصت المادة 34 منه على أن “يؤدي العدلان الشهادة لدى القاضي المكلف بالتوثيق، بتقديم وثيقتها إليه مكتوبة وفق المقتضيات المقررة في هذا القانون، وفيها يؤدي العدلان الشهادة لدى القاضي المكلف بالتوثيق، بتقديم وثيقتها إليه مكتوبة وفق المقتضيات المقررة في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه، بقصد مراقبتها والخطاب عليها”. كما نصت المادة 35 من القانون المذكور، في فقرتها الأولى على أن “يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق على الشهادات بعد إتمام الإجراءات اللازمة، والتأكد من خلوها من النقص، وسلامتها من الخلل، وذلك بالإعلام بأدائها ومراقبتها”، وقالت في فقرتها الثانية “يمنع على القاضي أن يخاطب على الشهادات الخاضعة لواجبات التسجيل إلا بعد تأديتها”، وأضافت في فقرتها الثالثة والأخيرة “لا تكون الوثيقة تامة إلا إذا كانت مذيلة بالخطاب، وتعتبر حينه وثيقة رسمية”.
ويؤخذـ من عبارات المادتين 34 و 35 سالفتي الذكر، أن الغاية من الخطاب هي: مراقبة الوثيقة العدلية والخطاب عليها؛ ومراقبة استيفاء رسوم التسجيل الواجبة على الشهادة موضوع الوثيقة؛ وإضفاء الصبغة الرسمية على الوثيقة.
وفي ضوء ما ذكر، لا مناص من القول، من الوجهة التشريعية في ظل القانون الحالي، إن الخطاب ركن من أركان الوثيقة، وبدونها لا تعتبر وثيقة رسمية، ولا تامة.
ثالثاً: مناقشة الأهمية العملية للخطاب
ومن خلال ما ذكر نتساءل هل للخطاب، كما يتم العمل به الآن، دور في نجاعة “التوثيق العدلي” وهل وراءه من جدوى؛ وهل من الضروري أو من المصلحة بقاؤه، أو يكون من المصلحة إلغاؤه؟
إن إبداء رأي في هذا الصدد لا ينبغي أن يتم ارتجالاً، بل لابد من تأصيل المسألة في ضوء المصلحة العامة، استئناساً بالفقه، وبالقانون المقارن؛ وقد أشير أعلاه إلى أهم مقتضيات كل منهما، التي يؤخذ منها:
من الوجهة الفقهية: أن الخطاب حق للمشهود له، إن طلبه كان على القاضي أن يجيبه إليه، ويمكنه مما يفيد ثبوت الوثيقة المنجزة في دائرة ولايته لدى القاضي الذي يجري التخاصم أمامه اعتماداً على تلك الوثيقة، وإن يطلب صاحب الشأن ذلك ظل الخطاب أمراً جوازياً، مباحاً؛ كما أفاتج نصوص: مختصر الشيخ خليل، وتحفة ابن عاصم وشراحها، وشراح لامية الزقاق، غير أن هؤلاء جعلوا الخطاب “روح الشهادة” في مجال اللفيف.
ومن هذه الأقوال والنقول الفقهية يتضح أن الخطاب حق لصاحب الوثيقة المعنية، إن شاء طلبه، وإن لم يحتج إليه تركه؛ وأنه مهما طلبه صار على القاضي المطالب به أن يجيبه لطلبه.
كما يؤخذ من النصوص السابقة أن الغاية من “الخطاب” إنما هي مجرد إخبار القاضي الذي يقع التخاصم لديه بأن الوثيقة المخاطب عليها هي فعلاً وثيقة رسمية، يصح اعتمادها والعمل بها.
ويستخلص مما ذكر أن الخطاب لا يستهدف مهمة “حفظ الوثيقة”.
ومن الوجهة القانونية: غير أن قول المادة 34 من القانون 03.16 بشأن تنظيم خطة العدالة: “يؤدي العدلان الشهادة لدى القاضي المكلف بالتوثيق، بتقديم وثيقتها إليه مكتوبة وفق المقتضيات المقررة في هذا القانون، وفيها يؤدي العدلان الشهادة لدى القاضي المكلف بالتوثيق، بتقديم وثيقتها إليه مكتوبة وفق المقتضيات المقررة في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه، بقصد مراقبتها والخطاب عليها”، قد يفيد أن للخطاب وظيفة أخرى غير وظيفة الإخبار. وأن الأمر يتعلق بأمرين: المراقبة، والخطاب؛ فكأن قاضي التوثيق جعل مراقباً على العدول يتعقب نشاطهم التوثيقي، ولا يخاطب عليه إلا إذا بدا له أنه سليم؛ كما أن قول الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون المذكور: “لا تكون الوثيقة تامة إلا إذا كانت مذيلة بالخطاب، وتعتبر حينه وثيقة رسمية”، يؤيد ما يفهم من المادة 34 قبلها. ومن هنا يتضح أن المشرع خرج بالخطاب عن مهمته الفقهية التي هي مجرد الإخبار بصحة الوثيقة، إلى مهمة الحكم على جوهر الوثيقة والحسم في جعلها – بالخطاب- وثيقة رسمية أو رفض الخطاب عليها وتجريدها من صفة الوثيقة الرسمية.
وهذا المعنى أو الحكم الذي توحي به صياغة المادتين 34 و 34 من القانون رقم 16-03 بشأن تنظيم خطة العدالة يطرح السؤال الآتي: هل للخطاب أثر على جوهر الوثيقة أمام قضاء الحكم، بحيث تصبح، نتيجة للخطاب عليها، وثيقة عاملة، أم أن الأمر يقتصر على مجرد الشكليات؛ وبالمقابل، وإذا قلنا إن مراقبة قاضي التوثيق للوثائق العدلية يقتصر على الجانب الشكلي، فهل يبقى لقضاء الموضوع الناظر في النزاع الذي يستدل فيه بالوثيقة المخاطب عليها سلطة في إعادة مراقبة شكليات الوثيقة المخاطب عليها من قبل قاضي التوثيق، أو أن الخطاب يقتضي أن سلامة الوثيقة العدلية شكلاً أمر صار محسوماً؛ ومتى كان الجواب بالإيجاب، وببقاء الحق لقضاة الموضوع في مراقبة سلامة الوثيقة العدلية: شكلاً، وجوهراً (وهو الواقع)، فما الفائدة من مراقبة قاضي التوثيق، عن طريق الخطاب، مادامت مجردة من أي أثر؟.
ثم إنه لابد من التساؤل، في ضوء التشريع القائم، حول ما إن كان حكم وأثر الخطاب واحداً في الرسوم العدية الأصلية، وفي “اللفيفيات”، معاً؛ أو أن الخطاب ضروري في “اللفيفات”، دون الوثائق الأصلية. والأمر الذي يفرض هذه التفرقة يكمن في أن سماع العدول لشهادات اللفيف ليس من صميم وظيفتهم، وإنما هو من صميم عمل القضاء، والعدول، الذين لا يقومون به إلا باعتبارهم نواباً عن القاضي، ومفوضاً إليهم من قبله في السماع المذكور؛ كما تفيده صيغة الخطاب على اللفيفيات، الذي يكون عادة بعبارة “الحمد لله، شهدوا لدى من قدم لذلك لموجبه، فثبت، وأعلم به”، كما مر آنفاً؛ ولو أن هذا التمييز في وجوب الخطاب على الشهادات اللفيفية، وعدم لزومه في الشهادات الأصلية، لا يبدو له مبرر جدي، في نطاق التنظيم القضائي القائم، وذلك لكون قاضي التوثيق ليس هو قاضي الحكم الذي يتولى سماع الشهود، ويتمتع بسلطة تقديرية في “التعديل والتجريح” لدرجة يحق له معها أن يستند في ذلك إلى معلوماته الشخصية، حسب التفصيل الوارد لدى الفقهاء في هذا المجال.
رابعاً: الخطاب في التشريع المقارن
- من الجانب الفقهي يلاحظ أن نصوص الفقه المالكي المقررة بشأن التوثيق العدلي، بما في ذلك الخطاب على الأحكام والرسوم، هي قواعد فقهية تهم سائر أقطار ما يصطلح عليه، الغرب الإسلامي، الشامل لأقطار: المغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر؛ وهي قواعد كانت تطبق في بلاد الأندلس أيضاً؛ الأمر الذي يسمح بالقول إن أحكام “الخطاب” كانت موحدة في الأقطار المذكورة.
غير أنه لما وضعت القواعد القانونية الوضعية وحلت نصوصها محل النصوص الفقهية، أخذت إعمال القواعد الفقهية المذكورة ينكمش شيئاً فشيئاً، وتحل محلها النصوص الوضعية، التي وإن كانت متقاربة فإنها تختلف من دولة إلى أخرى:
- فالمغرب اتبع الضوابط المشار إليها أعلاه، بشأن الخطاب، من حيث الشكل، ولو أنه ظل من حيث الجوهر يطبق القواعد الفقهية المذكورة، إلا فيما ورد بشأنه نص وضعي خاص مخالف،
- والمشرع الجزائري وحد تنظيم التوثيق، وأخذ بنظام الكاتب العدل، الذي يتولى توثيق جميع المعاملات؛ وجاءت المادة 18 من قانون الأسرة، رقم 11/84 الصادر في 9 رمضان 1404 (09/06/1984) تقرر أن “يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانوناً، مع مراعاة ما ورد في المادة 9 من هذا القانون” [وتنص المادة 9 المحال عليها على أن “يتم الزواج برضا الزوجين وبولي الزوجة، وشاهدين، وصداق”]،
ج. والمشرع التونسي أخذ بنظام الكاتب العدل أيضاً، فيما يخلص توثيق المعاملات، وبشأن عقود الزواج نصت المادة 3 من “مجلة الأحوال الشخصية” الصادر بالأمر المؤرخ في 6 محرم 1376 (13 أوت 1956) على أن “لا ينعقد الزواج إلا برضا الزوجين. ويشترط لصحة الزواج إشهاد شاهدين من أهل الثقة وتسمية مهر للزوجة”.
ومن خلال الإطلاع على بعض عقود الزواج التونسية تبين أن تبرم أمام “كاتبي عدل” يقع التعريف بإمضائيهما، ولا تتضمن عقود الزواج المذكورة أي “خطاب”.
الفقرة الثانية: هل ما يزال للخطاب على الوثائق العدلية يحقق نتائج وأهداف تقتضي بقاءه على حالته؟
يتضح من التطور التاريخي سالف الذكر لأنظمة التوثيق أن المسيرة في طريقها إلى إلغاء “الخطاب” بمعناه الفقهي، والتشريعي، سالفي الذكر؛ وتعويضه بتدابير أخرى تكون أسرع وأنجع.
من الواضح أن العدول، ممثلين في الهيئة الوطنية لعدول المغرب، ما فتئوا ينادون بإلغاء الخطاب، وهيئتهم تسعى إلى تحقيق هذا المبتغى؛ وحجبها في ذلك:
أن “الخطاب” لا يكاد يحقق أدنى حماية أو فائدة لا للعدلين، ولا المتعاقدين، لكون مراقبة قاضي التوثيق للوثيقة العدلية من حيث الشكل صارت في الغالب أمراً روتينياً، ولأن تلك المراقبة حتى لو وقعت بشكل دقيق لا تدفع عن العدول غائلة المؤاخذات التأديبية التي يتعرض لها العديد منهم بشأن رسوم مخاطب عليها؛ ولا يحقق – أي الخطاب- للمتعاقدين والمعنيين بالوثائق العدلية أية حماية بشأن مضمون الوثيقة، لأن كثيراً من الرسوم العدلية يتم استبعادها من قبل القضاء لأسباب ترجع تارة لعدم التقيد ببعض القواعد الفقهية الموضوعية، وتارة لعدم التقيد ببعض الشكليات، ولا يجدي أصحاب الشأن أن يتمسكوا بأن تلك الوثائق “مخاطب” عليها من قبل قضاة التوثيق.
أن “الخطاب” كثيراً ما يكون عرقلة أمام ذوي الشأن في الإسراع بإنجاز الوثيقة العدلية، ويكون سبباً للبطء في إنجاز الوثيقة.
والواضح نصاً من المادة 34 من القانون 16.03 بشأن تنظيم خطة العدالة أن على العدلين أن “يؤديا” شهادتهما أمام قاضي التوثيق، مكتوبة، وهو ما يقتضي أن الوثيقة العدلية يجب أن تخضع لفحص شكلي وجوهري من قبل قاضي التوثيق، لمراقبة سلامتها من أي خلل، وهذا المقتضى التشريعي يذكرنا بما كان يخضع له “طلبة” القرآن الكريم من القيام، إثر كل حصة يومية من الحفظ، من “عرض” على الفقيه الملقن ليختبر طلبته”: حفظاً، ورسماً، وأداء…؛ كما أن الواضح من المادة 35 من القانون المذكور، أن قاضي التوثيق “يخاطب..على الشهادات بعد إتمام الإجراءات اللازمة، والتأكد من خلوها من النقص، وسلامتها من الخلل، وذلك بالإعلام بأدائها ومراقبتها”، وهذا ما يعني أن الغاية من الخطاب أمران: مراقبة الوثيقة، والإعلام بأدائها وصلاحيتها.
في ضوء ما ذكر، نفحص الوثيقة العدلية، توخياً لما ورد في المادتين 34 و35 سالفتي الذكر، لنرى ما إن كان الأداء والخطاب قد أدى دورهما القانوني المتوخى منهما.
لاشك أن من أهم ما ينبغي أن تتسم به الوثيقة العدلية، شأنها شأن كل عقد أو اتفاق أو معاهدة، يكمن في ثلاث صفات، أو شروط، هي:
1. سلامة الوثيقة من حيث اللغة وذلك بوجوب اتسامها بالوضوح وسلامتها من الإجمال والإبهام والقصور والسلامة ومراعاتها لمعاني الألفاظ اللغوية والاصطلاحية وسلامتها من التضارب والتنافر؛
2. واستيفائها للأركان والشروط المتطلبة، فقهاً وقانوناً، في المعاملة أو التصرف موضوع التوثيق؛
3. وصدروها وفق إرادة المتعاقدين وتطابقها مع رغبتهما تطابقاً تاماً.
وهذه المناحي الثلاث هي أول ما يجب أن تشمله مراقبة قاضي التوثيق قبل الخطاب على أية وثيقة عدلية، فهل تحققت هذه الغاية من خلال الخطاب في ضوء النص السابق؟.
على المستوى اللغوي: إن المتتبع بتأمل للقضايا العديدة الرائجة أمام المحاكم يلحظ أن كثيراً من المنازعات تستغرق وقتاً طويلاً، وتكون النتيجة في كثير من الأحيان ضياع حقوق، ومن أمثلة ما يعتري بعض الوثائق العدلية في هذا المجال ما ينجم عن استعمال ألفاظ مشتركة، أو مبهمة، مثل: التعبير في بعض الوصايا للأحفاد بلفظ “الولد”، فيقع الخلاف بين الحفدة حول ما إن كان المقصود بالولد هو عموم الذكور والإناث، كما تقتضيه اللغة، أو خصوص الذكر، كما قد يقتضيه العرف عند بعض الناس…؛ ومثل التعبير بعبارة “المدة المقررة شرعاً”([15]) في بيان شرط المدة في وثائق الملكية والحيازة، وذلك عوض التعبير عن مدة الحيازة بعدد السنوات، مما ينجم عنه خلاف كبير وضياع حقوق عديدة، نتيجة لبعض مواقف القضاء،
وعلى المستوى الاصطلاحي: كما هو الشأن بالنسبة للجانب اللغوي، فإن المشتغل بفن التوثيق والقضاء المتأمل للوثائق التي يتبادلها الخصوم، يصطدم بنقاشات مبناها أمور اصطلاحية، من مثل استعمال عبارة “من غير علم منازع” (عوض من غير منازع)، وعدم التنصيص في العطايا على “معاينة الحوز”؛ وعدم الدقة في بيان “مستند علم الشهود” عند استعراض شروط الملك؛ واستعمال ألفاظ وعبارات عرفية أو غير واضحة في التعبير عن بعض الأمور الضرورية في الوثيقة، مثل استعمال “حرث العبرة” أو “حرث زوجة” في التعبير عن المساحة، أو استعمال “الذراع” في التعبير عن القياس، واستعمال “اليمين” و”الجوف”([16]) و “الصحراء” في التعبير عن الجهات…وذلك عوض استعمال الألفاظ الاصطلاحية الواضحة، مما يكون سبباً في منازعات كثيرة وتأويلات،
وعلى المستوى الفقهي: نصادف بعض الوثائق يتوقف فهمها على واقعة أو عنصر أو وصف لم يرد فيها، كان على العدل أن يذكره، مثل خلو رسم الإراثة المتضمن للأم من بين الورثة من ذكر وجود أو عدم وجود إخوة لأم للهالك، حالة أن وجودهم يحجب الأم. حجب نقل، من الثالث إلى السدس، استثناء من قاعدة كل من لا يرث لا يحجب وارثاً، كما هو معلوم.
الفقرة الثالثة: هل حالت مراقبة قاضي التوثيق وخطابه دون وجود إخلالات؟ وهل حققت للعدول حماية؟
إن المتأمل لأحكام القضاء على مختلف مستويات المحاكم، أن كثيراً من الوثائق العدلية يتم إهمالها وعدم إعمالها، لأسباب شكلية تارة، ولأسباب موضوعية تارة أخرى، على الرغم من خضوعها “للفحص التقني” من قبل قضاة التوثيق، عبر، عمليتي “الأداء” و”الخطاب”…والأمثلة كثيرة لا حصر لها: فهذه ملكية استبعدت لعدم صلاحية “مستند علم شهودها” وهذه وثيقة رفضت وأهملت لخلوها من التنصيص على “أتمية المشهود عليهم”، وتلك ملكية ردت وضاع حق صاحبها لكونها عبرت عن مدة الحيازة بعبرة “المدة المعتبرة شرعاً” لرجحان حجة خصم صاحبها بقدم التصرف لتعبيرها عن مدة الحيازة بعبارة 20 سنة مثلاً، مع أن صاحب الملكية المستبعدة يحوز المدعى فيه مدة أطول، عبرت عنها الوثيقة بالعبارة الآنفة….
ومن جانب آخر فإن عدداً غير قليل من العدول يتابعون جنائياً بالتزوير في وثائق رسمية، والحال أن صبغة الرسمية لا تضفي على الوثائق التي يتولى العدول الإشهاد فيها إلا بعد الخطاب عليها، عملاً بصريح المادة 35 من القانون 16.03 سالف الذكر؛ الأمر الذي يقتضي، منطقاً وقانوناً، أن “الشهادة” المضمنة في مذكرة الحفظ لا تعتبر وثيقة رسمية إلا بعد “أدائها” أمام القاضي و”الخطاب” عليها من قبله، وأن “الأداء” و”الخطاب” يقتضيان أن الوثيقة سالمة من كل عيب شكلي أو جوهري.
في حين أن متابعات جنائية تجري في حق عدول من أجل جناية تزوير وثائق رسمية، والحال أن بعض الوثائق محل المتابعات غير مخاطب عليها.
وفي حين أن وثائق مخاطب عليها ترد وتهمل من قبل القضاء، لأسباب شكلية تارة، ولأسباب موضوعية تارات أخرى؛ كما أن متابعات جنائية كثيرة تجري ضد عدول من جراء هذه الوثائق، من غير أن يخول لهم “الأداء” و”الخاطب” أية حماية أو وقاية.
وأمام هذا الأمر، يمكن القول إن “الأداء” و”الخطاب” لم يحققا المبتغى من ورائهما؛ ومن هنا يمكن القول إن “الخطاب” صار عملية روتينية لا مفعول له ولا جدوى، لا بالنسبة لذوي الشأن ولا بالنسبة للعدول؛ ويمكن من ثمة القول إن المناداة بإلغاء الخطاب تجد لها أساساً من الواقع العملي.
هذا إن قلنا إن دور “الأداء” و”الخطاب” (كما تقول المادة 34 من القانون المنظم لخطة العدالة) هو مراقبة الوثيقة من حيث الشروط المقررة فيها، وأن الخطاب (كما تقول المادة 35 من القانون المذكور) هو الذي يضفي على الوثيقة “الصبغة الرسمية” أو هو بتعبير الفقهاء “روح الشهادة”.
لكن، إذا قلنا إن مهمة “الأداء” و”الخطاب” يتعديان ما ذكر، إلى كونهما من مقدمات “حفظ” الوثيقة ضمن أرشيف رسمي، يتأتى الرجوع إليه عند الحاجة، مهما مر من زمن، باعتباره “مستودعاً” لحجج ووثائق، تحفظ الأموال والحقوق والأنساب…فإننا قد نصبح أمام موقف آخر.
فما هو الحل:
أما الآراء والمبررات السابقة، يتعين –لإبداء رأي في الموضوع- البحث عن أجوبة مقنعة للأسئلة الآتية:
- ما الغاية الحقيقية من “الخطاب”؟ أهي مجرد “خطاب” (=إعلام) القضاة الذين لا يشمل نفوذ القاضي المخاطب مناطق ولايتهم، أو هي مراقبة الوثيقة من قبل قاضي التوثيق للتأكد من استيفائها للشروط المقررة فقهاً، وتشريعاً، أو هي، زيادة على هذا وذاك، ضمان حفظ الوثيقة وإتاحة الفرصة لمن له الحق فيها لأخذ نسخ منها؛
- إذا كانت الغاية من الخطاب هي مجرد إخبار قضاة البلدان الأخرى بصحة وثبوت الوثيقة المخاطب عليها، ألا يغني عن ذلك، بالنسبة لقضاة المملكة: أن العدول يعينون الآن من قبل وزارة العدل والحريات وهم معروفون في مجموع أرجاء المملكة؛ وبالنسبة لقضاة وسلطات البلدان الأخرى: أن إجراءات تذييل الوثائق بالصيغ التنفيذية، والتعريف بها الطرق القضائية والدبلوماسية، وعبر الاتفاقات والمواثيق بين الدول المعنية، تغني عن الخطاب؛ سيما وأن المقرر فقهاً- كما سبق أعلاه- أن “الخطاب” جوازي، ما لم يطلبه صاحب المصلحة، فهي يبقى مبرر للتسوية، من حيث أحكام الخطاب، بين الوثائق الأصلية وبين الوثائق اللفيفية.
أو ينبغي قصر وجوب الخطاب على الوثيقة اللفيفية، باعتبار أن العدول إنما يتولون سماع شهود اللفيف بحكم النيابة عن القاضي، مما ينبغي معه أن يحتفظ القاضي المنوب عنه في سماع الشهود من قبل العدليين بسلطة مراقبة العدول الذين نابوا عنه في السماع، بالخطاب على الرسوم “اللفيفية التي ينجزونها في هذا الشأن([17])، والاستغناء عنه في الشهادات الأصلية.
وكذلك الأمر إن كانت الغاية من الخطاب هي “المراقبة”، التي تعني أنه يفترض في الوثيقة المخاطب عليها أنها سليمة شكلاً ومضموناً، وذلك لكثرة ما نصادفه من عدم إعمال قضاء الحكم لكثير من الوثائق العدلية، لعيوب شكلية أو جوهرية، مما يجعل “الخطاب” مجرد أمر شكلي، زائد، لا فائدة من ورائه، ولا ضرورة له.
ونفس الأمر ينطبق على أثر “الخطاب” على مسؤولية العدل “المخاطب” (فتحاً) على وثيقته، لما نراه من كثرة مساءلة العدول، مدنياً (أمام غرف المشورة) وجنائياً (أما غرف الجنايات) من وثائق مخاطب عليها، في غياب أية مسؤولية عن تلك الوثائق بالنسبة للقاضي الذي خاطب عليها مما لا يشفع للعدول في كون الوثيقة التي تلقوها مخاطباً عليها، ويجعل الخطاب غير ذي أثر.
وذلك لأنه إذا لم يكن “الخطاب” ضماناً لسلامة الوثيقة، ولا حماية للعدل، فما الفائدة منه، وما جدوى بقائه؛ والقاعدة أن أقوال وأفعال العقلاء يجب أن تصان عن العبث،
- أما إذا قلنا إن مهمة “الخطاب” تتعدى ما سلف، من المراقبة والإعلام، إلى كونه وسيلة لضمتن “حفظ” الوثيقة في “مستودع” لتظل رهن إشارة كل من له الحق، وهو ما لا يفهم بوضوح لا من قواعد الفقه ولا من نصوص القانون، فإنه يمكن القول بإبقاء “الخطاب”، لوجود فائدة فيه.
وإلا ينبغي البحث عن بديل يضمن “حفظ” الوثيقة العدلية و”صيانتها” وصيانة الحقوق التي تتضمنها من الضياع ومن العبث،
- وفي هذا السياق يمكن أن نتساءل عما إن كانت المقتضيات التي جاء بها القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، الصادر الأمر بتنفيذه ونشره بالظهير شريف رقم 1.07.167 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)، أن يضطلع بدور حفظ الوثيقة العدلية، وتزويد ذوي الشأن بنسخ منها عند الحاجة، وسد الثغرة التي يمكن أن تحدث في مجال الحفظ،
- هذه أرضية متواضعة للموضوع.
ولا شك أن النقاش الذي سيعقب العروض التي تلقى في هذا اللقاء، سوف تغني الموضوع وتثريه، بما يسمح بإبداء آراء ومقترحات على مستوى من المسؤولية والوعي بالأمر والتأمل فيه تأملاً رزيناً وهادفاً مؤسساً على ضوابط ومبررات.
وما لم يفض ذلك إلى رأي معاكس، وما دامت المهمة الإعلامية للخطاب لم تعد لها ضرورة، ولا تتوخى منها فائدة؛ كما أنه مادام الخطاب لم يعد يحقق فائدة واضحة لا للعدلين ولا لأطراف الوثيقة، وعملاً بقاعدة أن الأسباب تدور مع مسبباتها وجوداً وعدماً، فإنه يبدو أن الاستغناء عن الخطاب بات أمراً مطلوباً.
والله سبحانه وتعالى أعلم بالحق والصواب، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
[1] عرض ألقي في المنتدى العربي للتوثيق الذي نظمته الهيئة الوطنية لعدول المغرب يومي 6 و7 رجب 1434 (17 و18 ماي 2013) تحت شعار “التوثيق العدلي بين الخصوصية المغربية والتجارب العربية وتحديات العولمة”.
[2] ينظر:
أ. شراح تحفة ابن عاصم في الأبيات 85/100، ولاسيما:
(1). “توضيح الأحكام على تحفة الحكام”: تأليف الشيخ سيدي عثمان ابن المكي التوزري، الطبعة الأولى 1993، المطبعة التونسية، الجزء 1، ص. 52/63،
(2). “البهجة في شرح التحفة”: تأليف التسولي، ضبط وتصحيح محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية 1418/1998، ص. 188/138،
(3). “الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام”: تأليف سيدي محمد ميارة، ج1، ص. 41،
(4). حاشية الحسن بن رحال المعداني: على الشرح المذكور، المطبوع بهامشه.
ب. “القوانين الفقهية”: تأليف محمد بن أحمد بن جزي، مطبعة الأمنية بالرباط، الطبعة الثالثة 1382/1962، ص. 219،
ج. “الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية على مذهب المالكية”: تأليف الشيخ جعيط، مكتبة الاستقامة، تونس، ص. 226.
[3] ينظر على سبيل المثال “كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس”: للعلامة الفقهية المحدث الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني الدمشقي،
عناية عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب، الطبعة الأولى، 1414/1993، ص. 96/97.
[4] ينظر متن “مختصر خليل” (آخر “باب القضاء”).
[5] تنظر منظومة ابن عاصم المشهورة عند المغاربة بـ “التحفة”: “فصل في خطاب القضاة”، البيت رقم 85.
[6] ينظر الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام: ج1، ص. 41.
[7] ينظر توضيح الأحكام على تحفة الحكام: تأليف العلامة التوزري، المطبعة التونسية، الطبعة الأولى، 1331، ج1، ص. 52.
[8] وهذه القاعدة هي التي تقررها الفقرة 3 من المادة 35 من القانون 03.16 بشأن تنظيم خطة العدالة، المأمور بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 56.06.1 الصادر في 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006)، من أن الوثيقة العدلية لا تعتبر رسمية إلا بعد الخطاب عليها من قبل القاضي.
[9] تنظر موسوعة قواعد الفقه والتوثيق المستخرجة من حادي الرفاق، وضع وترتيب وتعليق: محمد القدوري، الطبعة الأولى، 2004، ص. 242.
[10] منشور بالجريدة الرسمية عدد 2727، الصادر بتاريخ 1 شوال 1384 الموافق لـ 3 يناير 1965، ص. 208.
[11] تنظر المجموعة المنيرة الصادرة عن وزارة العدل، مطبعة ماروك ماتان بالرباط، 1952، ص. 101؛ وقد تناول هذا المنشور أهم القواعد المتعلقة بالشهادات العدلية، وذلك في تسعة فصول، تحت العناوين الآتية: المتعاقدان اللفيف، المشهود فيه، تاريخ الوثيقة، المبالغ المالية، مستندات الوثيقة، وثيقة الملكية، الشهدات اللفيفية، مسائل متفرقة، تحرير الوثيقة.
[12] تنظر مجموعة المناشير الصادرة عن وزارة العدل بشأن محاكم قضاة الأحوال الشخصية 1957/1959، ص. 107.
[13] كناش التحصين هو سجل خاص، كانت ضوابط توثيق وحفظ الشهادات العدلية توجب على كل عدل لم يتمكن من تضمين شهادته في كناش الحفظ خلال الأجل المقرر، أن يقيدها في سجل التحصين، إلى أن يستكمل إجراءات إدراجها في كناش الحفظ، وإلا بطلت، ينظر بشأن شهادة اللفيف بحث محمد القدوري بعنوان “اللفيف ومقوماته في الفقه الإسلامي”، مجلة المحاماة، جمعية هيآت المحامين بالمغرب، العدد 21 يناير/إبريل 1985، ص. 69/82.
[14] أوجب الفصل 25 من المرسوم الصادر بتاريخ 18 ماي 1993، بشأن تطبيق قانون تنظيم خطة العدالة، أن يتم تضمين الوثائق العدلية حسب مواضعها في سجلات أربع، هي: سجل الأملاك العقارية، وسجل التركات والوصايا والتقديم، وسجل وثائق الزواج والطلاق، وسجل باقي الوثائق (الذي يعبر عنه بسجل المختلفة).
[15] دأب المجلس الأعلى (محكمة النقض حالياً) على عدم الاعتداد برسوم الملكية التي تعبر عن مدة الحيازة بعبارة “المدة المقررة فقهاً”، ولا تتضمن مدة الحيازة بعدد السنين، وذلك رغم أن حذاق الموثقين والفقهاء مجمعون على عبارة “المدة المقررة شرعاً” جرى العرف باستعمالها، وأن العرف كالشرع.
للوقوف على مزيد من النقاش في هذا الأمر ينظر: “حيازة العقار كدليل على الملك وسبب فيه”، تأليف محمد القدوري، مطبعة الأمنية، الطبعة الثانية 1430/2009، ص. 49.
[16] في شأن تعبير “الجوف” والمراد منه عند عدول المغرب، ينظر: المرجع السابق، ص. 84، هامش رقم 1.
[17] وذلك لأن القاضي يملك السلطة التقديرية في قبول شهادة أي شخص أو ردها، وله أن يستند في ذلك إلى علمه الخاص، كما هو معلوم ومسلم فقهاً.
ينظر شراح مختصر الشيخ خليل: لدى قوله- في باب القضاء- “ولا يستند لعلمه إلا في التعديل والتجريح كالشهرة بذلك”.