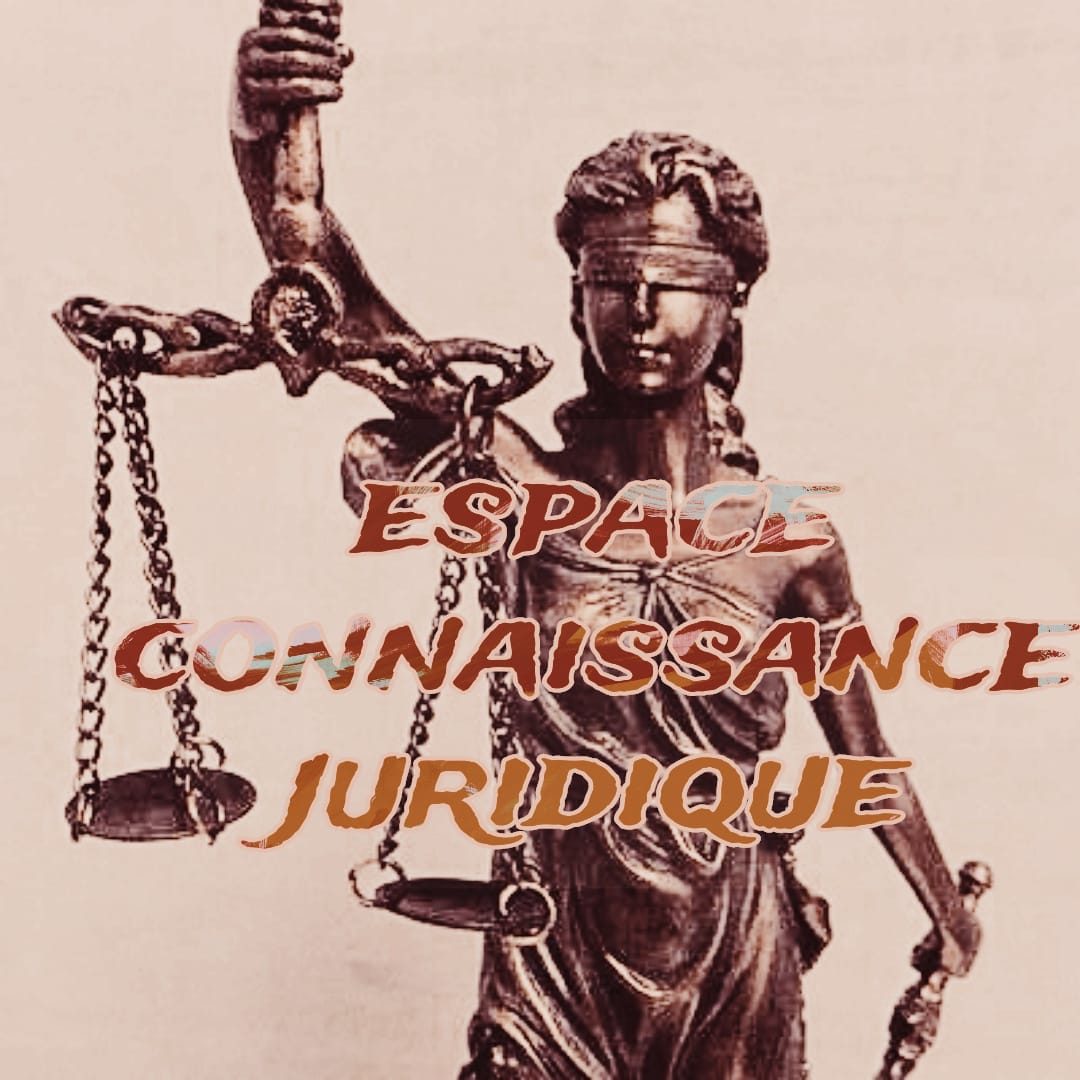قراءة أولية
محمد القدوري
محام بهيئة المحامين بالرباط
تمهيد :
1. ظلت النزاعات القائمة حول الحقوق العينية العقارية تتأرجح بين إخضاعها للقواعد المنظمة في الفقه المالكي الجاري به العمل في المغرب ، وبين إخضاعها لقانون الالتزامات والعقود، ولبعض المبادئ القضائية التي قررتها محاكم المملكة ، محط نقاش ، منذ صدور قانون الالتزامات والعقود المغربي ، وكان النقاش المذكور يشتد عندما يتعلق الأمر بعقار في طور التحفيظ ، إلى أن وضع حد للجدل المذكور بمقتضى المادة الأولى من القانون 39.08 المأمور بتنفيذه بالظهير الشريف رقم1.11.178 الصادر في 25 حجة 1432 الموافق 22نونبر 2011 التي نصت في فقرتها الأولى عل أن “تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ، ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار” ونصت في فقرتها على أن “تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331) (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون ، فإن لم يوجد نص، يرجع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي “. وهكذا وضعت هذه المادة حدا للجدل الذي كان قائما حول النصوص التي تخضع لها النزاعات المتعلقة بالعقار، بأن أصبحت النصوص الواجب الإعمال بشأن النزاعات المذكورة هي:
نصوص مدونة الحقوق العينية ، ثم نصوص قانون الالتزامات والعقود، ثم المبادئ والقواعد المقررة في الراجح، والمشهور، وما جرى به العمل في مذهب الإمام مالك.
2. وقد يكون من شأن عبارات المادة الأولى سالفة الذكر أن تفضي إلى اختلافات ونقاشات حول المراد من ” التشريعات الخاصة بالعقار” ، وهل يشمل ذلك والنصوص الخاصة الموجودة حاليا أو يقتصر على النصوص التيس تصدر بمناسبة تطبيق مدونة الحقوق العينية أو أن التعبير المذكور يعم القوانين الموجودة والتي ستصدر لاحقا، من جهة؛ وكذا حول التفسيرات التي ستعطى لبعض نصوص قانون الالتزامات والعقود المستمدة من مبادئ الفقه المالكي – وما أكثرها – بغرض تفسير الترجمة غير الدقيقة أو الغامضة والاقتباسات المقتضبة تارة وغير الدقيقة تارة أخرى من لبعض قواعد الفقه المالكي التي اعتمدها واضعوا قانون الالتزامات والعقود؛ الأمر الذي يدعو إلى ضرورة الاستعانة بمبادئ الفقه المالكي في أصولها الصحيحة ، من أجل تفسير نصوص قانون الالتزامات والعقود وفهم نصوص الفقه . وهو الأمر الذي ينعقد الأمل معه على المشتغلين في حقل القانون – من أساتذة ، ومحامين ومحافظين على الأملاك العقارية وقضاة – في أن يبذلوا من الجهد المناسب والتأمل العميق للنهوض بفقه العقار وتطويره بما يلائم مصلحة الأفراد والمجتمع ، في ظل قواعد واضحة ومنصفة ، بما من شأنه أن يشكل انطلاقة صحية وسليمة وفعالة في الطريق الصحيح لفهم وتطبيق وتأويل نصوص مدونة الحقوق العينية.
3. ومن الأسئلة التي يطرحها دخول مدونة الحقوق العينية حيز التنفيذ التساؤل حول ما إن كانت النصوص التي وضعت لتطبيق قانون 95/06/02 الذي نسخته مدونة الحقوق العينية ستبقى نافذة في ظل المدونة المذكورة أولا.
الفقرة الأولى : ملاحظات حول تنظيم الحيازة في مدونة الحقوق العينية:
1. أول وأهم ملاحظة تتعين إثارتها بشأن نصوص مدونة الحقوق العينية بشأن الحيازة أنها تتأرجح بين الأخذ بنظرية ابن رشد، الراجحة لدى الفقهاء، القائمة علي أن الحيازة المستوفية للشروط المقررة هي دليل على الملك وليست سببا فيه، وبين النظرية المقابلة ، المرجوحة ، القائمة علي أن الحيازة المستوفية للشروط المقررة في بابها مكسبة للملك وناقلة له وليست مجرد دالة على الملك.
ويبدوا ذلك جليا من تأمل المادة 3 من المدونة المذكورة ، ومواد الفصل الثالث من الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الثاني المتعلق بأسباب كسبب الملكية ، المخصص للحيازة ، المشتمل من 25 مادة ، هي المواد من 239 إلى المادة 263 ، الموزعة عبر أربعة فروع ، خصص الفرع الأول منها (المواد من 239 إلى 249 ) للأحكام العامة للحيازة ، والثاني (المواد من 250 إلى (259 لمدة الحيازة والثالث (المواد من 260 إلى (262 لآثار الحيازة ، والرابع (المادة (293 إثبات الحيازة وحمايتها.
ذلك أن مدونة الحقوق العينية ، باستثناء المدة 3، أدرجت المواد التي خصصتها لأحكام الحيازة ، ضمن أسباب كسب الملكية ، ومن ذلك يمكن القول إن مدونة الحقوق العينية أخذت بالنظرية القائلة بأن الحيازة من أسباب كسب الملكية ، وذلك ما كرسته المادة 3 من مدونة الحقوق العينية من أنه يترتب على الحيازة المستوفية للشروط القانونية اكتساب الحائز ملكية العقار غير المحفظ أو الحق العيني محل الحيازة ، وما نصت عليه المادة 239 من أن” تقوم الحيازة الاستحقاقية على السيطرة الفعلية على الملك بنية اكتسابه وما نصت عليه 260 من أنه “يترتب على الحيازة المستوفية لشروطها اكتساب الحائز ملكية العقار، وما أشارت إليه المادة261 من أنه “لا تكتسب بالحيازة : أملاك الدولة …” ، وما نصت عليه الفقرة 5 من المادة 243 من أنه “يمكن لفاقد الأهلية أو ناقصها أن يكتسب الحيازة إذا باشرها نائبه الشرعي نيابة عنه ، وما نصت عليه المادة 250 من أنه ” إذا حاز شخص أجنبي غير شريك ملكا حيازة مستوفية لشروطها… فإنه يكتسب بحيازته ملكية العقار” ، وما نصت عليه المادة 253 من الاعتداد ” بنية تملكه “.
والنظرية السابقة، القائلة بأن الحيازة مكسبة للملك، هي نظرية مرجوحة، وأن النظرية الراجحة هي نظرية ابن رشد القائمة عل أن الحيازة إنا هي دليل على الملك، وليست سببا فيه، وأنها مظنة الملك وليست سببا فيه، ولذلك لا يمكن تصنيفها ضمن أسباب كسب الملكية أو انتقالها؛ من أدلة ذلك أن الفقهاء المالكية يبحثونها باب الإثبات ، أو في باب القضاء، وليس في باب أسباب اكتساب الملكية أو انتقالها.
على أنه بوخذ من قول المادة 3 من مدونة الحقوق العينية “إلى أن يثبت العكس “، أنها اعتنقت النظرية القائلة إن الحيازة مجرد دليل علي الملك وليست سببا فيه، وهو ما تؤيده الفقرة الثانية من المادة 239 من المدونة المذكورة الناصة على أن “لا تقوم … الحيازة لغير المغاربة مهما طال أمدها”، وهو ما يزكيه قول المادة 241 من مدونة الحقوق العينية “لا تقوم الحيازة إذا بنيت علي عمل غير مشروع “، وهو نفس المعنى الذي يوخذ من المادة 242 الناصة على أن ” لا يكلف الحائز ببيان وجه مدخله إلا إذا أدلى المدعي بحجة علي دعواه ” ومن المادة 246 القاضية بأن “لا تقوم الحيازة ولا يكون لها أثر إذا ثبت أن أصل مدخل الحائز غير ناقل للملكية “.
ومما سبق يتبين أن مدونة الحقوق العينية أخذت بنظريتين متعارضتين من نظريات الحيازة وعلاقتها بسبب التملك ، وهما : نظرية ابن رشد التي تبعها ابن القاسم ، القائمة على أن الحيازة إنما هي دليل على الملك ، وليست سببا فيه، وهي النظرية الراجحة لدى جمهرة الفقهاء المالكية ؛ في مقابل النظرية المرجوحة القائلة بأن الحيازة سبب من أسباب كسب الملكية، وهو مسلك كان جديرا بمدونة الحقوق العينية أن تتجنبه وأن تعتنق بوضوح النظرية السائدة في الفقه القائمة على أن الحيازة إنما هي قرينة على الملك وليست سببا فيه، وأن الحيازة إنما هي، كما يقول الفقهاء، بمثابة العفاص والوكاء في القطة ، لا تنفع صاحبها متى ثبت أن سبب دخوله إلى العقار المحور غير مشروع .
ومن المناسب هنا، الإشارة إلى أن الفقهاء المعاصرين الذين اهتموا بموضوع الحيازة في الفقه المالكي يفضلون الأخذ نظرية ابن رشد، ويستندون في ذلك بمجموعة من النصوص والآراء، منها:
أ. ما ورد في مدونة الإمام مالك “في الشهادة على الحيازة ” مما “يؤيد الرأي القائل بأن الحيازة وحدها لا تنقل المال المحاز، ولكنها تدل على الملك، أو تعتبر قرينة على ملكية الحائز للمال المحاز، ولكنها. ليست قرينة قاطعة ” ([1]).
ب . ما ورد في شرح الحطاب لقول خليل، في باب الاستحقاق “وإن حاز أجنبي غير شريك ..” من أن “الحيازة لا تنقل الملك ، عن المحوز عنه إلى الحائز باتفاق ، ولكنها تدل على الملك ، كإرخاء الستور، ومعرفة العفاص والوكاء، وما أشبه ذلك ، فيكون القول معها قول الحائز، مع يمينه ” ([2]).
ج . ما أجمع عليه الفقهاء والموثقون من أن الحيازة لا تفيد الملك إلا بشرط أن يدعي الحائز الملك ، بسبب من أسباب اكتساب أو نقل المكلية ، أو يدعي جهل أصل الملك ويحلف، وأما تمسكه بمجرد الحيازة فلا ينفعه لرد حجة خصمه ([3]).
2. وثاني ملاحظة يمكن مؤاخذتها على مدونة الحقوق العينية أنها أخذت ، في المادتين 253 و 254 بقاعدة تلقيف الحيازة بين الخلف الخاص والخلف العام ، مع أن جانبا مهما من الفقه يفرق في التلفيق بين حيازة السلف وحيازة خلفه العام ، وفيها يضم مدة حياة السلف إلى مدة حيازة السلف ؛ وبين حيازة السلف وحيازة خلفه الخاص ، وفيها لا يقول بضم مدة حيازة المشتري إلى مدة حيازة البائع ؟ وهي قاعدة أخذ بها القانون السوداني صراحة ([4]).
4. وثالث ملاحظة تواخذ علي مدونة الحقوق العينية أنها، أثناء الحديث في المادة 3 علي أسباب الترجيح بين الأدلة قررت “تقديم البينة السابقة علي البينة اللاحقة تاريخا” مع أن القاعدة المتفق عليها فقها المقررة قضاء أن العبرة في الترجيح بالتاريخ إنما هي لطول مدة الحيازة ، وليس لمجرد أخر تاريخ إحدى الحجتين علي تاريخ الأخرى ([5]).
5. ورابع ملاحظة يمكن أن تلاحظ على المدونة المذكورة تتعلق بالارتباط والتكامل القائم بين نصوصها وبين نصوص قانون التحفيظ كما تم تعديله بالقانون 07.14 سالف الذكر، فيما يخص وسائل إثبات الحيازة، وذلك من خلال سن قانون التحفيظ لوسيلة من وسائل إثبات الملكية ، غير التي قننتها المادة 263 من مدونة الحقوق العينية ، وتمت الإشارة إليها عرضا في المادة 3 من نفس المدونة ، وذلك من خلال إحداث الفصل 6.51 من ظهير التحفيظ العقاري ، لوسيلة من وسائل إثبات الملكية هي الشهادة التي تنجزها السلطة المحلية ، وهي وسيلة إثبات قلما تناولها مؤلف من المؤلفات في مجال الحيازة ([6])، ويبدو أن الدافع إلى سنها هو التخفيف على ملاك الأراضي الخاضعة لنظام التحفيظ الجماعي ؛ ومثل الشهادة المذكورة لا يمكن أن تعدل الشهادة العدلية الصحيحة المستوفية للشروط المقررة .
6. هذا، ومن مستحدثات مدونة الحقوق العينية أنها تعرضت لحيازة الأشخاص المعنوية ، في الفقرة الثالثة من المادة 443 وهو موضوع قل من تكلم عنه ممن كتب في مجال الحيازة ([7])، وهذه من حسنات المدونة المذكورة .
الفقرة الثانية: الإحالة على غير مدونه الحقوق العينية:
7. لا بد من التساؤل حول النصوص الواجبة التطبيق بالموازاة مع مدونة الحقوق العينية، بالإضافة إلى القوانين التي نصت المدونة صراحة علي تطبيقها، وهي: قانون الالتزامات والعقود، الذي أصبح يحتل الدرجة الثانية بعد نصوص المدونة ، في تنظيم المنازعات العقارية ؛ علما بأن هنالك مواد تناولها “قانون الالتزامات والعقود” ولم تتكلم عنها مدونة الحقوق العينية ، فأضحى القانون المذكور هو النص المطبق على تلك المنازعات ، في الدرجة الأولى [ومن ضمن ما انفرد قانون الالتزامات والعقود بتنظيمه ، ولم تتناوله مدونة الحقوق العينية : البيوع (الفصول 478 إلى 613)، والمعاوضة (الفصل 619) والوكالة (الفصول 879 إلى943) والاشتراك (الفصول 959 إلى 1083)، والصلح (الفصل 1098 ) ، والرهن الحيازي للعقارات (الفصول 1170 إلى1183)].
8. ونظرا لأن مدونة الحقوق العينية أحالت على الراجح والمشهور وما جرى بع العمل، في مذهب الإمام مالك، فقد بات من اللازم التعريف بالمصطلحات المذكورة، بإيجاز:
أ. فالراجح : هو ما قوي دليله ، وقيل ما كثر قائله ، وعلى هذا القول الأخير يكون الراجخ مرادفا للمشهور؛ لكن المعتمد أن الراجح ما قوي دليله ([8]).
ب. وإما جرى به العمل “: هو ما تقرر العمل به من نصوص الفقه الموسومة بالضعيفة أو الشاذة ، مما يخالف الراجح أو المشهور، وذلك إما لضرورة أو عرف جار أو نحو ذلك ؛ فهو ضرب من الاجتهاد المذهبي ([9]). مع الإشارة إلى أن العمل ينقسم إلى عمل مطلق، وهو الذي يعم العمل به أقطار المغرب (تونس والجزائر والمغرب)، وعمل خاص ، وهو ما يقتصر على قطر واحد مثل العمل الفاسي الذي كان يجري به العمل في الأندلس والمغرب .
ح . وأما المشهور فقد اختلف المتأخرون في معناه، فقيل هو ما كثر قائله ، وقيل هو ما قوي دليله ، وقيل إنه قول ابن القاسم في المدونة ، وعلى القول الأول لابد أن يزيد نقلته عن ثلاثة؛ ويسميه الأصوليون بالمستفيض أيضا؛ وقد ذكر ابن فرحون في كشف النقاب أن “مسائل المذهب تدل على أن المشهور ما قوي دليله ، وأن مالكا رحمه الله كان يراعي من الخلاف ما قوي دليله، لا ما كثر قائله فقد أجاز الصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وأكثرهم على خلافه …، وأجاز أكل الصيد إذا أكل منه الكلب ولم يراع في ذلك خلاف الجمهور” ([10]). وقد نظم الفقيه العلامة أبو الشتاء بن الحسن الغازي المعروف بالصنهاجي في هذا الشأن أبياتا قال فيها:
إن يكن الدليل قد تقوى فراجح عندهم يسمى
والقول إن كثر من يقول به يسمى بمشهور لديهم فانتبه
عملنا هو الذي به حكم قضاة الاقتداء رعيا للحكم
مشهورهم لراجح تعارضا يقدم الراجح وهو المرتضى
وقدم العمل حيث ما جرى علي سواه مطلقا بلا مرا
هذا، وإن مجال القواعد والمبادئ المقررة في مجال الراجح والمشهور وما جرى به العمل من فقه الإمام مالك مجال واسع، يمكن الرجوع بشأنه على المؤلفات والمصادر المعتمدة في المذهب ، التي جرى القضاء على اعتمادها والأخذ بها، ومنها: ” الرسالة” لأبي زيد القيرواني ، و” المعونة ” للقاضي عبد الوهاب ، و”فصول الأحكام ” للباجي، و”جامع الأمهات ” لابن الحاجب ، و”عقد الجواهر الثمينة ” لابن شاس ، و” القوانين الفقهية ” لابن جزي، و”المختصر” للشيخ خليل ، و”التحفة” لابن عاصم ، و”لامية الزقاق “لعلي بن قاسم التجيبي.
4. أما النصوص الخاصة التي يجب الرجوع إليها، إلى جانب مدونة الحقوق العينية، في مجال المنازعات العقارية فهي متعددة ، ويندرج ضمنها ما يتصل بموضوع الحيازة في: ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 12 غشت 1913، كما وقع تتميمه وتغييره بالقانون 11.84 المامور بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.11.181 الصادر في 25 حجة 1432 )2011/11/22) المنشور بالتزامن مع مدونة الحقوق العينية ، وقانون المسطرة المدنية ،ومدونة الأوقاف ، والقوانين المتعلقة بأملاك الدولة ، والجماعات ، والنصوص المتعلقة بالتعمير، وبالاستثمار الفلاحي ، وبنزع الملكية من أجل المنفعة العامة ، والنصوص الخاصة الأخرى.
[1]تنظر مدونة الإمام مالك : الجزء الثالث عشر، ص . 41 و 42.
[2]ينظر شرح الحطاب على خليل : في باب الاستحقاق .
[3]تنظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الجزء الرابع ، ص . 207.
[4]المرجع السابق ، ص . 57 وما بعدها.
[5]المرجع السابق ، ص . 58 و 86.
[6]المرجع السابق ، ص . 77.
[7]ينظر محمد القدوري : حيازة العقار كدليل على الملك وسبب فيه ، الطبعة الثانية 2009، ص . 128، رقم 8 .
[8]ينظر محمد القدوري ، معجم المصطلحات الفقهية.
[9]نفس المرجع ؛ وينظر : الحجوي ، الفكر السامي ، الجزء الثاني.
[10]ينظر كسف النقاب الحاجب : ص . 62، 63، وأصول الفتوى : ص .474 و 489.