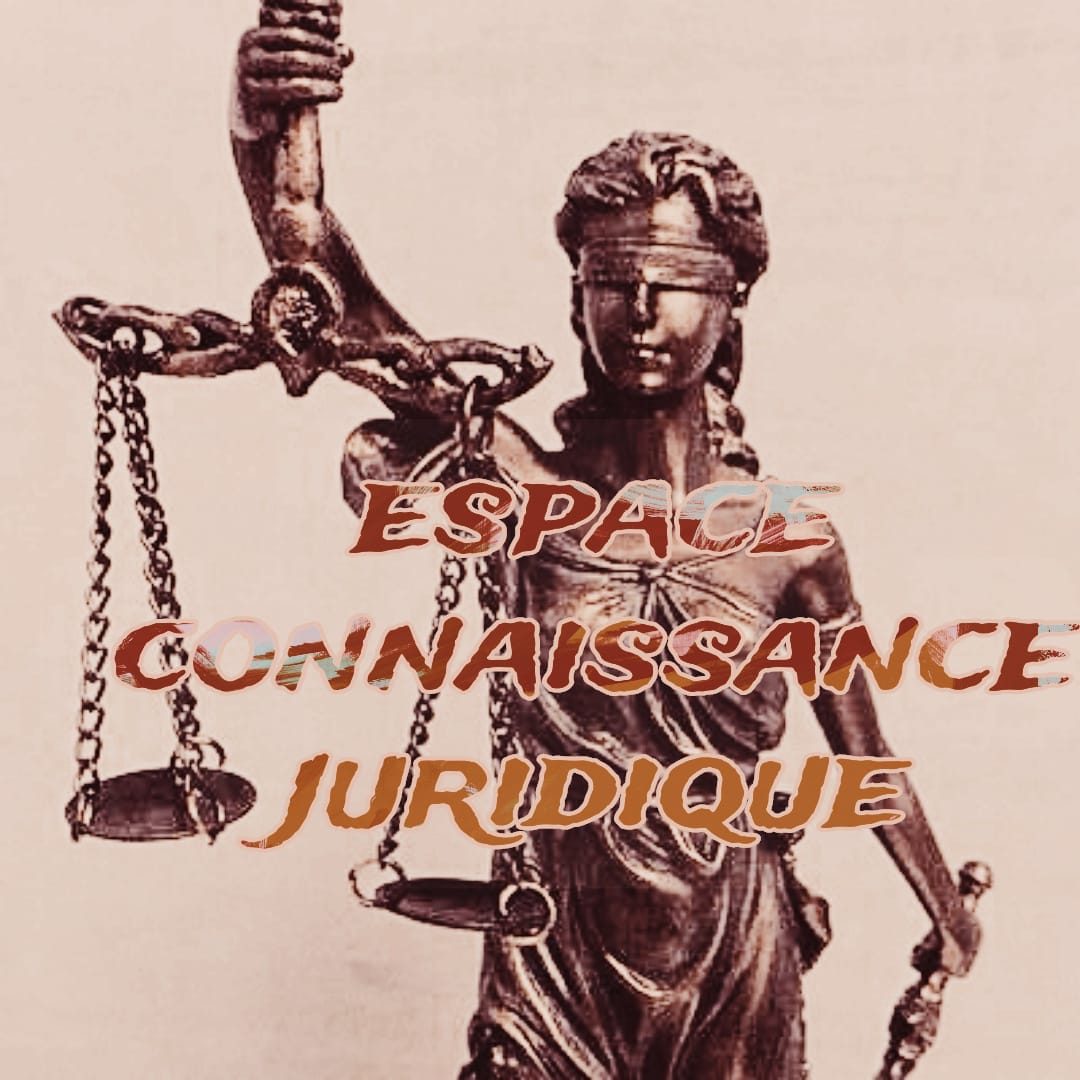ذ. عبد المهيمن حمزة
باحث في سلك الدكتوراه- القانون الخاص
أستاذ زائر بكلية الحقوق-طنجة
تكاد تتفق كل الفعاليات الحقوقية التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمؤسسة القضاء على أن إشكالية البطء في تصفية القضايا أمام المحاكم المغربية ترجع أسبابها أساسا إلى إشكالات التبليغ.
والتبليغ هو الشكل الذي تتم بواسطته إعلام الشخص بالإجراء المتخذ ضده أو لفائدته، فهو بذلك وسيلة قانونية تهدف إلى الإشعار بالموضوع الذي تعلق به التبليغ، وأساس فكرة التبليغ هو مبدأ المواجهة الذي يقوم على عدم جواز اتخاذ أي إجراء ضد شخص دون تمكينه من العلم به، وإعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه، فهذا المبدأ يعد نتيجة أساسية لحق الدفاع.
وعليه؛ فإن ضمان حق الدفاع، ومبدإ المواجهة يقتضيان التبليغ إلى كافة المدعى عليهم حالة تعددهم، وذلك حتى يرتب آثاره القانونية تجاههم من سير لإجراءات الدعوى، وسريان لآجال الطعن وصيرورة الأحكام نهائية وقابلة للتنفيذ، وليس الاكتفاء بالتبليغ إلى أحدهم دون البقية عملا بقاعدة: “الأثر النسبي للتبليغ”. إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة، بل ترد عليها استثناءات يمكن من خلالها التبليغ إلى بعض المدعى عليهم فقط، وهي إما استثناءات قانونية نص عليها المشرع، أو قضائية مصدرها الاجتهاد القضائي، الشيء الذي ينعكس على آثار التبليغ سواء من الناحية الموضوعية، أو من الناحية الإجرائية .
وتكمن أهمية دراسة موضوع التبليغ وتعدد المدعى عليهم في المكانة التي تحتلها مسطرة التبليغ القضائي، والتي تعتبر جسر التواصل في الدعوى القضائية، ومحطة الانطلاق والنهاية بين مختلف الفاعلين في الإجراءات القضائية، والعمود الفقري للدعوى، مما يجعلها القاطرة الوحيدة لتبليغ الإجراءات وإعداد وتهيئ الملفات حتى البت فيها وإصدار الأحكام والقرارات، ثم تبليغها وحفظها نهائيا أو توجيهها إلى الجهة القضائية المختصة للبت فيها بعد الطعن، وأخيرا الوصول إلى المرحلة الأهم، وهي التنفيذ والتي لا يمكن أن تتم إلا بناء على سلامة إجراءات مسطرة التبليغ، من هنا تثار إشكالية التبليغ عند تعدد المدعى عليهم، وما يرتبط بها من ضرورة التوفيق بين مصلحة المدعي من جهة، ومصالح المدعى عليهم وضمان حقهم في الدفاع والمواجهة من جهة أخرى.
ولمعالجة هذه الإشكالية ارتأينا اعتماد الخطة التالية :
المبحث الأول : ضوابط عملية التبليغ عند تعدد المدعى عليهم.
المبحث الثاني : آثار التبليغ عند تعدد المدعى عليهم.
المبحث الأول : ضوابط عملية التبليغ عند تعدد المدعى عليهم.
سنتناول ضوابط التبليغ إلى المدعى عليهم حالة تعددهم، من خلال وقوفنا على القاعدة العامة، وهو وجوب تبليغ كل مدعى عليه على حدة انسجاما مع مبدإ الأثر النسبي للتبليغ (المطلب الأول)، على أن نستعرض أهم الاستثناءات التي يمكن الخروج فيها عن هذه القاعدة؛ وهي إما استثناءات نص عليها المشرع، أو كرستها الممارسة القضائية (المطلب الثاني).
المطلب الأول : يجب أن يوجه التبليغ إلى كل مدعى عليه على حدة كقاعدة عامة.
إن مبدأ احترام حقوق الدفاع، وحق المواجهة يقتضيان ضرورة تبليغ كل أطراف الدعوى أيا كان عددهم، وذلك حتى يرتب التبليغ آثاره تجاههم، فما هو مضمون هذه القاعدة، وما هي الضوابط التي ينبغي مراعاتها لإعمالها.
الفقرة الأولى : مضمون القاعدة.
نظرا لأهمية التبليغ في سير إجراءات الدعوى، وسريان آجال الطعن وصيرورة الأحكام نهائية وقابلة للتنفيذ، فإن العمل القضائي أقر مبدأ هاما يدعى “الأثر النسبي للتبليغ”، ومعناه أن التبليغ يقتصر أثره على المبلغ إليهم فقط دون غيرهم، حيث يستحيل تبليغ طرف وتحميل طرف آخر آثار هذا التبليغ([1]).
وعليه؛ فإنه في حالة تعدد المدعى عليهم فإن التبليغ يجب أن يوجه إلى كل مدعى عليه على حدة، وذلك حتى يرتب آثاره تجاههم، فتبليغ حكم مثلا إلى مدعى عليه دون الآخر يجعل أجل الطعن ساريا في حق المبلغ إليه دون المدعى عليهم الآخرين، ونفس الشيء يقال بالنسبة لتبليغ الاستدعاء أو توجيه الإنذار أو تبليغ الحكم قصد التنفيذ ([2]).
وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي حيث جاء في قرار “إن المبدأ المعمول به هو مبدأ الأثر النسبي للتبليغ، وهكذا إذا بلغ الحكم إلى كل الأطراف ابتداء من التاريخ الذي بلغ إليه الحكم، وأن انقضاء الأجل يؤدي بالنسبة لكل واحد منهم إلى سقوط حقه في الاستئناف رغم أن أجل الاستئناف بالنسبة للأطراف الأخرى لم ينقض بعد” ([3]).
وفي نفس الاتجاه اعتبر المجلس الأعلى أنه ليس لتبليغ القرار للأطراف إلا أثر نسبي، بحيث لا يسري أجل النقض إلا ابتداء من تاريخ توصل كل واحد منهم بالقرار المطعون فيه بالنقض([4])، كما اعتبر قرار صادر عن الغرفة الأولى للمجلس الأعلى أنه “يتعين توصل كل مبلغ إليه بنسخة من الحكم” ([5]).
ورغم عدم وجود نص صريح في التشريع المغربي يؤكد هذا المعنى، فإنه يمكن أن نستنتج ذلك ضمنيا من خلال الفصل 32 من ق.م.م حيث جاء فيه: “…إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم…”. وعليه، فإن إلزام المدعي إرفاق مقاله الافتتاحي للدعوى بعدد من النسخ مساو لعدد المدعى عليهم قرينة على أن التبليغ يجب أن يوجه إليهم جميعا، وقد كرس المشرع المغربي هذا المقتضى في الفقرة الأولى من الفصل 48 من ق.م.م حيث ألزم القاضي بتأجيل القضية إلى جلسة أخرى إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم بنفسه أو بواسطة وكيله، وذلك من أجل أن يأمر من جديد باستدعاء كافة المدعى عليهم طبقا للقواعد المقررة في الفصول 37، 38 و39 من ق.م.م([6]).
وبعدما عرضنا مضمون هذا المبدإ من خلال الاجتهاد القضائي، يجدر بنا أن نتساءل عن الضوابط التي تحكم التبليغ إلى المدعى عليهم حالة تعددهم.
الفقرة الثانية: الضوابط القضائية الواجب مراعاتها عند التبليغ حالة تعدد المدعى عليهم.
حتى يتم التبليغ إلى المدعى عليهم عند تعددهم على نحو صحيح ويرتب آثاره القانونية عليهم، ينبغي مراعاة مجموعة من الضوابط التي كرسها الاجتهاد القضائي.
أولا : المعتبر في تبليغ المدعى عليهم هو الإعلام وليس العلم.
من خلال قراءتنا للفصول 37، 38، 39 و54 من ق.م.م، يتضح لنا أن المشرع أخذ بمعيار الإعلام، لترتيب التبليغ آثاره على المبلغ إليهم، وهذا المقتضى أكد عليه المجلس الأعلى، حيث اعتبر أن العلم بالحكم دون سلوك مسطرة التبليغ القانونية لا يرتب عنه سريان أجل الطعن، إذ لابد من الإعلام بالحكم)[7](.
وفي نفس السياق قضى المجلس الأعلى بـ “تقضي القواعد العامة للمرافعات بأن يتم تبليغ الحكم بأكمله بأسبابه ومنطوقه، ولا يعتبر سبق علم المحكوم عليه بطريقة أو بأخرى، ولو كانت قطعية”)[8](.
ثانيا : لا يعتد بتبليغ المدعى عليهم بواسطة الغير خارج إطار الفصل 38 من ق.م.م.
إذا تم تبليغ المدعى عليهم عبر من لهم الصفة في التسلم نيابة عنهم، فإن ذلك ينبغي أن يتم في إطار ضوابط الفصل 38 من ق.م.م الذي جاء فيه: “يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه، أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه، أو لأي شخص آخر يسكن معه”.
وعليه، إذا تعدد المدعى عليهم، فإنه يجب التبليغ إليهم جميعا مع احترام ضوابط الفصل 38 من ق.م.م، حيث قضى المجلس الأعلى بـ: “أن تبليغ مبلغ إليهما بموطن واحد لا يقيم فيه إلا أحدهما، يعتبر معه التبليغ تم إلى مجهول”([9]). فهذا القرار يؤكد أنه مهما تعدد المدعى عليهم فإنه يجب التبليغ إليهم جميعا إما شخصيا، أو إلى من له الصفة في التبليغ، ولا يكفي التبليغ إلى أحدهم إذا كان الآخر يقيم في موطن آخر، وذلك لأن تأويل الفصل 38 من ق.م.م يجب أن يتم بشكل ضيق جدا، وأن الأشخاص الذين يصح لهم تسلم الحكم في الموطن هم الأشخاص الذين يسكنون في نفس البيت مع المبلغ إليه، وأن الجيران لا يعدون من بين هؤلاء الأشخاص ([10]).
ثانيا : تنفيذ الحكم لا يكفي لافتراض تبليغه إلى المدعى عليهم.
إن تنفيذ الحكم لا يكفي لافتراض أن تبليغه وقع بصفة قانونية، إذ لابد من تبليغ المحكوم عليهم بالحكم الابتدائي وفقا لمقتضيات الفصول 37، 38، 39، و54 من ق.م.م، وذلك لتمكينهم من ممارسة الطعن بالاستيناف طبقا لمقتضيات الفصل 134 من القانون نفسه قبل سلوك مسطرة التنفيذ([11])، وهذا ما أكد عليه المجلس الأعلى حيث قضى بأن “تنفيذ الحكم لا يدل على تبليغه بصفة قانونية”([12]).
وبعدما عرضنا لضوابط المبدإ الذي يقضي بضرورة التبليغ إلى كافة المدعى عليهم وفقا لقاعدة الأثر النسبي للتبليغ، سننتقل في المطلب الموالي إلى الحالات الاستثنائية التي يكفي فيها تبليغ بعض المدعى عليهم.
المطلب الثاني : الحالات الاستثنائية التي يكفي فيها تبليغ بعض المدعى عليهم
بالرجوع إلى بعض النصوص القانونية، وبعض الاجتهادات القضائية، نجد أن قاعدة الأثر النسبي للتبليغ التي مفادها ضرورة التبليغ إلى كافة المدعى عليهم حتى يرتب التبليغ آثاره القانونية ليست مطلقة، بل ترد عليها استثناءات بعضها قانوني نص عليها المشرع (الفقرة الأولى)، وبعضها الآخر قضائي مصدرها الاجتهاد القضائي (الفقرة الثانية)، وهي استثناءات سنوردها على سبيل المثال لا الحصر.
الفقرة الأولى : الاستثناءات التشريعية.
من بين الاستثناءات التي نص عليها المشرع نذكر الحالات التالية على سبيل المثال :
1– حالة إذا كان المدعى عليهم ورثة:
نظم المشرع المغربي موضوع تبليغ الورثة بصفة عامة في الفصول 115، 137 و443 من ق.م.م، ومن خلال قراءتنا لهذين الأخيرين يمكن أن نستشف أحكاما هامة حول تبليغ الورثة باعتبارهم مدعى عليهم.
فالفصل 137 من ق.م.م أجاز استدعاء الورثة جماعيا دون التنصيص على أسمائهم، وهذا يعني إمكانية التبليغ إلى أحدهم فقط مادام أن الاستدعاء جماعي، ولا يشترط فيه تعيين أسمائهم([13]). أما الفصل 443 من ق.م.م فقد ألزم العون المكلف بالتنفيذ بتبليغ الحكم إلى الورثة المعروفين ليس إلا، مما يعني أن التبليغ هنا إلى بعض الورثة المدعى عليهم دون البقية كاف لكي ينتج آثاره القانونية([14])، وقد كان المشرع حكيما بإقراره لهذه الأحكام لأن القول بضرورة تبليغ الورثة المدعى عليهم كل واحد باسمه وفي موطنه يعتبر بمثابة تعجيز للمدعي في رفع دعاويه ضدهم واقتضاء حقه منهم.
ولقد تبنى المجلس الأعلى هذا الموقف، وأكد عليه في أكثر من مناسبة، حيث اعتبر أن الإنذار الموجه إلى ورثة المكتري بالإفراغ، ولو دون بيان أسمائهم يعتبر صحيحا إذا تسلمه أحدهم([15])، وجاء في قرار آخر حديث نسبيا:”… إذا تعلق الأمر بورثة المكتري، فإن المكري موجه الإنذار يمكنه توجيه الإنذار في اسم الورثة في حالة جهله لهويتهم، ويعتبر الإنذار مبلغا تبليغا قانونيا إذا تسلمه واحد منهم، وينتج آثاره بالنسبة لهم”([16]).
وقد انتقد بعض الفقه هذا التوجه معتبرا أنه يراعي مصلحة المدعي على حساب الورثة، فالأجدر بالمجلس الأعلى أن يتخذ موقفا آخر يوفق فيه بين مصلحة الطرفين معا، وأن يبادر إلى تأسيس قواعد قضائية تحد من تلاعب المدعي وتحايله في هذا المجال من خلال استفادته من الترخيص القضائي المتمثل في إعفائه من البحث على ورثة المكتري، وذلك بإقرار ضمانات قضائية من شأنها الحيلولة دون الإضرار بمصالح ورثة المكتري المدعى عليهم ([17]).
لكن رغم أن المشرع أجاز التبليغ إلى أحد الورثة المدعى عليهم دون البقية في المادة 443 من ق.م.م ، إلا أن المسألة ليست بهذه البساطة، حيث تطرح عدة إشكاليات قانونية وعملية، وذلك لارتباط التبليغ بالتنفيذ، ومن أهم الإشكاليات التي أوردها بعض الفقه([18]) نورد ما يلي :
- تنفيذ القرارات القضائية بإتمام بيع العقار المحفظ بما فيها من تسجيل وتحفيظ، ففي هذه الحالة إذا تم التبليغ إلى أحد الورثة فقط، فإنه لا يمكن تصور عملية التنفيذ إلا في مواجهة جميع الورثة المسجلين في الرسم العقاري، وبالتالي فالأمر يتطلب التبليغ إليهم جميعا.
- صعوبة التنفيذ على الورثة الذين لم يتم تبليغهم بالقرار، خاصة إذا كان من بينهم قاصرين، الأمر الذي يتطلب تدخل قضاء الأسرة، مما يحتم التبليغ إليهم جميعا.
- صعوبة التمييز بين التركة وذمة الورثة الذين قد يتمسك كل واحد منهم بأداء ما نابه من التركة، وبالتالي ضرورة التبليغ إليهم جميعا لأن الالتزام يكون قابلا للتجزئة في هذه الحالة.
- قد يكون لأحد الورثة نزاع معين مع باقي الورثة فيفضل عدم إخبارهم بمسطرة التنفيذ، أو قد يتقاعس عن ذلك مما يؤدي إلى فوات أجل الطعن، وبالتالي فإعمال مبادئ العدالة يقتضي التبليغ إليهم جميعا.
- قد يكون أحد الورثة أو محل إقامته مجهولا فكيف يمكن التنفيذ عليه دون تبليغه، والاكتفاء بتبليغ باقي الورثة.
2– حالة إذا كان المدعى عليهم شركاء على الشياع :
نؤكد أثناء عرضنا لهذه الحالة أنه رغم عدم وجود نص قانوني صريح يقضي بإمكانية التبليغ إلى أحد الشركاء على الشياع دون البقية، فإن هذا الحكم يمكن استنتاجه ضمنيا من بعض النصوص القانونية وبعض القواعد القضائية، وهذا ما سنوضحه من خلال المسوغات التالية :
- إن الشركة على الشياع تقضي بأن المصلحة مشتركة بين الشركاء، وبعدم قابلية محل الملكية المشاعة للتجزئة مادامت حصة كل الشركاء غير مفرزة عن سواها من الحصص، وهذا ما يستخلص من مفهوم الملكية المشاعة حيث عرفها مأمون الكزبري على أنها “ملكية مشتركة بين عدة أشخاص على شيء يكون فيها لكل من الشركاء حصة معلومة القدر في كل جزء من أجزاء الشيء المشترك دون أن تكون هذه الحصة مفروزة عن سواها من الحصص”([19])، ومن المعلوم أن الاجتهاد القضائي استقر على أنه في حالة وجود مصلحة مشتركة بين المدعى عليهم وكان الحكم غير قابل للتجزئة فإنه يمكن التبليغ إلى أحد المدعى عليهم فقط([20]).
- في حالة تحفيظ الشركاء على الشياع عقارا حسب الفقرة الثانية من الفصل 10 من ظهير التحفيظ العقاري، فإن نظير الرسم العقاري يسلم فقط إلى أحد الشركاء الذي هو مكلف بإدارة العقار حسب الفصل 59 من نفس الظهير، وبالتالي يكفي التبليغ إلى هذا الأخير دون بقية الشركاء لترتيب التبليغ آثاره عليهم بخصوص كل ما يتعلق بهذا العقار.
- إن تفسير الفصل 473 من ق.م.م الذي ينص على: “يخطر في حالة الشياع عون التنفيذ، في حدود الإمكان، شركاء المنفذ عليه…” يجعلنا نرى إمكانية الاكتفاء بالتبليغ إلى أحد الشركاء المدعى عليهم دون البقية لاستعمال المشرع عبارة “في حدود الإمكان”، بمعنى أنه إذا تعذر التبليغ إلى أحدهم ولم يكن ذلك ممكنا، فإن التبليغ إلى البقية كاف لترتيب آثاره القانونية على الجميع.
- جاء في حكم ابتدائي “إن بعث الإنذار بالإخلاء عمل من أعمال الإدارة والانتفاع، وبالتالي يكون توجيهه من طرف الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع العقار دون البقية المالكين على الشياع توجيها صحيحا ينتج آثاره القانونية حتى ولو عارض في ذلك بقية الشركاء” ([21]). فرغم أن هذا الحكم يتضمن الشركاء على الشياع باعتبارهم مدعين، فإن إعمال مبدأ التفسير بالمخالفة يجعلنا نسلم بإمكانية التبليغ إلى الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع دون البقية، وذلك لأن التبليغ هو عمل من أعمال الإدارة وليس التصرف، وهذا المقتضى يتماشى مع جوهر الفصل 971 من ق.ل.ع.
الفقرة الثانية: الاستثناءات القضائية.
لقد كرس الاجتهاد القضائي مجموعة من الاستثناءات عن قاعدة الأثر النسبي للتبليغ التي تقضي بضرورة التبليغ إلى كافة المدعى عليهم، ومن بين هذه الاستثناءات نذكر:
1– حالة وجود مصلحة مشتركة بين المدعى عليهم وكان الحكم غير قابل للتجزئة :
نستشف هذه الحالة من خلال قرار للمجلس الأعلى قضى بما يلي: “لا يترتب عن تبليغ الحكم إلى أحد المبلغ إليهما دون الآخر آثاره القانونية المتمثلة في سلوك الطعن في حقهما معا، بشرط أن تكون مصلحتهما مشتركة في الحكم غير القابل للتجزئة”.([22])
فهذا القرار يؤكد إمكانية تبليغ أحد المدعى عليهم دون البقية وذلك بعد توافر شرطين :
- أن تكون المصلحة مشتركة: وذلك لأن المصلحة شرط موضوعي أساسي لقيام الدعوى([23])، فلا دعوى حيث لا مصلحة، وقد جعلها بعض الفقه الشرط الوحيد الذي تستقيم به الدعوى.([24])
- أن يكون موضوع الحكم غير قابل للتجزئة : ويكون موضوع الحكم غير قابل للتجزئة في الحالات التالية :
* إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم بين المحكوم عليهم.
* إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه أطراف الدعوى أنه لا يجوز تنفيذ الالتزام منقسما، أو إذا انصرفت النية إلى ذلك([25]).
وكمثال على المصلحة المشتركة نستحضر التعرض الكلي على مطلب التحفيظ الجماعي حيث سمح المشرع في الفصل 16 من ظهير التحفيظ العقاري تقديم مطلب جماعي للتحفيظ عند توافر شروط معينة([26])، والذي يعنينا هو حالة وقوع تعرض على هذه العقارات، وقيام المحافظ برفع المطلب الجماعي للتحفيظ إلى المحكمة المختصة، فالمتعرض في هذه الحالة يأخذ مركز المدعي كوضع قانوني ناتج عن تعرضه([27])، ويقع عليه عبء الإثبات، وهذا ما أكد عليه المجلس الأعلى([28]). وبالمقابل تكون لطالبي التحفيظ صفة مدعى عليهم، ففي هذه الحالة يكون التبليغ صحيحا منتجا لآثاره إذا تم لأحد طالبي التحفيظ نظرا لوجود المصلحة المشتركة بينهم متى انصب التعرض على العقارات موضوع التحفيظ كلها.
2– حالة المدعى عليهم المتضامنين في الدين:
إذا كان المدعى عليهم متضامنين في الدين موضوع الدعوى فإن التبليغ إلى أحدهم كاف لترتيب التبليغ آثاره القانونية من سريان آجال الطعن، وقابلية الحكم للتنفيذ، وذلك لأن مناط التضامن هو التزام المدينين المتعددين بأداء الدين كله في مواجهة الدائن([29])، بحيث يمكنه إما متابعتهم جميعا، أو متابعة أحدهم على أن يحق له الرجوع على باقي المدينين، والتضامن لا يفترض، إذ لابد لإعمال قواعده من اتفاق أو نص القانون، وذلك طبقا للفصل 164 من ق.ل.ع([30]).
أما في الميدان التجاري([31])؛ فإن المشرع اعتبر التجار المدينين بالتزام تجاري متضامنين في ذلك الالتزام طبقا للمادة 335 من مدونة التجارة، إلا أن مبدأ التضامن هذا ليس من النظام العام، لذلك يمكن الاتفاق على عدم إعماله فيما بين المتعاقدين، كما أنه لا يجري العمل به إلا إذا نص القانون على ذلك([32])، مثل المقتضى الذي جاءت به المادة 155 من نفس المدونة([33]). وبما أن متابعة أحد المتضامنين يكفي لاسترجاع الدين، فإن التبليغ إلى أحدهم كاف لترتيب آثاره القانونية تجاه المدعى عليهم المتضامنين، وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية في حكم بتاريخ 20/06/1945 جاء فيه : “إن آثار تبليغ الأحكام بين الخصوم لا تكون إلا بين من بلغ الحكم ومن بلغ إليه سواء تعدد المحكوم عليهم أو المحكوم عليهم، وذلك فيما عدا حالة عدم القابلية التجزئة أو حالة التضامن”([34]).
المبحث الثاني: آثار التبليغ عند تعدد المدعى عليهم.
بعدما حددنا ضوابط التبليغ في حالة تعدد المدعى عليهم والمبادئ القضائية التي تحكمه سنتطرق في هذا المبحث إلى الآثار القانونية المترتبة عن هذا التبليغ (المطلب الأول)، ثم إجراءات الطعن فيه إذا كان التبليغ مخالفا للضوابط التي سبق وأن ذكرناها أعلاه (المطلب الثاني).
المطلب الأول : الآثار الموضوعية للتبليغ في حالة تعدد المدعى عليهم.
سنقسم هذه الآثار إلى آثار إيجابية، ونقصد بها الآثار المترتبة عن التبليغ في حالة تعدد المدعى عليهم والذي يراعى فيه الشروط والضوابط القانونية (الفقرة الأولى)، وآثار سلبية وهي المترتبة عن التبليغ الذي وقع فيه إخلال بتلك الضوابط (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : الآثار الإيجابية.
إن التبليغ إلى المدعى عليهم المتعددين، والذي روعي فيه الضوابط القانونية الموضوعية والإجرائية يترتب عنه أثرين أساسيين هما :
- تحديد الوصف القانوني للحكم :
يعتبر التبليغ المرجع الوحيد لتحديد الوصف القانوني للأحكام، فهذه الأخيرة قد توصف حضورية أو غيابية أو بمثابة حضورية على ضوء نتيجة التبليغ، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 47 من ق.م.م([35]).
فالحكم الحضوري هو الذي يحضر فيه الخصوم جلسات الدعوى سواء بأنفسهم أو بوكلاء عنهم إذا كانت المسطرة شفوية، وبتقديم مستنتجاتهم الخطية في الدعوى إذا كانت المسطرة كتابية، وذلك بعد سلوك المسطرة القانونية للتبليغ، وأما الحكم الغيابي فهو الذي يغيب فيه الخصوم إما بأنفسهم في حالة المسطرة الشفوية، أو بمستنتجاتهم في حالة المسطرة الكتابية بعد سلوك مسطرة التبليغ القانونية([36]).
لكن يبدو دور التبليغ في تحديد الوصف القانوني للحكم أكثر وضوحا في حالة الحكم بمثابة حضوري الذي لا يأخذ هذه الصفة إلا إذا توصل المدعى عليه بالاستدعاء بنفسه ولم يحضر وكان الحكم قابلا للاستئناف، وهذا ما أكده المجلس الأعلى حيث قضى بـ “إن الطاعنة لم تعلم بالتاريخ الذي حدد للنطق بالحكم، وهو ما يجعل الحكم بمثابة حضوري يسري أجل استئنافه من اليوم الموالي ليوم التبليغ”.([37])
وفي حالة تعدد المدعى عليهم، فإن الحكم قد يكون حضوريا بالنسبة للبعض، وغيابيا أو بمثابة حضوري بالنسبة للبعض الآخر، تبعا لمبدإ الأثر النسبي للتبليغ، ما لم يكن المدعى عليهم يصنفون ضمن خانة الاستثناءات، ففي هذه الحالة يكون للحكم صفة واحدة.
2- سريان آجال الطعن:
يعتبر التبليغ نقطة انطلاق آجال الطعن، إذ للطعن في الأحكام والقرارات آجال حددها القانون لا يبدأ سريانها إلا من تاريخ التبليغ، وهذا ما أكده المجلس الأعلى حيث قضى بـ “إذا ثبت تبليغ القرار من الخصم فإن مواعيد الطعن تبدأ بالنسبة للمبلغ والمبلغ إليه من تاريخ التبليغ”([38]). غير أنه لهذه القاعدة بعض الاستثناءات تتجلى في :
- طلب تقديم المساعدة القضائية من المجلس الأعلى، حيث نص الفصل 358 من ق.م.م على أن أجل الطعن يوقف ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية بالمجلس الأعلى، ويسري هذا الأجل من جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية لوكيل المعين تلقائيا، ومن يوم تبليغ قرار الرفض عند اتخاذه.
- تغيير أهلية أحد الأطراف: حيث ينص الفصل 139 من ق.م.م على أنه إذا وقع أثناء أجل الاستئناف تغيير في أهلية أحد الأطراف أوقف الأجل، ولا يبتدئ سريانه إلا من جديد إلا بعد 10 أيام من تاريخ تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسليم هذا التبليغ.
- وفاة أحد الأطراف: ينص الفصل 137 من ق.م.م على أن وفاة أحد الأطراف توقف أجل الاستئناف لصالح الورثة، ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور أجل 10 أيام من تاريخ تبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق المشار إليها في الفصل 54 من القانون نفسه.
- التبليغ الباطل: إن قرار التبليغ الباطل في أوامر الأمر بالأداء يوقف سريان آجال الطعن، كما أن توصل المحامي بنسخة من الحكم وفق طلبه لا يعتبر تبليغا قانونيا، و تبليغ الحكم بواسطة محامي الطرف الآخر هو تبليغ غير صحيح، ولا يترتب عنه آثار قانونية عملا بمقتضيات الفصل 137 من ق.م.م نفسها.
وفي حالة تعدد المدعى عليهم، ولم تكن لهم مصلحة مشتركة ولم يكن الحكم قابلا للتجزئة وتم تبليغ الحكم إلى كل الأطراف لكن في تواريخ مختلفة، فإن الأجل يسري بالنسبة لكل واحد منهم إلى حين سقوط حقه في الاستئناف، رغم أن أجل الاستئناف بالنسبة للأطراف الأخرى لم ينقض([39]).
الفقرة الثانية : الآثار السلبية.
تترتب عن عدم احترام ضوابط التبليغ حالة تعدد المدعى عليهم مجموعة من الآثار السلبية والمشاكل العملية تعيق سير إجراءات الدعوى، نظرا لأن التبليغ يعتبر العمود الفقري للمسطرة، إذ يصاحب كل إجراءات الدعوى من البداية إلى النهاية مما يعني أن مشاكل التبليغ تنعكس على إجراءات المسطرة في جميع مستوياتها وخلال كل المراحل التي تقطعها الدعوى([40])، وسوف نتطرق لأهم الآثار السلبية في النقطتين التاليتين :
1-عرقلة إجراءات سير المسطرة :
وذلك إما لأن التبليغ لم يتم لأي من المدعى عليهم، أو أنه لم يحترم الآجال القانونية، مما يؤدي إلى تأخير الملفات من جلسة إلى أخرى، وينتج عنه عدم تصفية الملفات، وتراكم القضايا بمكاتب القضاة، ويتأكد هذا في الحالة التي يكون الحكم غير قابل للتجزئة بين المدعى عليهم، كما لو كان محل النزاع عقارا يملكه شركاء على الشياع مثلا، مما يؤدي إلى لجوء المدعى عليهم خاصة إذا صدر الحكم عليهم في غيبتهم دون أن يكون بالملف ما يفيد توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية إلى تقديم طعون جانبية في التبليغ لطلب بطلانه، وهكذا تضاف مساطر أخرى إلى الملف الأصلي([41]).
2-عدم صيرورة الأحكام نهائية أو قابلة للتنفيذ :
وذلك اعتبارا لكون آجال الطعن لا تبتدئ بالسريان إلا من تاريخ التبليغ، وليس بأي إجراء آخر، والمقصود من ذلك هو التبليغ الذي يتم بصفة قانونية وتراعى فيه الضوابط الشكلية والموضوعية، والمسألة تزداد تعقيدا في حالة تعدد المدعى عليهم حيث يصعب تنفيذ القرارات القضائية في حقهم دون التبليغ إليهم جميعا، فرغم أن النص القانوني يسمح بجواز التبليغ إلى أحدهم فقط، مثل التبليغ إلى أحد الورثة وفقا للفصلين 137 و443 من ق.م.م، فإن تنفيذ القرارات المتعلقة بإتمام بيع عقار محفظ لا يمكن تصورها إلا في مواجهة جميع الورثة المسجلين برسم المحافظة العقارية، الأمر الذي يتطلب التبليغ إليهم جميعا([42]).
وعليه، فإن تنفيذ الحكم تربطه علاقة وطيدة بالتبليغ، فهي علاقة السبب بالنتيجة، فتنفيذ الحكم رهين بصحة التبليغات، وهو ما أكد عليه القضاء المغربي في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش جاء فيه : “حيث إن تنفيذ الحكم الابتدائي قبل أن تقول محكمة الاستيناف كلمتها في موضوع المنازعة المتعلق بالتبليغ سيلحق ضررا بحقوق العارض، وهذه صعوبة جدية”([43]). وهذا ما ينسجم مع ما سبق أن قضى به المجلس الأعلى في قرار جاء فيه: “إن تنفيذ الحكم لا يدل على تبليغه بصفة قانونية”([44]).
المطلب الثاني : إجراءات الطعن في صحة التبليغ حالة تعدد المدعى عليهم
إن تبليغ الاستدعاء أو الحكم أو القرار القضائي إلى المبلغ إليهم بشكل غير قانوني يجعل هذا التبليغ باطلا إما بطلانا يتعلق بالنظام العام يمكن للمحكمة أن تقتضي به بصفة تلقائية، أو بطلانا يتعلق بمصلحة الخصوم حيث يتعين إثارته لدى المحكمة (الفقرة الأولى)، وفي الحالة الأخيرة يطرح إشكال حول طرق الطعن الممكنة لإقرار بطلان التبليغ (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : بطلان إجراءات التبليغ حالة تعدد المدعى عليهم.
ينبغي أن نميز في هذه المسألة بين البطلان المتعلق بالنظام العام، والبطلان المتعلق بمصلحة الخصوم :
1–البطلان المتعلق بالنظام العام :
البطلان هو “الجزاء الذي يلحق إجراء مخالفا للقانون، ويؤدي إلى عدم ترتيب الآثار القانونية عنه بسبب ما شاب الإجراء من عيب”، والتشريعات الحديثة([45]) بدأت تتخلص من الشكلية الإجرائية العقيمة، وذلك بربط البطلان بتحقق الغاية من الإجراء، فإذا تحققت الغاية كان الإجراء صحيحا ولو نص القانون على البطلان ([46]).
وبالرجوع إلى الفصول 37، 38، 39 من ق.م.م نجد مقتضياتها لم ترتب أي جزاء صريح على مخالفة أحكامها، مما يعني أن المشرع المغربي قد ساير التشريعات الحديثة بأخذه بفكرة تحقيق الغاية من الإجراء، وهذا ما يتضح بشكل جلي من خلال مقتضيات الفصل 49 من ق.م.م، والتي تستثني الدفع ببطلان التبليغ من قاعدة وجوب الدفع بالبطلان الإجرائي والإخلالات الشكلية والمسطرة، قبل كل دفع أو دفاع، مما يعني أنه أخذ بالقاعدة القائلة بأن بطلان التبليغ ليس من النظام العام([47]).
لكن إذا كانت هذه هي القاعدة فإن هناك استثناءات يكون فيها هذا الدفع من النظام العام، وذلك في حالة ما إذا كان الوضع الذي ترتب البطلان على مخالفته مقررا أصلا للمصلحة العامة، وكمثال عن ذلك الدفع ببطلان استدعاء الحضور لصدوره عن غير ذي صفة([48]). وكذا صلاحية محكمة الطعن في أن تحكم ببطلان التبليغ بصفة تلقائية بصدد مراقبة آجال الطعن، لأن تلك المراقبة تتعلق بالإجراءات الشكلية الأساسية لقانون المسطرة المدنية، مما يقتضي التأكد من صحة التبليغ باعتباره منطلقا لاحتساب آجال الطعن الذي يعتبر من النظام العام ([49])، وقد كرس القضاء المغربي هذه الاستثناءات حيث قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأن: “عدم تضمين غلاف التبليغ لتاريخ التبليغ، أو عدم توقيعه من قبل المبلغ يجعل التبليغ باطلا، وأن هذه النقطة من النظام العام”([50]).
2–البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم:
ويتحقق هذا البطلان في الحالات التالية :
- البطلان بسبب نقص في البيانات الجوهرية المنصوص عليها في الفصل 36 من ق.م.م، ([51]) بشرط تقديم دفع بذلك قبل الدخول في أي نقاش في الموضوع، وزيادة على ذلك لابد من أن يترتب على النقص ضرر أفقد الإجراء خاصيته ([52]).
- البطلان بسبب الإخلال في تسليم الطي، كأن يسلم الطي إلى من يدعي أنه ذو صفة لكن هذا المتسلم قد يكون له مصلحة في تضليل المدعى عليه فلا يوصل التبليغ إلا في آخر الأجل، أو بعد فوات موعد الجلسة ([53]).
- البطلان بسبب عدم مراعاة الآجال المنصوص عليها في الفصل 40 من ق.م.م، وفي الفصول 511، 512، و513 من القانون نفسه.
الفقرة الثانية : طرق الطعن في صحة التبليغ.
إن الطعن في صحة التبليغ وإجراءاته محصورة في دفع شكلي يتقدم به من له مصلحة أمام المحكمة الابتدائية، أو في مقال استئنافي أمام محكمة الاستئناف، أو أمام المجلس الأعلى.
1–الطعن في التبليغ كدفع يتقدم به من له مصلحة أمام المحكمة الابتدائية:
غالبا ما يتعلق الأمر في هذه الحالة بإجراءات تبليغ الإنذارات والأوامر والأحكام الغيابية، والقرارات كقرار عدم نجاح الصلح ([54])، ويجب أن يقدم الدفع قبل مناقشة الجوهر مع إثبات الضرر، أو كصعوبة في التنفيذ بواسطة مقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية استنادا إلى المنازعة في صحة التبليغ ([55]).
ويلجأ أحيانا الطاعن بالاستئناف قبل ممارسة الطعن أمام محكمة الاستئناف إلى تقديم دعوى مستقلة أمام المحكمة الابتدائية رامية إلى بطلان تبليغ الحكم الابتدائي ملتمسا في الوقت ذاته من محكمة الاستئناف إيقاف البت في الدعوى إلى حين بت المحكمة الابتدائية في دعواه ببطلان التبليغ ([56])، إلا أن الفقه المغربي تصدى لهذه المسألة بالمنع تكريسا لمبدإ تعدد درجات التقاضي، واحتراما لمبدإ حجية الأحكام إذ لا يطعن فيها إلا بالطرق المحددة قانونا، فإذا انقضت آجال الطعن اكتسب قوة الأمر المقضي به، وأصبحت غير قابلة لأي طعن ([57]).
- الطعن في التبليغ أمام محكمة الاستئناف :
يمكن الطعن في صحة التبليغ أمام محكمة الاستئناف في عريضة الطعن، وقبل الكلام في الجوهر، كما يمكنها بعد الاطلاع على ملف التبليغ الموجود بالمحكمة الابتدائية الحكم بطلان التبليغ وقبول الاستئناف ولو قدم خارج الأجل القانوني، على اعتبار أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وأن محكمة الاستئناف هي التي لها صلاحية النظر في صحة أو بطلان تبليغ الاستدعاء أو الإنذار أو الحكم المؤسس عليها لأنها محكمة الأصل ([58]).
- الطعن في التبليغ أمام المجلس الأعلى.
من موجبات النقض حسب الفصل 359 من ق.م.م خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف. وقد حدد الأستاذ محمد الكشبور هذه القواعد في تلك القواعد المسطرية التي ينتج عن تخلفها بطلان الحكم. والقواعد المسطرية المتعلقة بحقوق الدفاع، وذلك بالإضافة إلى القواعد المسطرية التي لا تمس حقوق الدفاع لكنها متصلة بالنظام العام ([59]).
ويعد الطعن بالنقض لعدم صحة التبليغ خرقا للقواعد المسطرية المتعلقة بحقوق الدفاع وحق المواجهة، وهذا ما أكده المجلس الأعلى حيث اعتبر أن عدم استدعاء الأطراف بطريقة قانونية سببا موجبا للنقض ([60]). لكن يشترط أن يثبت الطاعن بالنقض تضرره من خرق القاعدة المسطرية المتعلقة بالتبليغ. إلا أن بعض الفقه يرى بأن هذا الشرط غير لازم، إذ يكفي أن يكون الخرق قد طال قاعدة جوهرية لقيام وقبول الطعن المذكور([61]).
ويقع على طالب النقض بسبب الإخلال بالقواعد المسطرية عبء الإثبات، وفي المقابل يعتمد المجلس الأعلى من أجل تفنيد ادعائه على شهادة التسليم التي تعتبر الوثيقة الأساسية لإثبات التبليغات القضائية في حالة النزاع وليست شهادة كتابة الضبط المبنية على وقائع ملف التبليغ)[62](، وتأتي في الدرجة الثانية شهادات كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين والسلطة الإدارية وإدارة البريد، لأن المشرع المغربي سوى بين هذه الجهات في الفصل 37 من ق.م.م ([63]).
خاتـمة:
من خلال دراستنا لموضوع التبليغ وتعدد المدعى عليهم سواء في الشق المتعلق باستعراض الضوابط التشريعية والقضائية التي تخضع لها مسطرة التبليغ عند تعدد المدعى عليهم، أو في الشق المتعلق بالآثار الموضوعية والإجرائية المترتبة عن هذه المسطرة يمكن استخلاص النتائج التالية:
1. تشتت النصوص القانونية المتعلقة بالتبليغ بصفة عامة، والتبليغ عند تعدد المدعى عليهم بصفة خاصة.
2. غياب نص صريح في التشريع المغربي ينظم أحكام التبليغ عند تعدد المدعى عليهم سواء من حيث المبدإ أو من حيث الاستثناءات، وإنما نستنتج هذه الأحكام ضمنيا من بعض النصوص مثل الفصول 32 و48 من ق.م.م، ومن بعض القواعد التي أقرها الاجتهاد القضائي مثل قاعدة “الأثر النسبي للتبليغ”، بالإضافة إلى بعض النصوص التي تعرضت لبعض الحالات الخاصة من التبليغ إلى المدعى عليهم المتعددين مثل التبليغ إلى الورثة المدعى عليهم في الفصول 115، 137 و443 من ق.م.م ، مما ألقى بعبء تنظيم الإشكالية على القضاء الذي حقق تراكما هاما في الموضوع .
3. إن المشرع المغربي قد جانب الصواب في الفصل 38 من ق.م.م عندما لم يلزم الجهة المكلفة بالتبليغ بالتحقق من وجود الشخص المبلغ إليه بموطنه قبل التبليغ إلى من له الصفة، بل منح الخيار في التبليغ إلى المدعى عليهم شخصيا أو عن طريق من لهم الصفة، وهذا ما يتضح جليا من خلال الصياغة القانونية لهذا الفصل حيث استعملت عبارة “أو” التي تفيد الخيار. وفي هذا يكون قد خالف التشريعات الإجرائية المقارنة كالتشريع الفرنسي والمصري والتونسي والليبي، فكل هذه التشريعات تنص على أن التبليغ الواقع لمن لهم الصفة في التوصل نيابة عن المبلغ إليه بموطنه لا يعتبر صحيحا إلا إذا كان الشخص المبلغ إليه غائبا.
4. إن المشرع لم يوفق بين مصلحة المدعي والورثة المدعى عليهم في الفصلين 137 و443 من ق.م.م، من خلال عدم إلزام التبليغ إليهم جميعا، فرغم إيجابية هذا المقتضى لأن القول بضرورة تبليغ الورثة المدعى عليهم كل واحد باسمه وفي موطنه يعتبر بمثابة تعجيز للمدعي في رفع دعاويه ضدهم واقتضاء حقه منهم، فإن له سلبيات خطيرة تؤدي إلى ضياع حقوق الورثة في مجموعة من الحالات، وعليه نرى أن المشرع كان عليه إيجاد حل مناسب يحفظ مصلحة الطرفين معا، من خلال تأسيس قواعد قضائية تحد من تلاعب المدعي وتحايله في هذا المجال مقابل استفادته من الترخيص القضائي المتمثل في إعفائه من البحث عن الورثة، وذلك بإقرار ضمانات قضائية للحيلولة دون الإضرار بمصالح المدعى عليهم من قبيل هذين الاقتراحين :
– أن يفرض على المدعي ممارسة حقه بحسن نية، بحيث إذا كان يعلم عناوين الورثة المدعى عليهم فلا يعتد بتبليغ أحدهم.
– أن يفترض في الورثة المدعى عليهم وجود مصلحة مشتركة بينهم حتى يثبت العكس، عندها يجب التبليغ إليهم جميعا.
وبالإضافة إلى هذين الاقتراحين وحتى يحقق التبليغ الى المدعى عليهم عند تعددهم أهدافه وغاياته نقترح ما يلي :
– جمع النصوص القانونية المتعلقة بالتبليغ في باب واحد، على غرار العديد من التشريعات المقارنة، وكما هو الشأن بالنسبة للنصوص المتعلقة بالتنفيذ، وتعديل وإتمام المواد القانونية التي تنظم مسطرة التبليغ.
– تنظيم التبليغ عند تعدد المدعى عليهم بنصوص صريحة سواء من حيث المبدإ، أو من حيث الإستثناءات والحالات الخاصة.
– تعديل الفصل 38 من ق.م.م بإلزام الجهة المكلفة بالتبليغ بالتحقق من وجود الشخص المبلغ إليه بموطنه قبل التبليغ إلى من له الصفة، وعدم الإبقاء على منح الخيار في التبليغ إلى المدعى عليهم شخصيا أو عن طريق من لهم الصفة فقط.
– إحداث نظام الغرامة المدنية كجزاء على التحايل أو الغش أو الإهمال في التبليغ على جميع الأطراف المعنية به، وخاصة المدعي الذي يستفيد من الترخيص القضائي الذي نص عليه الفصلان 137 و443 من ق.م.م، والمتمثل في إعفائه من البحث عن الورثة المدعى عليهم، وتحايله في هذا المجال. لذا، نرى ضرورة السعي إلى تعديل هذين الفصلين.
– الرفع من مستوى المكلفين بالتبليغ ماديا ومعنويا وتوفير وسائل العمل لهم، وإحداث نظام لمراقبة عملهم يسند إلى النيابة العامة ومؤسسة قاضي التنفيذ.
[1] محمد بفقير: “مبادئ التبليغ على ضوء قضاء المجلس الأعلى”، مكتبة الرشاد، الطبعة الأولى 1425 هـ، ص 242.
[2] محمد بفقير: م.س، ص 242.
[3] قرار صادر عن قضاء النقض بالمغرب، مدني 2-23 ماي 1957 أورده أدولف رييولط بصدد شرحه للفصل 134 ق.م.م في كتابه قانون المسطرة المدنية في شروح، تعريب إدريس ملين، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، مطبعة المعارف الجديدة 1996، ص 121.
[4] قرار المجلس الأعلى عدد 53 بتاريخ 14 نونبر 1987، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد5، ص 23 وما يليها.
[5] قرار المجلس الأعلى عدد 229 بتاريخ 24 أكتوبر 1972، منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد 125، ص 234 وما يليها.
[6] تنص الفقرة الأولى من الفصل 48 من ق.م.م على أنه: “إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم بنفسه أو بواسطة وكيله أخر القاضي القضية إلى جلسة مقبلة وأمر من جديد باستدعاء الأطراف طبقا للقواعد المقررة في الفصول 37 ،38 و39 للحضور في اليوم المحدد مع تنبيههم في نفس الوقت إلى أنه سيبت حينئذ في القضية بحكم واحد يعتبر بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة”.
[7]قرار المجلس الأعلى عدد 1823 بتاريخ 17/07/1985، صادر عن الغرفة المدنية والاجتماعية، منشور بمجلة الحاكم المغربية، عدد 41، ص 81 وما يليها.
[8] قرار المجلس الأعلى عدد 592 بتاريخ 03/11/1998، منشور بمجلة الدفاع، عدد 3، ص : 149 وما يليها.
[9] قرار المجلس الأعلى عدد 153، بتاريخ 03/02/1987، الملف العقاري عدد 5957/84، منشور بمجلة المعيار، عدد 12، ص : 105 وما يليها.
[10] قرار المجلس الأعلى عدد 128، بتاريخ 15 أبريل 1965، أورده أدولف رييولط، م.س، ص 44.
[11] محمد بفقير : م.س، ص 216.
[12] قرار المجلس الأعلى عدد 419، بتاريخ 12 أبريل 1972، منشور بمجلة القضاء والقانون، عدد 124، ص 163 وما يليها.
[13] تنص الفقرة الثانية من الفصل 137 من ق.م.م على أنه: “يمكن أن يقع هذا التبليغ إلى الورثة وممثليهم القانونيين جماعيا دون تنصيص على أسمائهم وصفاتهم ” .
[14] تنص الفقرة الأولى من الفصل 443 من ق.م.م على أنه: ” إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي بلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم إلى الورثة المعروفين ولو كان بلغ لموروثهم وذلك قصد القيام بالتنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 ، ويتعين إجراء حجز تحفظي على أموال التركة ” .
[15] قرار المجلس الأعلى عدد 833، بتاريخ 14/19/1981، ملف مدني رقم 81752، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 49-50، ص 74 وما يليها.
[16] قرار المجلس الأعلى عدد 1650، بتاريخ 17/11/1999، ملف تجاري 5018/97، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 56، ص 234 .
[17] محمد بفقير : م.س، ص : 180.
[18] بوبكر بهلول : م.س، ص : 58 وما يليها.
[19] مأمون الكزبري: “التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي”، الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية 1987، ص : 115.
[20] قرار المجلس الأعلى بتاريخ 05/12/1979، عدد905، ملف مدني رقم 74252، مجلة رابطة القضاة، عدد 8 و9، ص 84 وما يليها.
[21] حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 16/02/1983، عدد 9757، أورده:
– حسن البكري : “إشكالات قانونية في التبليغ من خلال العمل القضائي”، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 2003، ص 82 وما يليها.
[22] قرار المجلس الأعلى عدد 905، بتاريخ 05/12/1979، مشار إليه سابقا.
[23] راجع تفاصيل ذلك في مؤلف الدكتور عبد الكريم الطالب : “الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية” م.س ، ص 170 وما يليها .
[24] رزق الله الأنطاكي : “أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية”، الطبعة الخامسة، بند 134، ص: 154.
[25] أنور العمروسي: “التضامن والتضامم والكفالة في القانون المدني”، دار الفكر الجامعي، الطبعة 1، الإسكندرية 1999، ص 53.
[26] وتتمثل هذه الشروط في أن تكون الأملاك متجاورة، وأن تقدم طلبات منفردة بكل عقار مع مطلب مشترك، ودفع مصاريف التحفيظ المخفضة.
- يراجع : محمد خيري : “الملكية ونظام التحفيظ العقاري في المغرب”، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الثانية 1990، ص : 159.
[27] الفصل 2/32 من ظهير التحفيظ العقاري.
[28] “المتعرض في قضايا التحفيظ العقاري يعتبر مدعيا يقع عليه عبء الإثبات، وحتى في حالة عدم إنكار طالب التحفيظ ادعاءات المتعرض يتحتم على هذا الأخير أن يدلي تلقائيا بما لديه من حجج ليمكن قضاة الموضوع من ممارسة سلطتهم التقديرية وحق مراقبتهم على تلك الحجج ” قرار المجلس الأعلى صادر بتاريخ 17/04/1981، أورده :
- حميد كمال، ابتسام فهيم : التعرض على مسطرة التحفيظ”، ندوة المنازعات العقارية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، مطبعة الأمينة 2007، ص : 161.
[29] جلال محمد إبراهيم : “الرجوع بين المسؤولين المتعدين”، دراسة مقارنة، منشورات جامعة الكويت، طبعة 1992-1993، ص 54.
[30] ينص الفصل 164 من ق.ل.ع على ما يلي : ” التضامن بين المدينين لا يفترض، ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام أو من القانون، أو أن يكون النتيجة الحتمية للمعاملة”، ويقابل هذا الفصل المادة 279 من القانون المدني المصري، والمادة 226 من القانون المدني الليبي، والمادة 274 من القانون المدني السوري، والمادة 341 من القانون المدني الكويتي، والمادة 436 من قانون المعاملات لدولة الإمارات العربية المتحدة. – يراجع أنور العمروسي : م.س، ص : 11.
[31] للتفصيل أكثر حول التضامن في الميدان التجاري يراجع :
- عز الدين بنستي، دراسات في القانون التجاري المغربي، الجزء الاول، النظرية العامة للتجارة والتجار ، مطبعة النجاخ الجديدة، الطبعة الثانية ، الدار البيضاء 2001 ، ص 98 وما يليها .
- محمد لفروجي : التاجر وقانون التجارة المغربي ، مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة الأولى ، الدار البيضاء 1997 ، ص 362 وما يليها .
[32] فؤاد معلال : “شرح القانون التجاري المغربي الجديد”، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية 2001، ص 13.
[33] تنص المادة 155 من مدونة التجارة على ما يلي :” … يسأل مكري الأصل التجاري على وجه التضامن “مع المسير الحر عن الديون المفترضة من طرفه بمناسبة استغلال الأصل وذلم إلى نشر عقد التسيير الحر وخلال مدة الستة أشهر التي تلي تاريخ النشر .
[34] حكم محكمة النقض المصرية بتاريخ 20/06/1935 طعن رقم 10 ، أورده : سعيد أحمد شعلة : “قضاء النقض في المرافعات”، الجزء الثاني، ص : 365.
[35] حسن البكري : م.س، ص : 2.
[36] عبد اللطيف البغيل: “الشامل في القانون القضائي الخاص”، الجزء الثاني، نظرية الأحكام، مطبعة طوب بريس، الطبعة الأولى، الرباط 2006، ص 35.
[37] قرار المجلس الأعلى بتاريخ 15/07/1993، ملف جنحي رقم 15663، مذكور عند حسن البكري : م.س، ص 175 وما يليها.
[38] قرار المجلس الأعلى عدد 796، بتاريخ 06/06/1985، منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 44، ص 174.
[39] قرار صادر عن قضاء النقض بالمغرب، بتاريخ 23 ماي 1957، يراجع الهامش رقم 3، ص .
[40] باني محمد ولد بركة : “العون القضائي دليل عملي وتطبيقي”، دار السلام للطباعة والنشر، ص : 65.
[41] باني محمد ولد بركة : م.س، ص : 65.
[42] بوبكر بهلول : م.س، ص : 58.
[43] قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش رقم 1230، في الملف عدد 1553/91، أورده حسن بكري: م.س، ص 159.
[44] قرار المجلس الأعلى عدد 419، بتاريخ 12 أبريل 1972، منشور بمجلة القضاء والقانون، عدد 124، ص : 163 وما يليها.
[45] تنص المادة 156 من قانون المرافعات الإيطالي على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا حقق الإجراء الغاية منه. بينما تنص المادة 39 من قانون المرافعات اليمني، إن بطلان الإجراءات أو عدمه متعلق بالنتيجة المطلوبة فإن تحققت النتيجة من الإجراء فلا بطلان، وإن لم تتحقق كان الإجراء باطلا.
[46] عبد الله العبدوني : “مسطرة بطلان إجراءات التبليغ في ضوء العمل القضائي المغربي”، مجلة كتابة الضبط، عدد 4 و5 يناير-أبريل 2000، ص : 19.
[47] محمد بفقير : م.س، ص : 227.
[48] باني محمد ولد بركة : م.س، ص : 54.
[49] عبد الله العبدوني : م.س، ص : 22.
[50] قرار المجلس الأعلى عدد 683، بتاريخ 10/09/85، ملف 85/412، منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 46، ص : 85.
[51] للمزيد من التفصيل يراجع عبد الكريم الطالب : م.س، ص : 180 وما بعدها.
[52] باني محمد ولد بركة : م.س، ص : 54.
[53] باني محمد ولد بركة : م.س، ص : 54.
[54]عبد العالي العضراوي : “التبليغات القضائية بين الصحة والبطلان”، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط 2000، ص : 33.
[55] عبد الله العبدوني : م.س، ص : 22.
[56] محمد بفقير : م.س، ص : 231.
[57] عبد الله العبدوني : م.س، ص : 23.
[58] عبد العالي العضراوي : م.س، ص : 35.
[59] محمد الكشبور : “رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق الدار البيضاء، 1986، مطبعة النجاح الجديدة 2001 ص:335.
[60] قرار المجلس الأعلى بتاريخ 30/03/1978، منشور بمجلة القضاء والقانون، عدد 128، ص 187.
[61] محمد الكشبور : “التمييز بين القاعدة الموضوعية والقاعدة الشكلية”، دراسة في نظام الطعن بالنقض، مقال منشور بكتاب عمل المجلس الأعلى التحولات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بأشغال ندوة المجلس الأعلى بمناسبة ذكراه الأربعين، مطبعة مكتبة الأمنية 1999، ص : 167 وما يليها.
[62] قرار المجلس الأعلى رقم 1556 بتاريخ 25/06/1986، ملف مدني 79475، أورده إدريس ملين : “مجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة المدنية”، الجزء الثاني، ص 425.
[63] عبد الله العبدوني : م.س، ص 12.