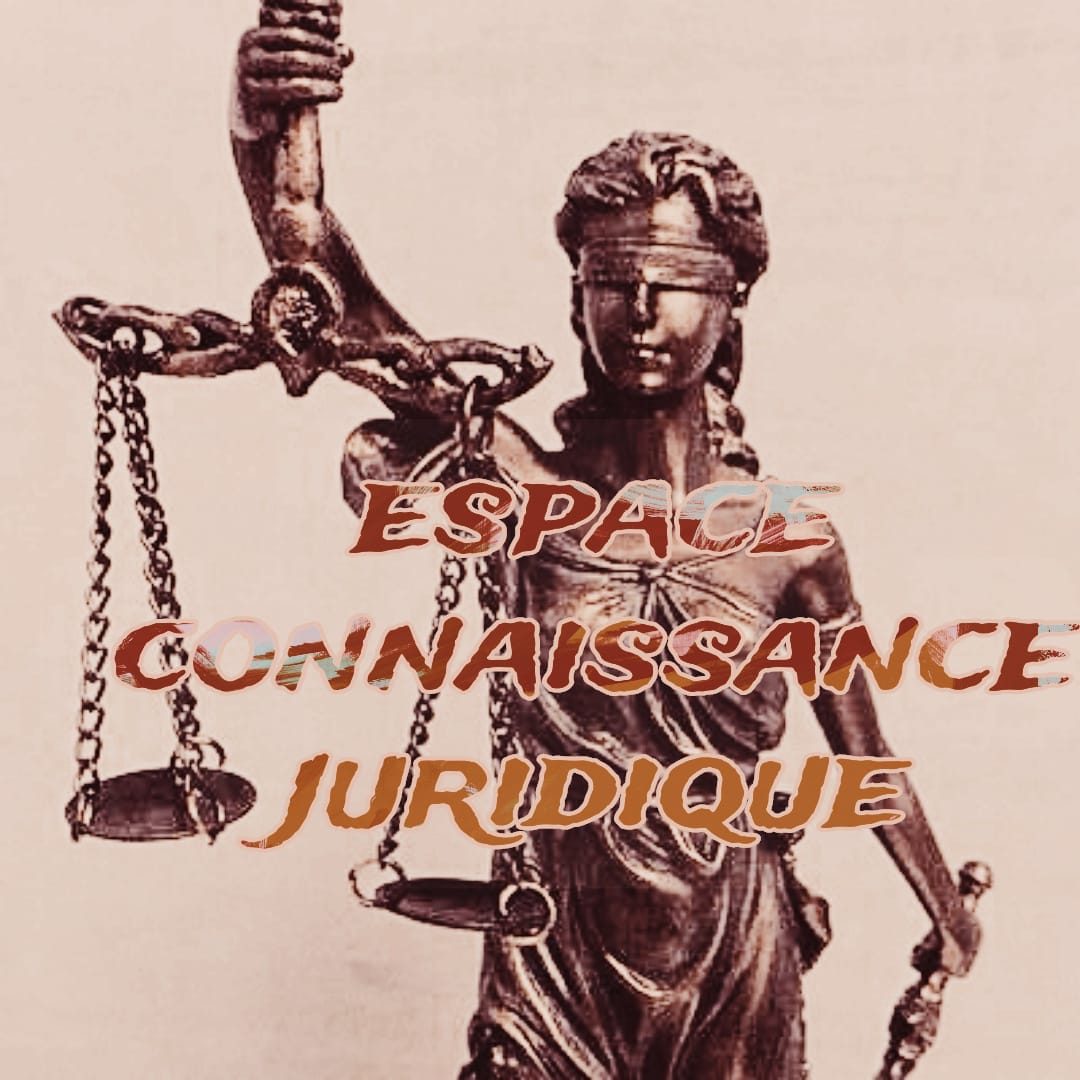Muamar A. O. Nakhlah
Al- Quds University || Palestine
Abstract: This research dealt with the issue of the principle of equivalence in international treaties, and it reviewed the Camp David agreement signed between Israel and the Arab Republic of Egypt in 1979 as a model for those treaties that involve inequality in contractual positions between its two parties, and an imbalance in privileges and obligations.
The researcher aimed through his research to clarify the concept of the principle of equivalence from the perspective of international law and the Vienna Convention, and an analysis of the Camp David agreement signed by the Republic of Egypt with Israel, and to indicate the extent to which the element of inequality in rights and obligations has been achieved between the parties to that treaty Egypt can terminate or amend the Camp David Accords because it is not equitable.
This study used the descriptive analytical approach, and through this approach, the researcher described the unequal treaties in terms of their nature, concept, content, images and mechanisms for their termination. The researcher also analyzed the Camp David Accords as a model for unequal treaties and evaluated them and highlighted the inequalities in them.
At the end of the research, the researcher reached a set of results, the most important of which is the peace treaty between Egypt and Israel that includes many unjust provisions against the Egyptian side, in return for privileges that the Israeli side benefited from.
At the conclusion of his research, the researcher recommended the Arab Republic of Egypt to invoke the theory of changing circumstances regarding the Camp David Agreement; In order to abolish it or amend its provisions in line with the Egyptian security interests.
Keywords: International treaties, Camp David, Egypt, Israel, parity, Convention.
مبدأ التكافؤ في المعاهدات الدولية
(اتفاقية كامب ديفيد بين إسرائيل وجمهورية مصر العربية لعام 1979 أنموذجاً)
معمر علي عرابي نخلة
جامعة القدس || فلسطين
المستخلص: هدف الباحث من خلال بحثه إلى بيان مفهوم مبدأ التكافؤ من منظور القانون الدولي واتفاقية فيينا، وتحليل لاتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها جمهورية مصر مع إسرائيل، وبيان مدى تحقق عنصر عدم التكافؤ في الحقوق والالتزامات بين أطراف تلك المعاهدة، كما هدف البحث لتقديم ومقترحات توضح كيف يمكن لمصر أن تنهي أو تعدل اتفاقية كامب ديفيد لعدم تكافئها. وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ومن خلال هذا المنهج قام الباحث بوصف المعاهدات غير المتكافئة من حيث ماهيتها ومفهومها ومضمونها وصورها واليات انهائها، كما قام الباحث بتحليل اتفاقية كامب ديفيد كنموذج للمعاهدات غير المتكافئة وقام بتقييمها وإبراز أوجه عدم التكافؤ فيها.
وفي نهاية البحث توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها تضمن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل العديد من الأحكام الجائرة بحق الجانب المصري، مقابل امتيازات استفاد منها الجانب الإسرائيلي.
وأوصى الباحث في ختام بحثه جمهورية مصر العربية بالاحتجاج بنظرية تغير الظروف إزاء اتفاقية كامب ديفيد؛ وذلك لإلغائها أو تعديل أحكامها بما يتوافق مع المصالح الأمنية المصرية.
الكلمات المفتاحية: المعاهدات الدولية، كامب ديفيد، مصر، إسرائيل، التكافؤ، اتفاقية.
المقدمة.
إن مبدأ التكافؤ في المعاهدات الدولية يعد من أهم مبادئ القانون الدولي العام، والذي تم الإعلان عنه في كافة المواثيق والاعلانات الدولية، ويعني ذلك المبدأ أن جميع الدول مهما تعاظمت قوة بعضها تعتبر متساوية في الحقوق والالتزامات التي تثبت لكل دولة بحكم وجودها ويقرها ويحميها القانون الدولي العام.
ومن المعلوم أن المعاهدات الدولية يجب أن تقوم وفق أحكام القانون الدولي على أساس المساواة والتكافؤ بين الأطراف في المراكز التعاقدية والحقوق والواجبات الناشئة عنها، وفي حال اختل ذلك الأمر نكون أمام معاهدة غير متكافئة تنعدم فيها المساواة في المراكز التعاقدية بين طرفيها، واختلال في الامتيازات والالتزامات، ويمثل غياب مبدأ التكافؤ من المعاهدات الدولية خروجاً على الأصل الذي يقضي بوجوب أن تكون المعاهدة متوازنة من حيث الحقوق والواجبات لكل طرف من أطرافها، فتصبح في حال فقد التكافؤ منها معاهدة مختلة، وعلى قدر معين من الغبن، وعدم العدالة، وقد يمتد تأثيرها السلبي إلى الحد من حرية الدولة الطرف الأضعف في التصرف أو في ممارسة سلطتها فيما يتعلق ببعض المسائل خاصة في ميادين السياسة الأمنية والعسكرية والاقتصادية.
ومن أبرز النماذج على المعاهدات غير المتكافئة في العصر الراهن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، حيث تم التوصل إلى إطاري كامب ديفيد للسلام في سبتمبر 1978، ثم معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل في مارس 1979، وعلى الرغم من تنفيذ تلك المعاهدة بين الجانبين وفق المواعيد والإجراءات المتفق عليها، إلا أنه من خلال استقراء نصوصها يظهر انها معاهدة غير متكافئة خاصة فيما يتعلق بتدابير الأمن المطبقة بموجب هذه المعاهدة والتي تنقص من السيادة المصرية الكاملة على أرض سيناء، مما يقلل كثيراً من قدرة مصر في الدفاع عن أرض سيناء، وهذا يمثل امتيازا عسكريا لإسرائيل؛ يجعل من معاهدة كامب ديفيد معاهدة غير متكافئة.
مشكلة البحث:
تكمن مشكلة الدراسة في التعرف على المعيار الذي يتم الاعتماد عليه بمعرفة إذا كانت المعاهدة غير متكافئة أم لا، ومعرفة موقف القانون الدولي من هذه المعاهدات، ومعرفة الاليات المتبعة لإنهاء هذه المعاهدات خاصة ما يتعلق بمعاهدة كامب ديفيد.
وتأتي أهمية هذه الدراسة كون أن غياب مبدأ التكافؤ من المعاهدات يؤثر على المعاهدة بشكل كبير، الأمر الذي يحد من سيادة الدولة الطرف الضعيف في المعاهدة، ويجعل من الدول الضعيفة دول تابعة للقوى العظمى بموجب تلك المعاهدات غير المتكافئة التي أصبحت إحدى وسائل الاستعمار الحديثة. كما تأتي اهمية هذه الدراسة كونها ستبحث في مدى قدرة جمهورية مصر العربية على تعديل اتفاقية كامب ديفيد أو إلغائها على اعتبار أن تلك المعاهدة قد مست السيادة المصرية وأنقصت منها، الامر الذي يجعلها معاهدة غير متكافئة.
أهداف البحث:
تهدف هذه الدراسة إلى:
1- بيان مفهوم مبدأ التكافؤ من منظور القانون الدولي واتفاقية فيينا، وتحليل لاتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها جمهورية مصر مع إسرائيل.
2- بيان مدى تحقق عنصر عدم التكافؤ في الحقوق والالتزامات بين أطراف تلك المعاهدة.
أهمية البحث:
قد تفيد الدراسة في الخروج بتوصيات ومقترحات توضح كيف يمكن لمصر أن تنهي أو تعدل اتفاقية كامب ديفيد لعدم تكافئها
منهج البحث.
اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في بحث هذا الموضوع، ومن خلال هذا المنهج سيقوم بوصف المعاهدات غير المتكافئة من حيث ماهيتها ومفهومها ومضمونها وصورها واليات انهائها، كما سيقوم الباحث بتحليل اتفاقية كامب ديفيد كنموذج للمعاهدات غير المتكافئة وسيقوم بتقييمها وإبراز أوجه عدم التكافؤ فيها.
خطة البحث
قام الباحث بتقسيم الدراسة إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة؛ تحت كل مبحث ثلاثة مطالب، وكما يلي:
· المقدمة: وتضمنت ما سبق.
· المبحث الأول: ماهية مبدأ التكافؤ
o المطلب الأول: مفهوم مبدأ التكافؤ في القانون الدولي والنشأة التاريخية له.
o المطلب الثاني: موقف الفقه والقانون الدولي من مبدأ التكافؤ.
o المطلب الثالث: النتائج المترتبة على غياب مبدأ التكافؤ من المعاهدة الدولية.
· المبحث الثاني: معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية ومعيار عدم التكافؤ
o المطلب الأول: مضمون معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية ” كامب ديفيد “.
o المطلب الثاني: أبرز نقاط عدم التكافؤ في اتفاقية كامب ديفيد.
o المطلب الثالث: تعديل أو إنهاء معاهدة كامب ديفيد بسبب عدم تكافئها.
· الخاتمة: خلاصة بأهم النتائج، التوصيات والمقترحات.
المبحث الأول- ماهية مبدأ التكافؤ.
يحتل مبدأ التكافؤ في المعاهدات الدولية مكانة بارزة؛ كون أن غياب التكافؤ من المعاهدات يمثل خروجاً على مبادئ وقواعد القانون الدولي التي تنص على وجوب أن تكون المعاهدات متوازية بين أطرافها؛ حيث أنه وفقاً لمفهومي العدالة والمساواة بين الدولة فإنه يجب على الدولة أن تعقد فيما بينها معاهدات متكافئة في المراكز التعاقدية وفي الالتزامات والامتيازات، وفي الحقوق والواجبات الناجمة عنها.
إن غياب التكافؤ في نصوص المعاهدة الدولية يجعلها معاهدة غير متزنة، وتكون على قدر من الغبن، وعدم العدالة، وينتج عنها ظلم للطرف الأضعف الذي لا يستطيع أن يمارس سلطته في بعض المسائل التي تنظمها تلك المعاهدة غير المتكافئة، وخاصة في ميادين السياسة الأمنية والعسكرية والاقتصادية يحد من قدرته على ممارسة.
نتناول في هذا المبحث بيان ماهية مبدأ التكافؤ في المعاهدات الدولية من خلال ثلاثة مطالب، حيث يوضح الباحث في المطلب الأول مفهوم المبدأ، ومن ثم في المطلب الثاني يبين موقف الفقه والقانون الدولي واتفاقية فيينا منه، وفي المطلب الثالث يذكر أهم النتائج المترتبة على غياب مبدأ التكافؤ من المعاهدات الدولية.
المطلب الأول- مفهوم مبدأ التكافؤ في القانون الدولي والنشأة التاريخية له.
في هذا المطلب سيبين الباحث المقصود بمبدأ التكافؤ في القانون الدولي وذلك من خلال الفرع الأول، ومن ثم سيتطرق للنشأة التاريخية لمبدأ التكافؤ من خلال الفرع الثاني.
الفرع الأول- مفهوم مبدأ التكافؤ:
إن مبدأ التكافؤ بين الدول في نطاق المعاهدات يستمد وجوده من أحكام القانون الدولي التي تقر لكافة الدول صاحبة السيادة مجموعة من الحقوق الأساسية التي تلتصق بها منذ نشأتها، وتبقى تلك الحقوق جزء لا يتجزأ من كيان الدولة وحياتها، ولا يجوز للدول أن تتنازل عنها، ويكون الإخلال بتلك الحقوق محظور ولا يرتب أي أثر قانوني؛ وعليه فإن أي معاهدة تقوم الدولة بتوقيعها يجب أن تكون بمنأى عن المساس بهذه الحقوق؛ لأن المساس بها يجعل موضوعها غير مشروع. (شكري، 1953م، ص93)
وقد عرف الدكتور علي أبو هيف مبدأ التكافؤ بقوله: ” التكافؤ بين الدول هو أن يكون جميع أعضاء المجتمع الدولي أمام القانون الذي ينظم جميع شؤونهم فلهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات التي تثبت لتلك الدول بحكم وجودها ويقرها ويحميها تلقائياً القانون الدولي العام، وكذلك تلك التي تقررت في المعاهدات والاتفاقيات الدولية بالنسبة للدول الأطراف فيها وغيرها من الدول التي يمكن أن تمتد أحكامها إليها ويستفيد منها كالمعاهدات الشارعة مثلاً” (أبو هيف، 1995م، ص225)
ومن المعلوم أن غياب مبدأ التكافؤ من المعاهدات يجعل من المعاهدة غير متكافئة، وقد عرف الفقهاء المعاهدات غير المتكافئة بأنها: ” تلك المعاهدات التي ترتبط بموجبها دولتان والتي ينتج عنها وضع قانوني وسياسي مقتضاه حرمان إحدى الدولتين المتعاقدتين من بعض مظاهر الاستقلال الخارجي أو اختصاص الداخلي لصالح دولة أخرى أو اخضاعها لسيطرة تلك الدولة في بعض المسائل وهذا الوضع القانوني والسياسي الذي يجعل الدولتين في مركزين غير متكافئين ” (شكري، 1953م، ص113)
ويرى الباحث أن الاتفاقيات غير المتكافئة هي: ” تلك المعاهدات التي تتناسب شروطها مع قوة الأطراف المتعاقدة على أن تطبق شروط المعاهدة بصورة متساوية ” ولذا فإن المعاهدات التجارية مثلاً كالتي تحتوي على شروط الدولة الأولى بالرعاية هي معاهدات متكافئة، فهذه المعاهدات تقضي مركزاً متساوياً لكل المتعاقدين وينطبق بالتساوي عليهما.
إن الاتفاقية غير المتكافئة يمكن أن تكون حينما تفرضها دولة أقوى على دولة أضعف، ويترتب عليها انتقاص مؤقت من سيادة الدولة الأضعف، في إقليمها وفي شؤون أخرى. وقد تكون تلك الاتفاقيات مقبولة ظاهرياً، لكنها في حقيقتها تعتبر أدوات للاستغلال، والإخضاع السياسي والاقتصادي، بما يمارس فيها من وسائل الضغط المختلفة؛ العسكرية والسياسية والاقتصادية. وعليه فالتكافؤ في المعاهدات يجعل من المراكز التعاقدية للدول الموقعة على المعاهدة مراكز متوازنة، وتكون الالتزامات والحقوق فيها متعادلة؛ الأمر الذي يحفظ المصالح الحيوية لأطراف المعاهدة، ويسمح للطرف الأضعف في المعاهدة من الافصاح عن ارادته الحقيقية. (الغنيمي، 1982م، ص182)
الفرع الثاني- النشأة التاريخية لمبدأ التكافؤ وأسباب قبول الدول للمعاهدات غير المتكافئة:
برز مفهوم مبدأ التكافؤ في عقد المعاهدات الدولية والاحتجاج به كقاعدة ينبغي أن تتوافر لإكمال صحة شرعية المعاهدات في النصف الثاني من القرن العشرين (الجشعمي، 2014م، ص213) ونتج عن ظهور مبدأ التكافؤ بدء التفرقة بين نوعين من المعاهدات هما المعاهدات المتكافئة والمعاهدات غير المتكافئة؛ حيث ظهرت تلك التفرقة في البداية على نحو غير محدد وأخذت بالتدرج شكلاً أكثر تحديداً حينما تطورت إلى نظرية ترتبط بمشكلة سيادة الأطراف المتعاقدة. (عثمان، 1963، ص39)
وقد بدأت المعاهدات غير المتكافئة في الظهور مع بداية القرن الثامن عشر، حيث سادت في تلك الفترة بعض المفاهيم التي ساعدت على عقد مثل تلك المعاهدات مثل مفهوم اباحة حق الحرب والفتح والغزو وغيرها، كما انه مما ساعد على ظهور تلك المعاهدات نصوص القانون الدولي التي كانت في تلك الفترة تخدم الاهداف الاستعمارية بشكل كبير؛ حيث أقرت بالطرق المختلفة لاكتساب السيادة على الأقاليم الضعيفة بصفة عامة والمستعمرات بصفة خاصة، واجتهد الفقه في وضع قواعد خاصة بهذه الطرق وتحليلها وتحويرها كلما دعت تطور الظروف إلى ذلك، كما شهد النصف الثاني من القرن الثامن عشر تزايد نصوص المعاهدات التي حجبت بشكل أو بأخر حق السيادة الوطنية لبعض الدول الصغيرة بهدف الإبقاء على إطار معين من العلاقات الخارجية وحصرها ببعض الدول الأوربية ([1])، بينما اتجه التطور الذي شمل غالباً عزل الحكام لهذه الدول إلى تبعيتهم إلى دولة أوربية معينة. (عبد الرزاق، 2018م، ص26)
وتجدر الإشارة إلى أن السياسة الأوربية تبلورت طيلة القرن 19 حول محور واحد، وهو ربط المجتمع الإنساني بأوروبا عن طريق أنظمة استعمارية، تحقيقاً لما اعتبرته ضرورة ملحة أي الحصول على أسواق كثيرة، تستعمل كمنافذ لتصريف الانتاج الصناعي، وللحصول على المواد الخام. وبالتالي ضمان تحقيق استمرارية التفوق المالي والاقتصادي والحضاري؛ ولتحقيق تلك الأهداف تطورت الحركة الاستعمارية في إطار مجموعة من الأساليب كان من بينها أسلوب المعاهدات غير المتكافئة؛ حيث أصبح ذلك الأسلوب أهم خطوة في المخطط الاستعماري خلال القرن التاسع عشر. (سميرس، 1989م، ص159)
ومن أبرز المعاهدات غير المتكافئة التي وجدت في القرن 19، معاهدة 1838 التي حددت ارتباط الامبراطورية العثمانية بأوربا إلى الى الحرب العالمية الأولى، ومعاهدة نانكان 1842 (بعد حرب الأفيون الأولى) التي فتحت أبواب الصين، وقبل ذلك اتفاقية 1823 التي ربطت مصير أمريكا اللاتينية، ثم المعاهدات التي أبرمتها الدول الأوربية على الخصوص في النصف الثاني من القرن 19 مع مصر وتونس والمغرب.
كما أنه من أبرز المعاهدات التي أدت إلى ظهور ونشأة مبدأ التكافؤ، والتي مثلت نموذجاً لتطبيق المعاهدات غير المتكافئة، هي معاهدات الامتيازات الأجنبية، حيث تعرف تلك المعاهدات بأنها: ” معاهدات تتضمن تسهيلات مختلفة، تجارية، دينية، قضائية، سياسية، تقدمها الدول للدول الأجنبية بهدف تشجيعهم على الإقامة فيها، واستثمار أموالهم وخبراتهم، وكانت الامتيازات تشمل تسهيلات في السفر والاقامة والتقاضي أمام المحاكم الخاصة وحرية ممارسة شعائرهم الدينية والتعليم، والاعفاء من الضرائب في قطاعات بعينها” (عبيدات، 2014م، ص2)
أما فيما يتعلق بالأسباب التي قد تدفع الدول إلى توقيع معاهدات غير متكافئة فقد تكون الأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية، أو عسكرية، فالدول التي تكون خاضعة للاستعمار توقع هذا النوع من المعاهدات للتخلص من الاستعمار، فتوافق الدولة المستعمرة نتيجة ممارسة الضغط والإكراه عليها لتوقيع تلك المعاهدة غير المتكافئة. أما من ناحية سياسية فالدول الضعيفة توقع معاهدات غير متكافئة لتتقاوى بالدول العظمي، إلا أن الدول العظمى تستغل حاجة الدول الضعيفة لها من خلال الضغط عليها لقبول شروطها وتوقيع معاهدات غير متكافئة معها، الأمر الذي يترتب عليه أن تسيطر الدولة القوية على قرارات الدول الضعيفة من خلال ربطها بمعاهدات سياسية غير متكافئة تمكنها من فرض ارادتها عليها واستغلالها. ومن أهم الدوافع التي تدفع الدول لتوقيع معاهدات غير متكافئة هي الأسباب الاقتصادية، حيث تغري الدول العظمي الدول الضعيفة بأنها ستقدم لها مساعدات ومعونات اقتصادية، وتستغل حاجة وفقر تلك الدول من خلال إكراهها على توقيع المعاهدات غير المتكافئة لتستمر بدعمها اقتصادياً؛ كون أن الدول التي تفشل في مواجهة مشكلتها الاقتصادية، سوف تذعن بالنهاية لضغوط الدول المانحة، وسوف تتنازل عن سيادتها الداخلية وسوف تطلق العنان لرؤوس الاموال الخارجية للهيمنة على قرارها ومقدراتها.
المطلب الثاني- موقف الفقه والقانون الدولي من مبدأ التكافؤ.
أولى الفقه الدولي واتفاقية فيينا عناية كبيرة لمبدأ التكافؤ بين الدول في المعاهدات، حيث أكد الفقهاء على ضرورة أن يوجد ذلك المبدأ في كافة المعاهدات بغض النظر عن أي اعتبارات تتعلق بمساحة الدول أو عدد سكانها، أو تقدمها العسكري والاقتصادي. (جعفر، 1990، ص50)
في هذا المطلب سيبين الباحث موقف الفقه الدولي من مبدأ التكافؤ ومن المعاهدات غير المتكافئة وذلك في الفرع الأول، كما سيوضح موقف اتفاقية فيينا في الفرع الثاني.
الفرع الأول: موقف الفقه الدولي من مبدأ التكافؤ
تناول الفقه الدولي مبدأ التكافؤ وموضوع المعاهدات غير المتكافئة، وقد استند إلى تكيفها إلى عدة معايير، أبرزها معيار الإكراه، معيار التعادل بين الأطراف، معيار احترام مبدأ المساواة بين الدول.
أولاً- معيار الإكراه:
من المتفق عليه أنه يشترط لصحة المعاهدة الدولية أن يكون رضاء أطرافها الالتزام بأحكامها رضاء سليماً حراً غير مشوب بأي عيب من عيوب الرضاء مثل: الغلط أو التدليس أو الإكراه. (عبد الحميد، وحسين، 1988م، ص71)
ويعرف الإكراه في مجال القانون الدولي بأنه قيام الدولة بالضغط على دولة أخرى أو على ممثلها ليدفعه إلى التعاقد، ومن الجدير بالذكر في هذا المجال أن الإكراه المعتبر عيباً من عيوب الرضاء وفقاً للقانون الدولي العام هو الإكراه الصادر على شخص ممثل الدولة، أو على الدولة ذاتها، ومن شأن وقوع مثل هذا الإكراه أن يجعل المعاهدة قابلة للإبطال. (اتفاقية فيينا، المادة 50+51)
وقد نصت المادة (51) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م على أنه: ” ليس لتعبير الدولة عن رضاها الالتزام بمعاهدة والذي تم التوصل إليه بإكراه ممثلها عن طريق أعمال أو تهديدات موجهة ضده أي أثر قانوني “
والملاحظ من النص السابق أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات قد طبقت استخدام هذه المادة حينما حصرت تعبير القوة الوارد في ميثاق الأمم المتحدة باعتباره لا يشمل جميع صورها التي تشكل عيباً يقضي ببطلان المعاهدة، وقد لاقى النص السابق ذكره من اتفاقية فيينا نقداً شديداً؛ كون أن القول بصحة المعاهدات المبرمة نتيجة إكراه واقع على الدولة قول لا يتمشى البتة واعتبارات العدالة؛ إلا أن انتقاد ذلك النص لا يؤثر على أية حال في تواتر الجماعة الدولية على تطبيقه، ولعل خير تفسير لتواتر الجماعة الدولية على تطبيق هذه القاعدة بالرغم من تعارضها الواضح مع المنطق والعدالة، هو أنها قاعدة لا بد منها لاستقرار المعاملات بين الدول، والواقع أنه لو فتح باب إبطال المعاهدات على أساس الإكراه الواقع على الدولة المتعاقدة لاهتزت الثقة بين الدول. (عبد الحميد، وحسين، 1988م، ص73)
والجدير ذكره أن القانون الدولي المعاصر يحرم استخدام القوة في مجال العلاقات الدولية، وذلك ما أشارت له اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في المادة (52) والتي نصت على أنه: ” تعتبر المعاهدات باطلة بطلاناً مطلقاً إذا تم إبرامها نتيجة تهديد باستعمال القوة أو باستخدامها لمبادئ القانون الدولي العام الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ” ومن أمثلة ذلك ما حدث في عام 1983م، عندما دخلت القوات اليهودية إلى لبنان وعمدت إلى محاصرة بيروت وفرضت عليها حصاراً برياً وبحرياً وجوياً أجبرت ذلك الحكومة اللبنانية على إبرام اتفاق 17 مايو عام 1983، وقد تم إلغائها فيما بعد لأسباب عدة أهمها أنه اتفاق باطل وتم بالإكراه ولم يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب اللبناني. (عبد الحميد، وحسين، 1988م، ص79)
ويعرف أصحاب هذا الاتجاه المعاهدة غير المتكافئة بأنها: ” تلك المعاهدة المفروضة من أحد الأطراف المتعاقدة على الطرف الأخر” وعرفها أخرون بأنها تنجم عن الموقف غير المتساوي لطرفيها، حيث يكون هناك طرف قوي يجعل الطرف الأخر وهو ضعيف أن يلتز في المعاهدة بما يخالف مصالحه، والمبادئ العامة للعدالة، وأن هذه المعاهدات هي التي تستخدم لتكريس التبعية والاستغلال للدول الصغيرة والضعيفة. (اسماعيل، 2011م، ص81)
ويرى الباحث أن مبدأ التكافؤ يغيب من المعاهدة بسبب الإكراه في الحالات التي تبرم فيها الاتفاقيات الدولية، ولا يكون أمام أحد أطرافها إلا أن يقبل بأحكام تلك المعاهدة، وذلك مثل: الاتفاقيات التي تبرمها الدولة قبل الحصول على الاستقلال؛ فتقبل الدولة بالمعاهدة بهدف حصولها على استقلالها؛ وعليه فتكون مكرهة للقبول بأحكام تلك المعاهدة.
وبناء على ما سبق، فإن المعاهدة التي تبرم تحت الإكراه سواء أكان الإكراه على ممثل الدولة، أم على الدولة ذاتها، هي معاهدة باطلة بطلاناً مطلقاً منذ لحظة إبرامها، وهو ما أوضحته معاهدة فيينا لقانون المعاهدات في مادتها (51) المتعلقة بالإكراه الواقع على ممثل الدولة بالنص: ” ليس لتعبير الدولة عن رضاها الالتزام بمعاهدة والذي تم التوصل إليه بإكراه ممثلها عن طريق أعمال أو تهديدات موجهة ضده أي أثر قانوني ” ويعتبر البطلان حق مطلق للدولة ليس لها حرية الاختيار في تطبيق النص من عدمه، نظراً لخطورة التصرف الناجم عن الإكراه، فالبطلان يرتد إلى لحظة إبرام المعاهدة، حتى لا يترتب عليه اكتساب حقوق وتحمل التزامات. (مصطفى، 2016م، ص579)
وقد يتعرض ممثل الدولة لإكراه مادي أو معنوي، بمقتضاه يتم التنازل عن جزء من حدود دولته، أو التصديق على معاهدات مخالفة لمصالح شعبه، إذا كانت السلطات التشريعية الداخلية لبلاده تسمح له الحق بإبرام المعاهدات دون الرجوع إلى البرلمان، وهو الامر الذي يتيح للجهة التي تريد إذعانه بالضغط عليه للرضوخ لأوامرها، إما خوفاً على حياته أو مستقبل بلاده، لذلك أتى نص المادة (51) يكرس البطلان المطلق في هذه الحالة. وكذلك الأمر أن تعرضت الدولة لضغوط وتهديدات عسكرية، كمحاصرة إقليمها البري أو البحري بقوات عسكرية أو غيرها من أنواع التهديدات، مما تضطر الجهة التشريعية بالرضوخ لهذه التهديدات خوفاً على الاستقرار الداخلي للدولة. (مصطفى، 2016م، ص581)
وتجدر الاشارة إلى أن إلزام نص المادة (51- 52) بأن المعاهدات التي تبرم تحت الإكراه تكون باطلة بطلاناً مطلقاً، تجعل القاعدة امرة وليست مكملة، بخلاف الأثار المترتبة عن باقي عيوب الرضا الأخرى (الغلط – الغش- التدليس) حيث يترتب عليها البطلان النسبي، أن شاءت الدولة طالبت بالبطلان أو تغاضت عنه.
كما يرى الباحث أنه يمكن الاستناد لأحكام البطلان الواردة في اتفاقية فيينا في المواد ” 52″، “53” في إلغاء أو تعديل كثير من الاتفاقيات غير المتكافئة، خاصة تلك الاتفاقيات التي يتم عقدها بين الدول الكبرى والدول النامية، والتي يشكل عنصر الضغط السياسي والاقتصادي جانباً هاماً في إذعان هذه الدول لإبرامها، وبالتالي فمن حق الدول النامية الاستناد لهذه النظرية لإبطال الاتفاقيات التي أبرمت نتيجة للإكراه.
ثانياً- معيار التعادل في التزامات الأطراف:
يتبنى أصحاب هذا المذهب الرأي الذي يقول بأن عدم التكافؤ يعود إلى عدم التعادل الواضح والفعلي وقت إبرام المعاهدة في الالتزامات بين الطرفين فيما يتعلق بحقوق سيادتهم؛ وعليه فإن أصحاب هذا الرأي يعرفوا المعاهدة غير المتكافئة بأنها: ” المعاهدات التي يتحمل فيها أحد الاطراف أكثر من الأخر، أو هي المعاهدات التي لا يتعهد الأطراف فيها بذات الالتزامات أو التزامات متساوية ” (اسماعيل، 2011م، ص 82)
ثالثاً- معيار احترام مبدأ المساواة بين الدول:
يرى أصحاب هذا المعيار بأن المعاهدات غير المتكافئة هي: ” التي لا تحترم مبدأ المساواة في السيادة بين الدول ” ووفق هذا المعيار فإن مبدأ التكافؤ يغيب من المعاهدة في حال لم يتم احترام مبدأ المساواة في السيادة بالنسبة لأحد الأطراف في المعاهدة.
ويذهب اخرون من هذا الاتجاه الفقهي إلى الربط بين المعاهدات غير المتكافئة والظاهرة الاستعمارية عند تعريف هذه المعاهدات غير المتكافئة حيث عرفها بأنها: ” هي التي ترتبط بموجبها دولتان وينتج عنها وضع قانوني وسياسي مقتضاه حرمان إحدى الدولتين المتعاقدين من بعض مظاهر استقلالها الخارجي أو اختصاصها الداخلي لصالح الدولة الأخرى، أو إخضاعها لسيطرة تلك الدولة في بعض المسائل “
وعلى الرغم من هذا الخلاف الفقهي حول معيار عدم التكافؤ فإنه يوجد هناك قاسم مشترك بين الفقهاء القائلين بهذا المبدأ، وهو اعتبار أن المعاهدة غير المتكافئة تتضمن الإخلال ببعض، أو كل الحقوق الجوهرية لأحد أطراف المعاهدة بما يجعل هذه المعاهدة غير مشروعة، مما يحق لهذا الطرف أن يطلب إبطال المعاهدة. (مريكب، 2006م، ص405)
الفرع الثاني- موقف القانون الدولي واتفاقية فيينا من مبدأ التكافؤ :
في ظل هيمنة قليل من الدول الكبرى على باقي دول العالم، وإبرام الكثير من الدول العربية لبعض المعاهدات ناتجة عن ضغوط دولية ويغيب من نصوصها مبدأ التكافؤ، تظهر أهمية اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، كونها اتفاقية شارعة ملزمة وهي القاعدة العامة لكل اجراءات ابرام المعاهدات الدولية واثارها والأحكام المتصلة بها.
ومن خلال استقراء نصوص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م، فإن الباحث يسجل بأن الاتفاقية قد خلت تماماً من مصطلح المعاهدات غير المتكافئة؛ ولم تنص نصوص الاتفاقية على حالة البطلان في حال غياب مبدأ التكافؤ عن الاتفاقية وعدم مراعاة الدولة لذلك المبدأ؛ وذلك بسبب موقف الدول القوية التي عارضت بشكل كبير النص على بطلان المعاهدات غير المتكافئة؛ كونها في الغالب تكون مستفيدة من تلك المعاهدات. (أبو هادي، 2013م، ص200)
وعلى الرغم مما سبق؛ فإنه يلاحظ بأن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م، قد وضعت قواعد معينة تقضي بإبطال أي معاهدة في حال كانت ناجمة عن عيب من عيوب الإرادة، كالإكراه أو الغش أو الغلط.
والجدير ذكره أن اتفاقية فيينا قد رتبت البطلان كجزاء يترتب في حالة مخالفة القواعد الأمرة ([2]) المنصوص عليها في القانون الدولي؛ إلا أنها ميزت في هذا الصدد بين مخالفة نص المادة ” 53″ من الاتفاقية، ونص المادة “64”، فجعلت من مخالفة نص المادة “53” أي- مخالفة قاعدة أمرة قائمة حين عقد المعاهدة- بطلان عام يصيب الاتفاقية كلها بما فيها النصوص التي لا تتنازع مع القواعد الأمرة، في حين لو كانت المخالفة لنص المادة “64” فإن البطلان يكون جزئي؛ بحيث تبقى كافة الأثار التي تولدت عن تلك الاتفاقية صحيحة باستثناء النصوص التي تتعارض مع القاعدة الامرة الجديدة. (رمضان، 1978م، ص38)
وبناء على ما سبق؛ فإن المعاهدات غير المتكافئة يمكن اعتبارها وفقاً لاتفاقية فيينا مخالفة جوهرية للقواعد الأمرة المنصوص عليها في القانون الدولي؛ كون أن تلك المعاهدات تقوم طبيعتها على أساس إهدار مبدأ المساوة في السيادة بين الدول، وتكريس الأوضاع الاستعمارية، وإغفال حق تقرير المصير؛ وبما أنه يشترط حتى يكون موضوع المعاهدة مشروع فينبغي ألا يتعارض مع قاعدة امرة من قواعد القانون الدولي؛ وعليه فتكون المعاهدات غير المتكافئة معاهدات غير مشروعة كون أن فكرتها الأساسية تخالف العديد من القواعد الأمرة، وهذا ما أكدت عليه العديد من الدول أثناء مناقشة لجنة القانون الدولي للقواعد الامرة بأن تلك القواعد تشمل حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشئون الداخلية، ومنع استعمال القوة، والمساواة بين الدول في السيادة؛ وعلى هذا الأساس فإن أي معاهدة تتعارض مع تلك المبادئ تعتبر باطلة لمخالفتها القواعد الامرة. (النقيب، 2017م، ص100)
وقد عبر عن المعنى السابق مندوب الاتحاد السوفيتي لدى اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة عندنا قرر ضرورة احتواء القواعد الامرة على المبادئ العامة في الميثاق، كالسيادة والمساواة بين الدول، واضاف أنه يجب اعتبار المعاهدات المختلفة للمستعمرين الجدد باطلة، حيث أنها غير متكافئة ولا تتفق مع مبدأ المساواة في السيادة بين الدول. كما ذهب مندوب المجر إلى أن وجود المعاهدات غير المتكافئة، يعد أمراً غير محتمل بالنسبة للدول المستقلة حديثاً، ويشكل خطورة عليها، وأضاف أن تلك المعاهدات التي تفرض الالتزامات غير المناسبة على أحد الأطراف، يمكن أن تعتبر باطلة طبقاً لمشروع القانون الدولي، ورأى أنه من المرغوب فيه تناول تلك المشكلة صراحة في مادة منفصلة عن المشروع. (رمضان، 1978م، ص38)
وبناء على ما سبق؛ فإنه يمكن القول بأن القواعد الامرة تعد من ألصق المبادئ بنظرية الاتفاقيات غير المتكافئة، وان القول بوجود قاعدة امرة في القانون الدولي يستتبع بالضرورة بطلان الاتفاقيات غير المتكافئة؛ وعليه فإن الباحث يرى بضرورة أن تنص اتفاقية فيينا على بطلان المعاهدات غير المتكافئة لمخالفتها الجسيمة لأحكام الاتفاقية ولمشروعية المعاهدات.
ومن جهة أخرى، فإن المعاهدات غير المتكافئة تعتبر معاهدات مخالفة لميثاق الأمم المتحدة، حيث تنص المادة (103) من الميثاق على أنه: ” إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي أخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على الميثاق ” ويتبين من ذلك النص أنه لا يعتد بأي التزامات ناشئة عن معاهدات في حال كانت متعارضة مع التزامات الأعضاء بموجب ميثاق الامم المتحدة؛ وبما أن المعاهدات غير المتكافئة تفتقد إلى مبدأ المساواة الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في ديباجته ([3])، كما تتناقض تلك المعاهدات مع نص المادة (55) من الميثاق والذي يؤكد على تطوير علاقات الصداقة بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة وحق تقرير المصير.
والجدير بالذكر أن الأمم المتحدة قد لعبت دوراً مهماً في رفض المعاهدات غير المتكافئة، ويظهر ذلك في موقف الأمم المتحدة من قضية قبرص مع اليونان وتركيا والمملكة المتحدة عام 1960م وذلك في أعقاب مؤتمر لندن وزيوريخ، حيث بحثت فيها موضوع استقلال الجزيرة، واستنادا إلى هذه المعاهدة حاولت بعض الدول التدخل عسكرياً حينما وقعت الحرب الأهلية المذكورة، حيث تعرض ممثلو الوفود إلى معاهدات الضمان بين قبرص من جانب وتركيا وبريطانيا من جانب أخر، والتي تخول هذه الدول الضامنة منفردة في شؤون قبرص لضمان تنفيذ المعاهدة، وقد احتج وزير خارجية قبرص على المعاهدة المذكورة، كون أن أي معاهدة تنال من استقلال الدولة وسيادتها تعتبر باطلة، كما أن الشرط الوارد في المعاهدة المذكورة هو شرط غير متكافئ. ومن خلال مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاحتمال هذا الدخل قررت الجمعية رفضه ووصفت ما تضمنته المعاهدة من جواز تدخل أي دولة من الدول الضامنة في مثل هذه الحالة بأنه باطل؛ لأنه يعتبر من المعاهدات التي تحتوي على شرط الأسد. (عبد الرزاق، 2018م، ص41)
المطلب الثالث- النتائج المترتبة على غياب مبدأ التكافؤ من المعاهدة الدولية.
إن غياب مبدأ التكافؤ من المعاهدة الدولية يجعل أطراف المعاهدة في مركزين غير متكافئين، بحيث تصبح الدولة الضعيفة في وضع سياسي وقانوني مقتضاه حرمانها من بعض مظاهر سيادتها الخارجية، واختصاصاتها الداخلية لبعض الدول القوية؛ الامر الذي ينشأ عنه أن تصبح الدولة القوية بموجب المعاهدة غير المتكافئة متعسفة بحق الدولة الضعيفة بحيث تمارس عليها نوع من الاستغلال المقيد لبعض الالتزامات التي يرد النص عليها في تلك المعاهدات.
في هذا المطلب سيوضح الباحث أبرز النتائج المترتبة على غياب مبدأ التكافؤ من المعاهدات الدولية، حيث سيقوم بدراسة الاثار السياسية والعسكرية المترتبة على تلك المعاهدات في الفرع الأول، والأثار القانونية والاقتصادية في الفرع الثاني.
الفرع الأول- الاثار السياسية والعسكرية لغياب مبدأ التكافؤ من المعاهدة الدولية.
إن من أبرز الأثار السياسية التي تنتج عن غياب مبدأ التكافؤ من المعاهدة الدولية أن سيادة الدول الموقعة على مثل تلك المعاهدات تكون سيادة مقيدة؛ كون أن تلك المعاهدات تندرج في إطار معاهدات التبعية، بمعنى أن الدولة القوية بموجب المعاهدة غير المتكافئة تصبح مسيطرة على الدولة الضعيفة؛ مما ينتج عنه حرمان الدولة الضعيفة من بعض مظاهر سيادتها الخارجية واختصاصها الداخلي لصالح الدولة القوية. إضافة إلى أن غياب مبدأ التكافؤ من المعاهدة يؤدي إلى اختلال في المراكز القانونية للدول المتعاقدة؛ الامر الذي ينشأ عنه تطور في العلاقة بين دولة تابعة ودولة متبوعة، فتقوم الدولة التابعة بإيراد نصوص في المعاهدة غير المتكافئة تقيد من سلطات الدولة المتبوعة. (شكري، 1953م، ص126)
كما يترتب على ابرام المعاهدات غير المتكافئة من الناحية السياسية سيطرة الدول القوية واستغلالها للدول الضعيفة، لذلك فقد أصبحت المعاهدة غير المتكافئة إحدى الوسائل الحديثة التي تستخدمها الدول الاستعمارية؛ بهدف فرض السيطرة على الدول الضعيفة؛ حيث تقرر تلك المعاهدات أوضاعاً سياسية يكون من أثرها المباشر المساس بسيادة الدول التي تُفرض عليها الالتزامات. (الطيار، 2000م، ص80)
أما من الناحية العسكرية فإن غياب مبدأ التكافؤ من المعاهدات الدولية أدى إلى تطور المشكلة الاستعمارية؛ كون أن الدول الاستعمارية أصبحت تفرض أرائها ومواقفها وسياساتها على الدول الضعيفة من خلال المعاهدة غير المتكافئة، ومن أبرز أنواع هذه المعاهدات تقديم المساعدات العسكرية، أو إقامة القواعد العسكرية. كما تسعى الدول الكبرى من خلال المعاهدات غير المتكافئة إلى عقد تحالفات عسكرية مع الدول الضعيفة، وهذه التحالفات تقيد سيادة الدول الضعيفة والتي اضطرت إلى ارتقاء بالحماية العسكرية وهذا يؤثر في سيادتها، وبالتالي تخل بمبدأ المساواة والتي يفترض أن تتمته بها قبل غيرها، كما أن الانضمام إلى الأحلاف العسكرية القائمة وإقامة القواعد وتخزين الأسلحة وتقديم التسهيلات العسكرية هو أحد وسائل الهيمنة، ويؤدي بالتالي إلى المساس بالسيادة الوطنية للدول الخاضعة للهيمنة. (عبد الرزاق، 2018م، ص 51)
الفرع الثاني- الاثار القانونية والاقتصادية لغياب مبدأ التكافؤ من المعاهدة الدولية.
يترتب على عدم التكافؤ في المعاهدات وانعدام المساواة بالمراكز التعاقدية بين أطراف المعاهدة انتقاص الحقوق الأساسية القانونية للدولة مثل الحق بالسيادة، وما يترتب على ذلك من اثارة العداوة بين دول العالم وتهديد الأمن والسلم العام، كما يترتب على غياب مبدأ التكافؤ من المعاهدات الاخلال بحق المساواة بين الدول فهي تعقد بين طرفين يتسمان بتفاوت كبير في القوة، وإضافة لما سبق فإن عدم التكافؤ في الشروط المنصوص عليها بالمعاهدة فيما يتعلق بممارسة الدولة للحقوق الأساسية داخلياً وخارجياً، ينفي صفة الدولة في القانون الدولي، وتكتسب هذه الصفة عندما تستعيد المساواة في الحقوق والواجبات التي ترتبها المعاهدة. (أبو هيف، 1995م، ص234)
كما يترتب على انعقاد المعاهدات غير المتكافئة انعدام المساواة في المراكز التعاقدية بين طرفيها والاخلال في الامتيازات والالتزامات الناشئة عنها بالنسبة لكل منهما، كأن تفرض التزامات على جانب وتمنح إلى جانب أخر. كما تؤدي إلى تؤدي إلى انتقاص من الحقوق الأساسية لبعض الدول كحق السيادة أو المساواة بحيث يؤدي استمرارها إلى انتهاك سيادة الطرف الأضعف فيها واهدار المصالح الحيوية، كما تؤدي إلى العداوة والضغينة بين الدول وتهديد السلم. (عبد الرزاق، 2018م، ص54)
أما من الناحية الاقتصادية فإنه يترتب على ابرام الدول الضعيفة للمعاهدات غير المتكافئة أثار اقتصادية بالغة الأهمية، فالدول الكبرى عندما تقوم بتقديم المساعدات والمعونات الاقتصادية؛ تهدف إلى ضمان حقوق استعمارية معينة في دولة أقل تقدماً، وان جوهر هذه المعاهدات قد أفصحت عن نفسها من خلال الاستقراء التاريخي وما تضمنه من شروط خاصة لها تأثيرات ملحوظة على اقتصاد الدولة الأخيرة، كما أن المساعدات التي كانت تعطى يمكن سحبها فقط بواسطة إجراءات متسلطة ومنفردة وهي بمعنى اخر أن هذه المعاهدات تكرس الاستغلال والتبعية الاقتصادية. (الطراونة، 2005م، ص212)
والجدير ذكره أن الدول الكبرى تعمد إلى ابرام المعاهدات غير المتكافئة؛ حيث تقوم بتقديم معونات مالية كبيرة، وتكون أداة للتبعية ومجرد مدفوعات عن خدمات تقدم للدول المانحة، فالدولة التي تفشل في مواجهة مشكلتها الاقتصادية، سوف تذعن في النهاية لضغوط الدول المانحة، وسوف تقوم بالتنازل عن توجهاتها الاقتصادية المستقلة والسماح بتدخل الدائنين والمنظمات الدولية في شؤونها الداخلية
المبحث الثاني- معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية ومعيار عدم التكافؤ .
بدأت مرحلة السلام بين مصر وإسرائيل بزيارة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات لمدينة القدس عام 1977م، وبعد تلك الزيارة تم التوصل إلى إطاري كامب ديفيد للسلام في سبتمبر 1978م، ثم معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل في مارس عام 1979م، وقد وضعت وثيقة كامب ديفيد، ووثيقة المعاهدة أسساً للتسوية مع الفلسطينيين.
وعلى الرغم من تنفيذ معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية وفق المواعيد والإجراءات المتفق عليها تحت رعاية القوة متعددة الجنسيات، والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن تدابير الأمن المطبقة بموجب هذه المعاهدة تجعلها معاهدة غير متكافئة؛ كون أنها تنقص من السيادة المصرية الكاملة على أرض سيناء، وتضعف من القدرات العسكرية المصرية على الضفة الشرقية لقناة السويس مما يقلل بشكل كبير من قدرة مصر في الدفاع عن أرض سيناء.
نتناول في هذا المبحث معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية ومعيار عدم التكافؤ من خلال ثلاثة مطالب، حيث يبين الباحث في المطلب الأول مضمون معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، ومن ثم في المطلب الثاني يبين أبرز نقاط عدم التكافؤ المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي المطلب الثالث يوضح كيف يمكن إنهاء أو تعديل معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية بسبب عدم تكافئها.
المطلب الأول- مضمون معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية ” كامب ديفيد “.
في هذا المطلب سيتطرق الباحث إلى مضمون معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية ” كامب ديفيد”، حيث سيبين في الفرع الأول النشأة التاريخية لاتفاقية كامب ديفيد، وفي الفرع الثاني سيوضح أبرز بنود تلك الاتفاقية.
الفرع الأول- نبذة تاريخية حول اتفاقية كامب ديفيد
أدركت الولايات المتحدة الامريكية بعد انتهاء حرب تشرين الأول 1973م بين العرب وإسرائيل، أنه من الممكن أن تتجه المنطقة إلى حرب وصراع جديد أن لم يتم التوصل لتسوية شاملة بين العرب وإسرائيل؛ ولذلك فقد بادرت إدارة الرئيس الأمريكي جيرالد فورد (1973- 1976) وإدارة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر (1977- 1981) بطرح مبادرات بهدف عقد تسوية منفردة، وعقد صلح بين مصر وإسرائيل.
وفي تاريخ 5 أيلول 1978م وجه الرئيس الامريكي كارتر دعوة لكل من بيغن والسادات لحضور مؤتمر قمة في منتجع كامب ديفيد في واشنطن، وقد حضر الوفدان المصري والإسرائيلي تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي في الوقت المحدد لبدء المفاوضات، وقد عقد المؤتمر في كامب ديفيد في تاريخ 5 سبتمبر 1978، وانتهت أعماله في 18 من الشهر نفسه، أي استمر ثلاثة عشر يوماً، حاولت فيها الولايات المتحدة أن تجد حلاً وسطاً بين رغبات السادات وهي الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وبين تمسك بيغن بعدم التنازل عن الضفة الغربية وقطاع غزة. (الوثائق الفلسطينية، 1975، ص449)
وفي اليوم الأول من المفاوضات قدم الرئيس السادات أفكاره عن حل القضية الفلسطينية بجميع مشاكلها مؤكداً على أن يكون مشروع قرار مجلس الأمن الدولي رقم (242) كأساس للحل وانسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة، وايجاد حلول لقضية المستوطنات الإسرائيلية. وفي المقابل فقد كان موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بيغن متشدداً ورافضاً لأية تنازلات؛ حيث رفض مشروع السادات بشكل قاطع، كما رفض إعطاء سكان الضفة الغربية وقطاع غزة أي إشراف على الشؤون الخاصة، وتمسك بالمستوطنات في سيناء، كما ربط بيغن موافقته على أي قضية تتعلق بالتسوية بموافقة أعضاء الكنيست أولاً. (الوثائق الفلسطينية، 1975، ص452)
وبسبب التشدد الإسرائيلي في المفاوضات مع الوفد المصري، فقد أعلن الرئيس السادات لمرافقيه أنه قرر الانسحاب من كامب ديفيد، فنصحه وزير الخارجية الأمريكي سايروس فانس بأن يلتقي الرئيس الأمريكي جيمي كارتر على انفراد، وبعد أن اجتمع الرئيسان مدة نصف ساعة خرج بعدها السادات قائلا للوفد المصري ” سأوقع على أي شيء يقترحه الرئيس كارتر دون أن أقرأه” وقد حاول وزير الخارجية المصري محمد ابراهيم كامل اقناعه بعدم قبول المشروع الأمريكي لأنه هو في ذاته مشروع إسرائيلي، ولكنه لم يجد اذاناً صاغية من السادات فقدم استقالته في كامب ديفيد وقبلها السادات. (كامل، 1987م، ص52)
ونتيجة لتلك التنازلات المصرية الكبيرة، فقد وقع الرئيس السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن على اتفاقية كامب ديفيد الأولى بتاريخ 17 أيلول 1978 وبإشراف الرئيس الأمريكي كارتر.
وفي تاريخ 26 اذار 1979م وبعد مباحثات كامب ديفيد وقعت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في البيت الأبيض في واشنطن، وقعها عن الجانب المصري الرئيس المصري أنور السادات وعن الجانب الإسرائيلي رئيس الوزراء مناحيم بيغن، وقد تضمنت المعادة مقدمة وتسعة مواد مع ثلاثة ملاحق وخرائط ملحقة بالاتفاقية تتعلق بالحدود الدولية وخطوط المناطق والخطوط والمناطق السارية عند انسحاب إسرائيل إلى خط العريش ومراحله وملحق بخريطة الحدود الدولية.
الفرع الثاني- أبرز ما تضمنته اتفاقية كامب ديفيد
تتكون اتفاقيتي كامب ديفيد من وثيقتين:
الوثيقة الأولى: هي عبارة عن إطار السلام في الشرق الأوسط، وشملت على مقدمة توضيحية، لتحقيق السلام على أساس قراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 ورقم338، ونظام إقرار مبدأ الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووضع الترتيبات لفترة انتقالية، وكان من أبرز ما احتوته تلك الوثيقة ما يلي: (جاد، 1988م، ص124)
أ- مبادئ عامة تحتوي على المبادئ التي تحكم تسوية النزاع في الشرق الأوسط تسوية سلمية وعادلة وشاملة.
ب- أسس مشتركة تحتوي على المبادئ التي تحكم معاهدات السلام بين إسرائيل وكل دولة من الدول العربية التي ستقبل ابرامها معها.
ج- أسس خاصة تتضمن وضع تصور للأسلوب الذي يمكن به تسوية المشكلة الفلسطينية من ناحية واجراء التسوية مع مصر من ناحية أخرى.
الوثيقة الثانية: وهي عبارة عن إطار الاتفاق لإبرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وهي تحتوي على مجموعة من المبادئ والأسس التي تحكم العلاقات بين الطرفين، كما تشمل على مجموعة من المبادئ التي على أساسها سيتم التفاوض بين الطرفين من أجل إبرام معاهدة السلام في غضون ثلاثة أشهر من توقيع هذا الإطار، وفيما يلي أهم الجوانب التي تضمنتها تلك المعاهدة) :اتفاقية كامب ديفيد، 1979م)
أ- تبادل الاعتراف وبدء العلاقات السلمية بين البلدين. وتحقيقاً لهذا الجانب وافق الطرفان على انهاء حالة الحرب بينهما، والاعتراف بحدود كل منهما من قبل الاخر، كما وافق الطرفان على تطبيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي فيما بينهما، وتأسيس علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية كاملة بين بلديهما، والاعتراف بحق كل منهما باستخدام المياه والممرات الدولية، واللجوء إلى الحلول السلمية لحل خلافتهما. (اتفاقية كامب ديفيد، 1979م)
ب- تعهدت إسرائيل بموجب تلك المعاهدة بالانسحاب من صحراء سيناء المصرية فيما لا يضار بموضوع قطاع غزة المحتل والذي كان تحت الإدارة المصرية قبل الاحتلال في عام 1967م.
ج- أوجبت المعاهدة تحقيق علاقات عادية بين الطرفين، ويشمل ذلك اعترافاً كاملاً بعلاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية.
د- ضرورة اقامة ترتيبات أمنية متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات ومراقبين من الأمم المتحدة وتمركز قوات الامم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول، وان سحب هذه القوات يتم بموافقة مجلس الأمن الدولي بما في ذلك موافقة الأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ه- نصت المعاهدة على ضمان عبور السفن الإسرائيلية لقناة السويس واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات دولية.
و- وضعت الاتفاقية شروطاً على سيادة مصر على سيناء بعد عودتها اليها بتحفظات على توزيع الجنود، كما تضمنت الاتفاقية شروطاً قاسية على مدى تحرك الجيش المصري وقواته في سيناء فحضرت مثلاً استخدام المطارات الجوية التي يخليها الإسرائيليون قرب العريش وشرم الشيخ على الأغراض السلمية فقط. (جاد، 1988م، ص164)
ز- ربطت مواد معاهدة السلام بعض المواضيع بنصوص ” إطار كامب ديفيد للسلام” وبعض الظروف الدولية الأخرى ومن بين هذه المواضيع:
1. وضع قطاع غزة المشار إليه في المادة الثانية من المعاهدة الذي ربط بتأسيس الإدارة المحلية في الضفة الغربية، وكما بحث في الإطار؛ وعليه فإن تنفيذ المادة الثانية من المعاهدة يرتبط عضوياً بالتنفيذ الكامل لمشروع الإدارة المحلية، وتقرير مصير المناطق التي ستخضع لتلك الإدارة بشكل نهائي.
2. ربط حق الدفاع عن النفس المعروف دولياً بالمادة 103من ميثاق الأمم المتحدة. فقد نصت الفقرة الخامسة من المادة السادسة من المعاهدة على أنه: ” مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، في حال وجود تناقض بين التزامات الطرفين بموجب هذه المعاهدة وأية التزامات أخرى فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة سوف تكون ملزمة ونافذة
ومن خلال مطالعة نصوص اتفاقية كامب ديفيد فإن الباحث يرى بأن تلك الاتفاقية قد صيغت بطريقة تتلاءم مع الخطط والأهداف المستقبلية للولايات المتحدة، ولإسرائيل، كما هدفت المعاهدة إلى العمل على تقييد مصر وعزلها عن الجسد العربي، وكانت تلك الصيغة محكمة وواضحة فيما يختص بالالتزامات الواجب تنفيذها من قبل الإدارة المصرية، إلا أنها كانت مبهمة فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي.
والجدير بالملاحظة أن نصوص معاهدة كامب ديفيد ربطت ربطاً وثيقاً بين عملية الانسحاب وبين التطبيع الكامل بين مصر وإسرائيل، وبذلك كانت مسألة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، غير مرتبط بالقانون الدولي، المتمثل بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة حسب ما جاء في القرار (242) وإنما كانت مكافأة لإسرائيل بالتطبيع الكامل معها؛ لانسحابها من سيناء، وذلك أوهم العالم بأن الحرب التي خاضتها إسرائيل عام 1967م كانت حرباً دفاعية وليس احتلالية. (مطر، 2012م، ص60)
ومن الواضح أن معاهدة كامب ديفيد تضمنت التزامات واجب تنفيذها من الجانب المصري في فترة زمنية قريبة، بعد توقيع المعاهدة، على سبيل المثال: ” تنهي مصر حالة الحرب بمجرد تبادل الوثائق، وإقامة العلاقات الودية، فتح قناة السويس، وفتح الحدود المصرية أمام السيارات الإسرائيلية، … ” أما المتعلقة بإسرائيل فقد كانت المدة طويلة، حيث أعطت المعاهدة إسرائيل مدة ثلاث سنوات للانسحاب من سيناء، وخمس سنوات للفترة الانتقالية، وكان الهدف الإسرائيلي من طول المدة حتى تنشأ الولايات المتحدة لها مطارات في النقب. (مطر، 2012م، ص63)
المطلب الثاني- أبرز نقاط عدم التكافؤ في اتفاقية كامب ديفيد.
باستقراء أحكام معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، نجدها قد نصت على الانسحاب من جميع الأراضي المصرية المحتلة في مقابل إقامة السلام مع إسرائيل، ومع ذلك نجد ما يستحق البحث والنظر في خصوص مبدأ عدم التكافؤ بشأن عدم التعادل في الالتزامات وعدم المساواة في مبدأ السيادة.
في هذا المطلب سيتطرق الباحث إلى أبرز نقاط عدم التكافؤ المنصوص عليها في اتفاقية كامب ديفيد، حيث سيوضح في الفرع الأول أوجه عدم التكافؤ في الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في المعاهدة، كما سيبين في الفرع الثاني مخالفة المعاهدة للقواعد الأمرة في القانون الدولي.
الفرع الأول- عدم التكافؤ في الترتيبات الأمنية الواردة في المعاهدة
نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من معاهدة كامب ديفيد على أنه: ” بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبون من الأمم المتحدة. وهذه الترتيبات موضحة تفصيلاً من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول، وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان “
وقد نصت الفقرة الثانية على أنه: ” يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول من الاتفاقية، ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب أولئك الأفراد، وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الامن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك “
يتبين من النصوص السابقة أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل تضمنت العديد من الأحكام الجائرة بحق الجانب المصري، مقابل امتيازات استفاد منها الجانب الإسرائيلي؛ حيث رتبت الاتفاقية في مواجهة الجانب المصري تدابير أمنية متشددة انصرفت في جانب منها إلى نزع سلاح ثلثي شبه جزيرة سيناء. والمتأمل في نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، يجد أنها وضعت ترتيبات أمنية متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية والإسرائيلية، الأمر الذي يجعلنا نقول أن المادة جاءت متكافئة للطرفين؛ إلا أن ذلك الافتراض ليس له وجود على أرض الواقع؛ كون أن البروتوكول الأول الملحق بمعاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، نص على ترتيبات أمنية رجحت بموجبها كفة إسرائيل على حساب السيادة المصرية. (عتلم، 2002م، ص86)
ويظهر عدم التكافؤ جلي وواضح في الالتزامات التي رتبتها المواد السابقة؛ حيث أصبحت مصر بموجب تلك الأحكام غير قادرة على الدفاع عن نفسها وأراضيها في سيناء، وأصبحت سيادتها العسكرية على أراضي سيناء مقيدة بشكل كبير؛ كون تلك النصوص أدت إلى نزع سلاح ثلثي سيناء، وتقييد عدد القوات المصرية المتواجدة في الثلث الباقي، ومنع إنشاء أي مطارات أو موانئ عسكرية في تلك المناطق. كما أنه بموجب المواد السابقة فقد أصبحت منطقة سيناء منطقة محتلة بشكل دائم من قبل القوات الأجنبية، ولا يجوز لمصر أن تطالب بسحب القوات الأجنبية المتواجدة في تلك المناطق إلا بعد موافقة أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وهو ما يعني التدخل في السيادة المصرية بشكل واضح.
إن من يطلع على المواد رقم (2، 3، 4، 5) من البروتوكول الأمني الأول الملحق بمعاهدة السلام، يلاحظ بشكل كبير حجم الاعتداء الذي لحق بمبدأ التكافؤ فيما يتعلق بتبادل التسليح المصري – الإسرائيلي، حيث إن غالبية الأحكام والإجراءات الواردة في تلك النصوص كانت لصالح إسرائيل، وتنقص من السيادة المصرية على أراضيها. (عتلم، 2002م، ص92)
والجدير بالإشارة إلى أن تلك التدابير الأمنية المنصوص عليها في معاهدة السلام كانت مستساغة وفق قواعد القانون الدولي التقليدي؛ وكانت تلجأ الدول المنتصرة في النزاعات إلى تضمين معاهدات السلام أحكام خاصة في شأن الضمانات الدولية؛ بهدف كفالة استتباب الحالة القانونية التي قد رسختها الدول المنتصرة في إطار علاقتها بخصومها؛ والملاحظ أن تلك الفكرة هي ما تعبر عنه نصوص المادة الرابعة من معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية؛ كون أن المحصلة النهائية لنصوص المعاهدة فيما يتعلق بالتدابير الامنية هو اعتماد إجراءات لنزع سلاح الجيش المصري من سيناء؛ إلا أنه لم يعد ما سبق مستساغ وفق قواعد وأحكام القانون الدولي المعاصر، وما قد استتبعه من صيرورة مبدأ المساواة بين الدول الذي نص عليه ميثاق الامم المتحدة؛ حيث أصبح الاضطلاع باعتماد إجراءات النزع الكلي أو الجزئي للتسليح غير متصور إلا على أساس التكافؤ بين أطراف النزاعات المسلحة الدولية. (عتلم، 2002م، ص19)
وبناء على ما سبق، فإن الباحث يرى أن ما تضمنته معاهدة كامب ديفيد وخاصة في المادة الرابعة منها من مساس بالسيادة المصرية على أراضيها، ومياهها الإقليمية، وأجوائها، ومن القيود الشديدة التي تخل بالأمن القومي المصري، يجعل تلك المعاهدة نموذجاً صارخاً للمعاهدات غير المتكافئة.
الفرع الثاني- غياب مبدأ التكافؤ من معاهدة كامب ديفيد بسبب مخالفتها للقواعد الامرة في القانون الدولي:
وضح الباحث في المطلب السابق أن المعاهدات غير المتكافئة تقوم طبيعتها على أساس إهدار مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، وتكريس الأوضاع الاستعمارية، وإغفال حق تقرير المصير؛ كما بينا أنه حتى تكون المعاهدة متكافئة ومشروع فيجب ألا يتعارض موضوع المعاهدة مع قاعدة امرة من قواعد القانون الدولي؛ وعليه فتكون المعاهدات غير المتكافئة معاهدات غير مشروعة كون أن فكرتها الأساسية تخالف العديد من القواعد الأمرة.
ومن خلال الاطلاع على نصوص معاهدة كامب ديفيد فإن الباحث يرى بأنه يوجد العديد من النصوص داخل تلك المعاهدة تخالف القواعد الامرة في القانون الدولي، الأمر الذي يجعلها معاهدة غير مشروعة وغير متكافئة، ومن تلك الأمور ما يلي:
أولاً- الفشل في مراعاة مبدأ تقرير المصير:
فشلت معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية في مراعاة مبدأ تقرير المصير، حيث حدد إطار كامب ديفيد مضمون تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وعند تمحيص هذا المضمون على ضوء السوابق في القانون الدولي، يتبين أن شروط كامب ديفيد تبتعد بشكل حاد، فيما يتعلق بتقرير المصير؛ كون أن الاتفاقية لا تعترف بالسيادة الفلسطينية على الاقليم المشمول بالحكم الذاتي.
إن الحكم الذاتي الذي جاء في نصوص كامب ديفيد لا يدل مطلقاً على أي شكل من أشكال تقرير المصير، حيث يرى الباحث أن الوضع السياسي والمدني للسكان في الأراضي المحتلة، كما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف، أفضل بكثير من حيث الحماية القانونية من الوضع تحت الاحتلال بالحكم الذاتي المقترح بموجب اتفاقيات كامب ديفيد.
إن عدم ضمان حق تقرير المصير للفلسطينيين في نصوص اتفاقية كامب ديفيد، ومخالفة الاتفاقية للمبادئ القانونية المنظمة لهذا الحق، يثير الشكوك حول حسن نية أطراف اتفاقيات كامب ديفيد، وان فشلهم في تسوية القضايا الأساسية للصراع، وتركها للمفاوضات المقبلة، يشير بشكل واضح إلى الرغبة في التوصل إلى اتفاقية هزيلة وصورية. وبالإضافة لذلك فإن الفشل في التوصل إلى اعلان مبادئ المفاوضات المقبلة، يعني أن إسرائيل سوف تبقى متمتعة بتفوقها كقوة محتلة للأراضي العربية؛ وهذا بطبيعة الحال يدل دلالة واضحة على أن تقرير المصير للفلسطينيين لم يكن قط ليعتبر مادة للمفاوضات من قبل الحكومة الإسرائيلية. (الرفاعي، 1984م، ص88)
ثانياً- مخالفة المبادئ الأساسية للقانون الدولي:
تتضمن معظم اتفاقيات السلام نصوصاً تتعلق بمراعاة القانون الدولي، وحماية حقوق الإنسان، من قبل الدول الأطراف لتلك الاتفاقية. والملاحظ أن اتفاقية كامب ديفيد لم تتضمن تلك المبادئ، حيث إن الاهتمام الرئيسي للأطراف كان منصباً بشكل واضح على التوصل إلى إطار سياسي، يمكن الاستناد عليه والتوصل إلى حلول سياسية.
إن من المبادئ الرئيسية المكفولة بالقانون الدولي والتي تجاهلتها اتفاقية كامب ديفيد مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة؛ حيث يشكل مبدأ قانوني أساسي تضمنه ميثاق الأمم المتحدة، ويعني هذا المبدأ أنه يجب على القوة المحتلة أن تعلن نيتها لسحب قواتها من الارض المحتلة لدى التوصل إلى اتفاقية سلام مع الأطراف المعنية بالنزاع المسلح. لكن إطار كامب ديفيد لم يتضمن اعلاناً يتعلق بتطبيق هذا المبدأ. (الرفاعي، 1984م، ص88)
المطلب الثالث- تعديل أو إنهاء معاهدة كامب ديفيد بسبب عدم تكافئها.
تسعى الدول الضعيفة التي قامت بإبرام المعاهدات غير المتكافئة إلى التخلص من الالتزامات الجائرة المفروض عليها بموجب تلك المعاهدات، وذلك عن طريق تعديل بنود تلك الاتفاقيات أو إنهاء الاتفاقية، وتعتمد الدول في ذلك على التمسك بالقواعد التي تتعلق بعيوب الإرادة، فيجوز للدول الاحتجاج بأن المعاهدات غير متكافئة دون أن تكون قد وقعت في غلط أو تدليس، أو ذهبت ضحية فساد ممثلها، أو مورس ضدها إكراه، وذلك عن طريق الاحتجاج بمبدأ تغير الظروف.
ومن المعروف أن الكثير من المعاهدات الدولية إنما تبرم بالنظر لظروف واقعية معنية ومن المتصور أن تتغير هذه الظروف على نحو يجعل من شأن تنفيذ المعاهدة المساس بمصالح البعض من الدول المتعاقدة، وفي هذه الحالة فإن الفقه الدولي قد استقر على الأخذ بفكرة تغير الظروف وإمكانية تعديل هذه المعاهدة.
وقد أحاطت اتفاقية فيينا نظرية تغير الظروف بالعديد من الضوابط التي تجعل من الصعوبة بمكان الاحتجاج بها كأساس لانقضاء أو إيقاف أو الانسحاب من المعاهدة، حيث اشترطت الفقرة الأولى من المادة (62) من الاتفاقية لجواز الاعتداد بالتغيير في الظروف شرطين وهما:
أ- أن يكون التغيير في الظروف التي أبرمت المعاهدة في ظلها جوهرياً أي من شأنه أن يعدل بصورة جذرية في مدى الالتزامات التي ما زال من الواجب القيام بها بموجب المعاهدة.
ب- عدم توقع أطراف المعاهدة للتغير في الظروف وأن يكون وجود هذه الظروف سبباً رئيسياً لرضا الأطراف بالالتزام بالمعاهدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز الاستناد إلى التغيير الجوهري في الظروف كسبب لإنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها في حالة كانت المعاهدة منشئة لحدود، أو إذا كان التغيير الجوهري نتيجة إخلال الطرف بالتزام طبقاً للمعاهدة أو بأي التزام دولي لأي طرف اخر في المعاهدة.
وقد استخدمت الدول هذه النظرية في انهاء المعاهدات الدولية استناداً إلى تغير الأوضاع، فقد قامت تركيا عام 1914 بإنهاء معاهدة الامتيازات، كما قامت الصين عام 1926 بإنهاء معاهدة الصداقة والتجارة في الملاحة مع بلجيكا المبرمة عام 1825 بعد أن فشلت الصين في إعادة النظر في المعاهدة، وكذلك ألغت مصر المعاهدة المبرمة بينها وبين بريطانيا عام 1936م بشأن الضمانات والتحالف وسلامة أراضيها حيث قامت عام 1951 بإلغائها بالإرادة المفردة. (عبد الرزاق، 2018م، ص82)
ومما لا شك فيه أن معاهدة كامب ديفيد هي إحدى تطبيقات نظرية تغير الظروف، حيث إن المعاهدة أقرت أوضاع وترتيبات أمنية غير متكافئة في منطقة سيناء، أدت إلى الانتقاص من السيادة المصرية، وبما أن الظروف قد تغيرت في تلك المنطقة، فتستطيع مصر أن تطالب بتطبيق قاعدة تغير الظروف وتحتج بها لتعديل المعاهدة او الغاءها. ومن أبرز الظروف التي تغيرت والتي تتيح لمصر مبرر قوي لأن تطلب من إسرائيل تعديل الجزء المتعلق بترتيبات الأمن؛ الاختراقات الإسرائيلية المتكررة للأراضي المصرية بحجة ملاحقة مسلحين. كما أن من ضمن الظروف التي تغيرت انتشار الفوضى في سيناء بسبب محدودية عدد الجنود المصرين المسموح تواجدهم في تلك المنطقة، والحل لتلك المشكلة يكون من خلال تعديل بنود المعاهدة الخاصة بالحدود بمعنى أن يتم زيادة وجود الجيش المصري وفقاً لمبدأ الظروف الطارئة المعروف في القانون الدولي، الذي يؤكد على الحق في طلب تعديل المعاهدة ويكون التعديل باتفاق الطرفين، فإن رفض الطرف الأخر طلب التعديل نلجأ للتحكيم الدولي ([4]). (النقيب، 2017م، ص105)
ويرى الباحث أن مصر تستطيع أن تعدل في بنود معاهدة السلام مع إسرائيل، ويجوز لها أن تطلب تعديل البنود المتعلقة بالترتيبات الأمنية كون أنها غير متكافئة، وكون أن الظروف قد تغيرت عن الوقت الذي أبرمت فيه تلك المعاهدة، خاصة أن ما يحدث في سيناء في الوقت الراهن فرصة تاريخية لتتقدم مصر بطلب لتعديل هذا الجزء من الاتفاقية استناداً لنص المادة الرابعة منها، وفي حال رفضت إسرائيل التفاوض على تعديل المعاهدة، فيكون من حق مصر أن تلجأ إلى التحكيم الدولي بموجب نص المادة السابعة من معاهدة كامب ديفيد.
جاءت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات، نذكرها على النحو الآتي:
أولاً- خلاصة بأهم النتائج :
1. التكافؤ في المعاهدات يجعل من المراكز التعاقدية للدول الموقعة على المعاهدة مراكز متوازنة، وتكون الالتزامات والحقوق فيها متعادلة؛ الأمر الذي يحفظ المصالح الحيوية لأطراف المعاهدة، ويسمح للطرف الأضعف في المعاهدة من الافصاح عن ارادته الحقيقية.
2. تناول الفقه الدولي مبدأ التكافؤ وموضوع المعاهدات غير المتكافئة، وقد استند إلى تكيفها إلى عدة معايير، أبرزها معيار الإكراه، ومعيار التعادل بين الأطراف، ومعيار احترام مبدأ المساواة بين الدول.
3. إن المعاهدة التي تبرم تحت الإكراه سواء أكان الإكراه على ممثل الدولة، أم على الدولة ذاتها، هي معاهدة باطلة بطلاناً مطلقاً منذ لحظة إبرامه.
4. يمكن الاستناد لأحكام البطلان الواردة في اتفاقية فيينا في المواد ” 52″، “53” في إلغاء أو تعديل كثير من الاتفاقيات غير المتكافئة، خاصة تلك الاتفاقيات التي يتم عقدها بين الدول الكبرى والدول النامية، والتي يشكل عنصر الضغط السياسي والاقتصادي جانباً هاماً في إذعان هذه الدول لإبرامها، وبالتالي فمن حق الدول النامية الاستناد لهذه النظرية لإبطال الاتفاقيات التي أبرمت نتيجة للإكراه.
5. خلت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م من مصطلح المعاهدات غير المتكافئة؛ ولم تنص نصوص الاتفاقية على حالة البطلان في حال غياب مبدأ التكافؤ عن الاتفاقية وعدم مراعاة الدولة لذلك المبدأ.
6. تضمنت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل العديد من الأحكام الجائرة بحق الجانب المصري، مقابل امتيازات استفاد منها الجانب الإسرائيلي؛ حيث رتبت الاتفاقية في مواجهة الجانب المصري تدابير أمنية متشددة انصرفت في جانب منها إلى نزع سلاح ثلثي شبه جزيرة سيناء.
7. يظهر عدم التكافؤ جلي وواضح في الالتزامات التي رتبتها اتفاقية كامب ديفيد على جمهورية مصر العربية، حيث أصبحت مصر بموجب تلك الاتفاقية غير قادرة على الدفاع عن نفسها وأراضيها في سيناء، وأصبحت سيادتها العسكرية على أراضي سيناء مقيدة بشكل كبير. كما أنه بموجب الاتفاقية فقد أصبحت منطقة سيناء منطقة محتلة بشكل دائم من قبل القوات الأجنبية، ولا يجوز لمصر أن تطالب بسحب القوات الأجنبية المتواجدة في تلك المناطق إلا بعد موافقة أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وهو ما يعني التدخل في السيادة المصرية بشكل واضح.
8. تعتبر معاهدة كامب ديفيد إحدى تطبيقات نظرية تغير الظروف، حيث إن المعاهدة أقرت أوضاع وترتيبات أمنية غير متكافئة في منطقة سيناء، أدت إلى الانتقاص من السيادة المصرية، وبما أن الظروف قد تغيرت في تلك المنطقة، فتستطيع مصر أن تطالب بتطبيق قاعدة تغير الظروف وتحتج بها لتعديل المعاهدة او الغاءها.
ثانياً- التوصيات والمقترحات.
1. ضرورة إضافة نص إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م لاعتماد معيار عدم التكافؤ كأحد أسباب بطلان المعاهدات.
2. ضرورة إلغاء الاستثناء الوارد في المادة 62 من اتفاقية فيينا الذي يمنع تطبيق نظرية الظروف على اتفاقيات الحدود والتنازلات عن الاقليم؛ كون هذا الاستثناء يحافظ على الاتفاقيات الاستعمارية الباطلة ويعارض حق تقرير المصير بالنسبة لسكان تلك الأقاليم.
3. أوصي جمهورية مصر العربية بالاحتجاج بنظرية تغير الظروف إزاء اتفاقية كامب ديفيد؛ وذلك لإلغائها أو تعديل أحكامها بما يتوافق مع المصالح الأمنية المصرية.
قائمة المراجع.
أولاً- المراجع العامة
– أبو هيف، علي صادق، (1995م) القانون الدولي العام، النظريات والمبادئ العامة، منشأة معارف الإسكندرية.
– جعفر، عبد السلام، (1990م) المنظمات الدولية: دراسة فقهية وتأصيلية للنظرية العامة للتنظيم الدولي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الاقليمية، الطبعة السادسة، دار النهضة العربية، مصر.
– شكري، محمد، (1953م) مدخل إلى القانون الدولي العام، مكتبة النهضة، مصر.
– عبد الحميد، محمد و حسين، مصطفى، (1988م) القانون الدولي العام، الدار الجامعية، بيروت.
– عثمان، أحمد، (1963م) مبدأ التنظيم الدولي لإدارة المستعمرات، دار النهضة، القاهرة.
– الغنيمي، محمد، (1982م) الوسيط في قانون السلام، منشأة المعارف، الاسكندرية.
– وثائق الفلسطينية، الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1975، بيروت، 1976.
ثانياً- المراجع المتخصصة.
– اسماعيل، محمد، (2011م) الضمانات الدولية لتنفيذ معاهدات السلام العربية – الإسرائيلية، مكتبة جريرة، القاهرة.
– الجشعمي، خالد، (2014م) المعاهدات الدولية والسيادة الوطنية، منشورات زين حقوقية.
– رمضان، عصام صادق، (1978م) المعاهدات غير المتكافئة في القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة.
– الرفاعي، محمد، (1984م) اتفاقيات السلم المصرية الإسرائيلية في نظر القانون الدولي، الطبعة الأولى، دار الجليل للنشر، عمان.
– الطيار، عماد، (2000م) المعاهدات الدولية شروطها وأحكامها في الشريعة والقانون، دار الحافظ، دمشق، 2000م.
ثالثاً- الرسائل العلمية.
– أبو هادي، دبيل، (2013م) قانون المعاهدات الدولية وفق الفقه والسوابق والتشريع الدولي بالتركيز على تحفظات اليمن والسودان بشأن بعض المعاهدات الدولية، رسالة دكتوراة، جامعة النيلين، السودان.
– عبد الرزاق، عمر، الاليات المتاحة لإنهاء المعاهدات غير المتكافئة في القانون الدولي العام، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الإسراء، 2018م.
– مطر، زياد، (2012م) اتفاقية كامب ديفيد المصرية- الإسرائيلية وأثرها على القضية الفلسطينية 1978- 1993م، رسالة ماجستير، كلية الآداب، الجامعة الاسلامية، غزة.
– مريكب، خيري، (2006م) الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي (غزة- أريحا) دراسة قانونية في ضوء قواعد القانون الدولي العام، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة.
رابعاً- الدوريات والمجلات العلمية.
– جاد، محسن علي، (1988م) الوضع القانوني الراهن لاتفاقيتي كامب ديفيد سنة 1978م، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 44.
– سميرس، لطيفة، (1989م) المعاهدات اللامتكافئة في القرن 19: المغرب نموذجاً، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، العدد10، المغرب.
– الطراونة، مخلد، (2005م) اثار المعاهدات الدولية في ضوء قواعد ومبادئ القانون الدولي، مجلة الحقوق، المجلد الثاني، العدد الأول.
– عتلم، حازم، (2002م) قاعدة تغير الظروف في ظل معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، المجلد 44، 2002م.
– عبيدات، ميسون (2014م) الامتيازات الأجنبية وأثارها على الدولة العثمانية، ورقة قدمت لمؤتمر التحولات الفكرية في العالم الاسلامي، الأردن.
– مصطفى، نور، (2016م) مدى التزام الدول الكبرى بتطبيق المعاهدات الدولية الشارعة في مواجهة دول العالم الثالث: دراسة تطبيقية على الدول العربية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 72.
– النقيب، نادية، (2017م) مدى مشروعية الاتفاقيات غير المتكافئة في القانون الدولي، مجلة السعيد للعلوم الإنسانية والتطبيقية، العدد1.
([1]) من الأمثلة على تلك المعاهدات: المعاهدات التي عقدتها بريطانيا مع أمراء ومشايخ الخليج العربي في أواخر القرن التاسع عشر.
([2]) يقصد بالقاعدة الامرة: هي قاعدة لا يجوز الإخلال بها، أو الاتفاق على مخالفتها، ولا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع، أي قاعدة امرة أخرى.
([3]) جاء في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة أنه: ” الشعوب والأمم تؤكد ثقتها من جديد في المساواة والحقوق بين الأمم الصغيرة والكبيرة”
([4]) النقيب، نادية، مرجع سابق، ص 105.