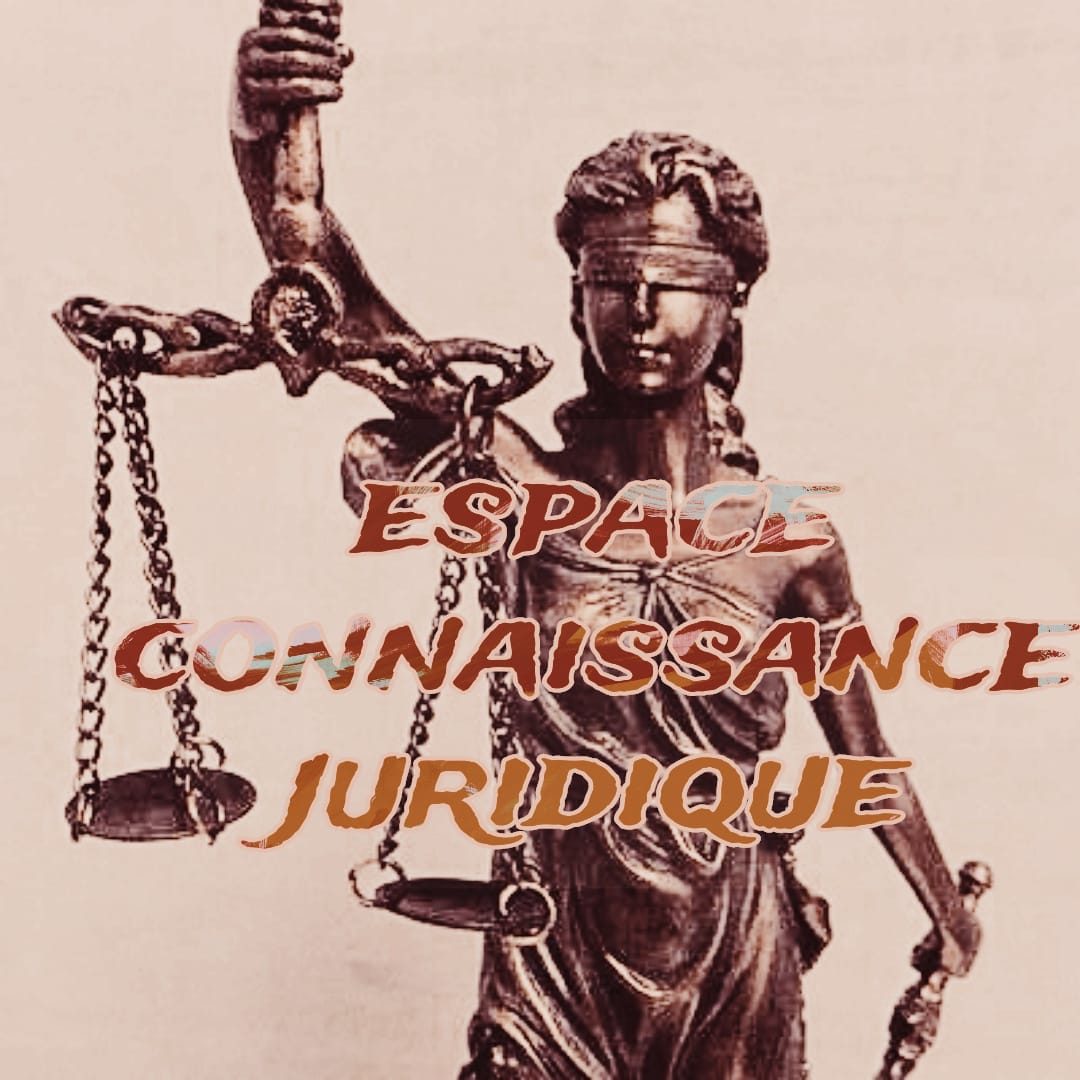أحمد أنوار ناجي
أستاذ باحث بكلية العلوم
القانونية والاقتصادية والاجتماعية
بفاس
مقدمة:
تعرف الوسائل البديلة لحل النزاعات اهتماما متزايدا على صعيد مختلف الأنظمة القانونية والقضائية، وذلك لما توفره هذه الأخيرة من مرونة وسرعة في البت والحفاظ على السرية وما تضمنه من مشاركة الأطراف في إيجاد الحلول لمنازعاتهم، وهي بذلك تحتل مكانة بارزة في الفكر القانوني والاقتصادي، ويتعرض موضوع مداخلتي هاته لإحدى القضايا المهمة التي تشغل جمهور المتخصصين من قانونيين واقتصاديين ومنتجين ومستهلكين، فطابع اختيار هذه الدراسة التي تتمحور حول الوساطة في منازعات الملكية الفكرية لم يكن وليد الصدفة فمن المبررات الأساسية التي دفعتني إلى البحث في هذا الموضوع يمكن إيجازها في الآتي:
- التوجه الجديد الذي عرفه العالم والمتجلي في الاهتمام المتزايد بالوسائل الودية لفض النزاعات على صعيد مختلف الأنظمة القانونية والقضائية.
- حداثة الموضوع فلا يخفى على الجميع أن الوساطة في منازعات الملكية الفكرية في ظل المستجدات الجديدة من اتفاقيات دولية وثورة علمية وتكنولوجية وكثرة التقليد والتزييف جعلت لهذا الموضوع بريقا خاصة في البحث.
- أنه لأول مرة يعنى المشرع المغربي بتنظيم الوساطة الاتفاقية من خلال القانون 05-08.
- أن هذه المداخلة تهدف إقامة العلاقة بين الوساطة كوسيلة مقبولة لتسوية المنازعات وخصوصية تطبيقها في مجال منازعات الملكية الفكرية، مما سيسمح بتقييم حقيقي للموضوع ككل.
هذه الاعتبارات كلها دفعتنا إلى التركيز على هذا الموضوع ومدى أهميته وكان اختيارنا له من زاوية أخرى أنه لم يحظ بالدراسة والتأصيل الكافيين.
تبقى الإشارة على أنه أثناء إنجاز هذه الدراسة صادفتنا صعوبات متعددة بعضها ذات طابع منهجي، والبعض الآخر متصل بطبيعة الموضوع نفسه ونطاقه يمكن إجمالها فيما يلي:
- غياب شبه تام للأحكام القضائية الصادرة عن القضاء المغربي والقاضية بالتذييل بالصيغة التنفيذية في هذا المجال وهو أمر لم يساعدنا كثيرا طوال مراحل إنجاز هذا البحث، الأمر الذي يعقد مأمورية الباحث في هذا الموضوع.
لكن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء غياب مثل هذه الأحكام لا يعني عدم اهتمام أو اكتراث محاكمنا الموقرة بهذا الموضوع، بل إن ما يبرره هو حداثة الفكرة وعدم تصدي الأطراف للنزاعات المتعلقة بهذه الفكرة بعد.
- التطرق لقانون حقوق الملكية الفكرية بالشرع والتأصيل أمر دقيق وبالغ التعقيد، فهذا الموضوع مازال حديثا في مجال الدراسات القانونية والاقتصادية في معظم دول العالم كما أن هذه الحقوق قد اتسعت في العصر الحديث لتشمل مجالات جديدة لم تكن محل حماية من قبل، بالإضافة إلى أنها حقوق تتصف بالعالمية.
- أثار هذا البحث صعوبات إضافية أخرى تتصل بنطاقه إذ أنه بالنطر إلى خصوصيته التي تتمثل في كونه موضوع وثيق الصلة بالاقتصاد والاستثمار فقد وجدنا أنفسنا في الكثير من الأحيان أمام بحث يختلط فيه ما هو اقتصادي محض بما هو قانوني بحت، ولعل هذه الملاحظة تزداد اتضاحا إذا أدركنا بأن منازعات الملكية الفكرية هي أصلا قضية اقتصادية والعديد من الإشكاليات التي تطرحها لا يتسنى فهمها بدقة ما لم يتم الإلمام ببعض القضايا الاقتصادية عموما والصناعية منها على وجه الخصوص.
- أما الصعوبة الأخيرة والأهم التي صادفتنا أثناء إنجاز هذه الدراسة فتتصل بعدم وجود دراسات متخصصة تجمع بين موضوع حماية الملكية الفكرية والوساطة، فنحن لا ننكر بطبيعة الحال أنه توجد دراسات كثيرة في مجال الملكية الفكرية وفي مجال الوساطة، لكن ما نقصده هو الدراسات التي تجمع بين خصوصية المنازعة في مجال الملكية الفكرية ومدى إمكانية تطبيق الوساطة عليها.
لا حاجة للإشارة في هذا المقام إلى أن افتقار المكتبة القانونية الوطنية لأبحاث متخصصة حول هذا الموضوع الحساس يظل أمرا غير مفهوم في ظل العولمة واندماج المغرب في الاقتصاد العالمي مع ما يترتب عن ذلك من تحديات على مستوى المنافسة وقدرة المقاولات الوطنية على استيعاب التقنيات الجديدة في مجال الملكية الفكرية، وبالتالي الاستفادة من كافة مزايا وحسنات نظام الوساطة.
ولهذا وجدت من المناسب وحتى تعم الفائدة ويتخذ هذا البحث صفة الشمولية المطلوبة أن تكون خطة البحث على المنوال التالي:
المبحث الأول: نظام الوساطة كآلية جديدة لحل المنازعات
المطب الأول: تعريف نظام الوساطة كحل بديل لحل المنازعات
المطلب الثاني: اختلاف الوساطة عن بعض النظم المشابهة
المبحث الثاني: خصوصية الوساطة في منازعات الملكية الفكرية
المطب الأول: مدى قابلية منازعات الملكية الفكرية للوساطة
المطب الثاني: مدى فعالية هذه الوسيلة في حل هذه المنازعات
المبحث الأول: نظام الوساطة كآلية جديدة لحل المنازعات
كان القضاء مند القدم ولا يزال الوسيلة الأساسية لحل النزاعات، لكن مع تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلي والدولي أخذت تنشأ إلى جانب القضاء وسائل أخرى لحسم المنازعات، وبذلك ظهر التحكيم، بحيث لم يعد من المبالغة القول بأن التحكيم لم يعد وسيلة بديلة لحسم المنازعات المدنية والتجارية بل أصبح أو يكاد يصبح الوسيلة الأساسية لحسم منازعات التجارة الدولية.
وإلى جانب التحكيم ظهرت الوساطة وهذا الشكل من العدالة قديم جدا وهو أقدم من عدالة الدولة، واذا كانت الوساطة تتم في السابق بشكل بسيط قائم على إصلاح ذات البين ونابعة من العادات والتقاليد السائدة في المجتمع، كما حبذتها كل الديانات السماوية ([1]) وبذلك أخذ هذين الأسلوبين طريقهما ليصبحا أيضا من الوسائل البديلة لحسم النزاعات ([2])
وبذلك أصبحت الوساطة تمثل في الحاضر مهجة وغاية تسعى المجتمعات إلى تحقيقها وتشكل فعلا مؤثرا على صعيد التقاضي، فكان من الطبيعي أن تعمل الدول جاهدة لإيجاد إطار ملائم يضمن لهذه الوسائل تقنينها ثم تطبيقها لتكون بذلك أداة فاعلة لتحقيق وتثبيت العدالة وصيانة الحقوق، ولذلك لا يمكن لقانون في بلد كالمغرب أن يشد عن هذا التيار، وهو ما حدا بالمشرع المغربي إلى تنظيم نظام الوساطة عن طريق القانون رقم 05-08 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
ولذلك، فإننا سنتناول في هذا المبحث المقصود بالوساطة كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات، إذ لا بد من التعريف بهذا النظام من جميع جوانبه إذ كما يقول الأصوليون الحكم على الشيء فرع تصوره، في (مطلب أول)، على أساس أن نستعرض الاختلاف بين الوساطة والنظم المشابهة في (مطلب ثان).
المطلب الأول: تعريف الوساطة كوسيلة بديلة لحل المنازعات:
تدخل الوساطة ضمن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات أو ما يعرف بالعدالة الموازية (ADR Alternative Dispute Resolution)، أو الطرق المناسبة لفض المنازعات، كما تسمى في الوقت الحاضر (MARC) Modes Alternatives de Règlement des conflits، ويعبر عنها أحيانا “فض المنازعات” Dispute Resolution (DR)، وهي تلك الآليات التي يلجأ لها الأطراف عوضا عن القضاء العادي عند نشوء خلاف بينهم، بغية التوصل لحل لذلك الخلاف ([3]).
وانطلاقا من هذا المعنى يخرج التقاضي عن إطار هذا التعريف، فهو لا يعد وسيلة بديلة لحل الخلافات بل وسيلة أصيلة، إذ أن الأصل في الأطراف اللجوء إلى المحاكم ومحاولة حل الخلافات التي بينها عبر التقاضي في حال نشوء خلاف بينه.
وتنقسم طرق فض المنازعات الملائمة أو البديلة ADR إلى أقسام متعددة تختلف تبعا لأساس التقسيم، ولعل أفضل تقسيم لها هو تقسيمها من حيث درجة التدخل intervention من قبل طرف ثالث في النزاع، ووفق هذا التقسيم تنقسم هذه الطرق إلى: المفاوضات، الوساطة، التقييم الحيادي المبكر، التحكيم على أن ما يهم محور تدخلنا هو الوساطة.
وهذه الأخيرة هي مرحلة متقدمة من التفاوض تتم بمشاركة طرف ثالث (وسيط)، يعمل على تسهيل الحوار بين الطرفين المتنازعين ومساعدتهما على التوصل لتسوية، إذن فهي آلية تقوم على أساس تدخل شخص ثالث محايد في المفاوضات بين طرفين متخاصمين بحيث يعمل هذا المحايد عل تقريب وجهات النظر بين الطرفين وتسهيل التواصل بينهما وبالتالي مساعدتهما على إيجاد تسوية مناسبة لحكم النزاع ([4]).
إذن فبينما يتم حل الكثير من الخلافات عبر التفاوض المباشر بين الطرفين دون وجود الحاجة لوسيط، فإن كثيرا من المفاوضات قد تتعثر في مراحل مختلفة، أو أن حدة النزاع لا تسمح بوجود مفاوضات ابتداء بين الأطراف في بعض الأحيان الأمر الذي يحتم الاستعانة بوسيط للمساعدة في دفع عجلة التفاوض إلى الأمام وجسر الهوة بين الطرفين.
والوساطة عملية طوعية بطبيعتها ولا يجوز للوسيط اتخاذ قرار بات في أساس النزاع، بل إن دوره ينحصر في محاولة تقريب وجهات نظر الطرفين (أو الأطراف) وجسر الهوة بينها، وفي طرح الحلول البديلة أمامهم دون فرض أي منها عليهم ([5]).
فالأطراف هنا هم الذين يصنعون النتيجة فوظيفة الوسيط تقتصر على تيسير التواصل والتفاوض بين الطرفين لا التحكيم بينهم، وينتج عن ذلك نتيجة هامة من الناحية العملية، تتلخص في قابلية الاتفاقية الناشئة عن الوساطة للتطبيق من الأطراف بشكل تلقائي كونهم هم الذين توصلوا إليها بمحض إرادتهم ولم تفرض عليهم من الخارج ([6]).
واتفاق الوساطة يتخذ شكلين ([7]):
- شرط وساطة وينص عليه في الاتفاق الأصلي، يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يعرضوا على الوساطة النزاعات التي قد تنشأ عن الاتفاق المذكور (الفصل 327-61).
- عقد وساطة وذلك بعد نشوء النزاع، ويمكن إبرامه حتى أثناء مسطرة جارية أمام المحكمة (الفصل 327-59).
المطلب الثاني: اختلاف الوساطة عن بعض المنجزات المشابهة:
لقد أصبحت الوساطة تعرف إقبالا متزايدا، بحيث أصبح التحكيم بدوره لا يلجا إليه إلا بعد استنفاد طريق الوساطة([8])، وترجع فعالية الوساطة إلى أن هدفها ليس هو تحديد من يربح ومن يخسر فالطرفان معا رابحان، ولكن هدفها هو وضع حلول مبتكرة للنزاع بشكل لا يتوافر عند المحاكمة، فهي ترمي إلى حل النزاع أو تجنبه كما أنها تساعد على إعادة بناء العلاقات والحفاظ على استمراريتها في المستقبل، كما أن من آثارها ترسيخ ثقافة الحوار والتعايش والبعد عن الخصومة.
فهذه الخصوصيات والأدوار التي تلعبها الوساطة جعلتها تختلف عن بعض النظم المشابهة كالمفاوضات والتحكيم والدعوى القضائية.
فالمفاوضات أو التفاوض هو آلية لتسوية النزاع قائم على الحوار المباشر بين الطرفين المتنازعين سعيا لحل الخلاف، ولا يحتاج التفاوض إلى أي طرف ثالث، بل يعتمد على الحوار بين الطرفين مباشرة، أما الوساطة فتقتضي تدخل طرف ثالث يقوم بمهمة الوسيط.
أما التحكيم فإذا كان يشبه الوساطة في وجود طرف ثالث يعمل على حل النزاع إلا أنه يعتبر من حيث نتيجته ملزما، بحيث يملك المحكم أو هيئة التحكيم سلطة اتخاذ القرار في أساس النزاع والبت فيه، وهذا على خلاف الوسيط الذي لا يملك هذه السلطة. كما أن التحكيم متى اتفق عليه (قبل نشوء النزاع أو بعده) يصبح ملزما، ويتوجب على الأطراف السير به حتى نهاية إجراءاته وإصدار القرار المنهي للخصومة من خلاله. ويعتبر حكم التحكيم ملزما ويستوي مع القرار الصادر عن المحكمة إذا ما تم تذييله بالصيغة التنفيذية، فإما أن ينفد الطرف الصادر ضده طواعية والا سيتم تنفيذه جبرا. عكس ما عليه الأمر في الوساطة فالأطراف هنا هم الذين يصنعون النتيجة فوظيفة الوسيط تقتصر على تيسير التواصل والتفاوض بين الطرفين لا التحكيم بينهم، وينتج عن ذلك نتيجة هامة من الناحية العملية، تتلخص في قابلية الاتفاقية الناشئة عن الوساطة للتطبيق من الأطراف بشكل تلقائي كونهم هم الذين توصلوا إليها بمحض إرادتهم ولم تفرض عليهم من الخارج.
وبذلك إذا كان التحكيم يقوم على رد الحق إلى أصحابه، فإن الوساطة يهمها في المقام الأول المحافظة على المصالح المهنية للفرقاء التجاريين في الماضي والحاضر والمستقبل حيث أن الغرض منها يكمن في السعي إلى تجنب تأثير النزاع على العلاقات المستمرة بين الفرقاء.
أما أهم الفروق الأساسية بين الوساطة والدعوى القضائية فيمكن إيجازها فيما يلي:
- عندما يتقدم أحد الطرفين للقضاء، فإن الطرف الثاني يكون مجبرا على الحضور أمام المحكمة، في حين أن الوساطة اتفاقية وطوعية وغير ملزمة
- في التقاضي يكون الحكم القضائي ضروريا وملزما، وفي الوساطة لا تكون ملزمة، إلا إذا صدر قرار بتذييلها بالصيغة التنفيذية في حين أن عقد الوساطة يصبح ملزما في المجال التجاري بمجرد توقيعه من الطرفين
- التقاضي محكوم بعدد من الإجراءات والقوانين، ولا يمكن للأطراف خرق هذه الإجراءات والقوانين. في حين تكون في الوساطة للأطراف إمكانية الفصل في النزاع وفق قواعد العدل والإنصاف وعدم التقيد بالقوانين لذلك فالوساطة مرنة وغير محكومة بقواعد صارمة.
- يرتكز التقاضي على المجهود الذي يبذله المحامي وليس هناك مجال كبير للأطراف للحديث أمام المحكمة فجل المساطر بالمغرب كتابية، في حين أنه في الوساطة فإن التركيز يتم على الطرفين.
- في التقاضي هناك رابح وخاسر، أما الوساطة فالطرفان معا رابحان.
- يقطع التقاضي أمام المحاكم مدة طويلة في حين، قد يتم حل النزاع في الوساطة خلال أسابيع فقط.
المبحث الثاني: خصوصية الوساطة في منازعات الملكية الفكرية
أدت التطورات التي عرفتها الملكية الفكرية وعرفها الاقتصاد العالمي في الربع الأخير من القرن العشرين إلى ازدياد الأهمية التي تكتسيها الحماية الدولية لتلك الحقوق، فتعاظم الدور الاقتصادي الفاعل للملكية الفكرية على مستوى المبادلات الدولية في الزمن المعاصر زمن العولمة مما حدا بالمجتمع الدولي في سياق إرساء أسس النظام الاقتصادي العالمي الجديد، إلى وضع أسس نظام دولي جديد يكفل للمشاريع المالكة لحقوق الملكية الفكرية تأمين نقل حقيقي دون خوف من التعدي عليها ([9])، والولايات المتحدة هي أكبر دولة تعاني من خسائر كانت من المتوقع أن تكتسبها لولا وجود عمليات سرقة لملكيتها الفكرية بمقدار 2.8 مليون دولار، ولا شك أن هذا الرقم يعطي دافعا كبيرا لديها للبحث بشراسة عن توفير آليات حاكمة لحماية الملكية الفكرية ([10]).
ولهذا سعت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مفاوضات جولة أورجواي 1994/1986 إلى تدويل حماية حقوق الملكية الفكرية ونقلها من المستوى الإقليمي أو المحلي إلى المستوى العالمي بما يساعدها على استعادة نصيبها السوقي الذي تناقص من جراء التقليد المتبع بواسطة الغير.
مما تقدم، يمكن القول أن الدافع الرئيسي وراء إدخال الملكية الفكرية ضمن الإطار التجاري متعدد الأطراف هو الحد من الخسارة الناجمة عن عمليات التقليد.
وقد عني المجتمع الدولي بتنظيم حقوق الملكية الفكرية، فتوالت الاتفاقيات الدولية في هذا المضمار بداية من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (سنة 1883)، مرورا باتفاقية برن لحماية حق المؤلف (سنة 1886)، وانتهاء باتفاقية حقوقي الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة المعروفة اختصارا بالتربس هذه الأخيرة التي اهتمت بوضع آلية لفض النزاعات التي قد تحدث بين الدول بشأن مدى احترام مقتضيات الاتفاقية، فأحالت المادة 64 منها بشأن ذلك على ” مذكرة الاتفاق المتعلقة بالأحكام والمساطر المطبقة على النزاعات ([11]) الملحقة كذلك بمعاهدة مراكش المحدثة للمنظمة العالمية للتجارة([12]).
وبذلك أسندت مهمة الإشراف على تطبيق تلك الأحكام والمساطر إلى جهاز فض النزاعات.
وتأخذ مذكرة الاتفاق المتعلقة بالأحكام والمساطر المطبقة على النزاعات ” بمبدأ المصالحة الدولية كآلية أساسية لفض النزاعات بين الدول، أي تبدأ بالوساطة أولا ثم التحكيم ثانيا.
ولما كانت حماية حقوق الملكية الفكرية تقتضي توفير بنية تحتية قانونية فعالة، تكفل قيام إطار قانوني سليم لممارسة تلك الحقوق، وضمان حمايتها، ومواكبة تطورها، فقد عمل المشرع المغربي في إطار تحديث ترسانته القانونية وعصرنة وتدويل قواعد قانون الأعمال على مراجعة التشريع المعمول به في هذا الخصوص، والذي يعود لسنة 1916 فأصدر بذلك قانونين الأول حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 00-2 بتاريخ 15 فبراير 2000 ويتكون من 71 مادة، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 05-34الصادر في 14 فبراير 2006، والثاني حول الملكية الصناعية رقم 97-17 كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 05-31الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006.
*أما الأهداف المتوخاة من إصباغ حماية فعالة على هذا النظام فيمكن حصرها في الآتي:
- تشجيع الإبداع والابتكار
- الحد من انتشار تقليد المصنفات
- توفير الشروط المشجعة للاستثمار الوطني والأجنبي وتوفير المناخ الملائم لنقل التقنية والمعارف الحديثة.
- تعزيز الثقة بالنظام القانوني لحماية الملكية الفكرية.
وتنقسم حقوق الملكية الفكرية وفقا للتقسيم العادي إلى قسمين رئيسيين هما:
الملكية الصناعية، والملكية الفنية والأدبية
* الملكية الصناعية:
ومن أهم صور الملكية الصناعية براءات الاختراع، ونماذج المنفعة، والرسوم والنماذج الصناعية، والعلامات التجارية، والأسماء التجارية، والمؤشرات الجغرافية.
* الملكية الفنية والأدبية:
أما الملكية الفنية والأدبية فتشمل حقوق المؤلف وما يرتبط بها من حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة ويطلق عليها الحقوق المجاورة لحق المؤلف.
هذا وقد أدى ازدياد منازعات الملكية الفكرية وانتشارها بشكل مخيف خلال السنوات الخيرة إلى حدوث العديد من الآثار السلبية على اقتصاديات الدول الصناعية وهو ما حدى بالتشريعات الوطنية بإصدار قوانين أكثر صرامة وذلك حتى تستطيع فرض رقابة متشددة على أفعال التزييف والتقليد من ذلك مثلا أن الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت قانونا يعتبر التزييف الصناعي أو توزيع السلع المزيفة جريمة فدرالية يعاقب مرتكبها بغرامة ربع مليون دولار للأفراد، ومليون دولار للشركات مع عقوبة سجن لمدة 5 سنوات.
وغني عن البيان أن المشرع المغربي أوجد ترسانة قانونية كغيره من التشريعات على ما ينشأ من منازعات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وأوكل للقضاء مهمة الفصل فيها.
لذلك سنحاول الإجابة في (مطلب أول) عن مدى قابلية منازعات الملكية الفكرية للتسوية عن طريق الوسائل الودية لفض المنازعات وخاصة الوساطة، أم أنها تظل حكرا على القضاء خصوصا وان هذا التساؤل يجد مشروعيته في المغرب بعد إصدار القانون رقم 05-08 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، لننتقل بعد ذلك للحديث عن مدى فعالية الوساطة في حل منازعات الملكية الفكرية (مطلب ثان).
المطلب الأول: مدى قابلية منازعات الملكية الفكرية للوساطة
أكد المشرع المغربي كغيره من التشريعات على مبدأ عام وهو أن ما يجوز الصلح فيه تجوز الوساطة فيه، ونصت الفقرة الثانية من الفصل 327-56 من القانون 05-08 على أنه: “لا يجوز أن يشمل اتفاق الوساطة مع التقيد بمقتضيات الفصل 62 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، المسائل المستثناة من نطاق تطبيق ولا يجوز إبرامه إلا مع مراعاة التحفظات أو الشروط أو الحدود المقررة لصحة الصلح بموجب الفصول من 1099 إلى 1104 من نفس الظهير الشريف المذكور “.
وعلى هذا الأساس لا تجوز الوساطة في مسائل الحالة الشخصية، وماله ارتباط بالنظام العام، أو الحقوق الشخصية الخارجة عن التعامل (الفصل 1100 م ق ل ع).
ومادامت منازعات الملكية الفكرية لا تتعلق بمسائل الحالة الشخصية أو الحقوق الشخصية الخارجة عن التعامل يبقى التساؤل الوحيد هل لها علاقة بالنظام العام؟
لقد أثار موضوع قابلية منازعات الملكية الفكرية للحل بواسطة الوسائل الودية ومنها الوساطة الكثير من النقاش الفقهي بين مؤيد ومعارض له، فهناك من يعتبر الأحكام المنظمة لهذه الحقوق من النظام العام وبالتالي لا يجوز الوساطة فيها على اعتبار أن هذه المنازعات سواء كانت داخلية أم خارجية لها طابع جنائي في أكثر الأحيان، وطابع مدني في أقل الأحيان وهي بذلك خارج أي بحث حول قابليتها للوساطة؟ فلا التجارة تطالب بإحالة هذه المنازعات إل الوساطة، ولا طبيعتها تقبل الوساطة؟ فالوساطة بين من ومن؟ بين اللص الذي اغتصب هذا الحق الفكري وبين مالك هذا الحق؟ فهل هذا معقول.
في حين أنكر البعض الآخر عنها صفة النظام العام وأخضعها للوساطة مستندا في ذلك على أن إحالة هذه المنازعات عن طريق الوسائل البديلة مطلوبة على الصعيد الدولي وعلى صعيد عقود استغلال واستثمار هذه الحقوق خاصة وأننا نعيش في زمن العولمة وفي وقت أصبحت فيه هذه الحقوق المحرك الأساسي للتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية لتحقيق النمو والازدهار، ناهيك عن الطبيعة الدولية لهذه الحقوق.
لكن بالرجوع إلى الفقه المقارن نجده يميز بين حالتين:
- الأولى: تتعلق بقانونية وصلاحية هذه الحقوق (شروطها وكذا بطلانها) هي من الأمور التي تدخل في إطار النظام العام وبالتالي فإنها تستثنى من الوساطة.
- الثانية: منازعات التزييف فالفقه أنكر عنها طابع النظام العام، لأنها ترتبط غالبا بالمصالح الخاصة وبالتالي فاللجوء بشأنها إلى الوسائل الودية أو القضاء الخاص أمر جائز بشأنها.
فهذا الصراع الدائر منذ نصف قرن والذي أخذ ذروته في السنين العشرين الأخيرة بين قابلية أو عدم قابلية هذه المنازعات للتسوية بواسطة الوساطة هو في الحقيقة صراع بين حماية هذه الحقوق أو عدم حمايتها، كما أن الفقه المقارن وفي محاولة منه للبحث عن مدى قابلية هذه المنازعات للخضوع للوساطة لم يفصل فيها بالشكل الكافي والسبب في ذلك يرجع في اعتقادي أو في تقديري إلى مسألة أساسية ومشكلة كانت ولا تزال من أهم المشكلات القانونية التي لا تجد لها علاجا سواء عن طريق التشريعات الوطنية أو المعاهدات الدولية، كما لا تزال محل جدل فقهي واسع النطاق هذه المشكلة تتمثل في فكرة النظام العام. وفي غياب تعريف جامع مانع للنظام العام هذا الأخير الذي قيل في شأنه الشيء الكثير فقد عبر عنه بالفكرة الزئبقية وأنه ابن عاق للقانون الدولي الخاص بل شبهها بعض الفقه المغربي بالرمال المتحركة التي تفقد من يخوض فيها السيطرة والاتجاه ([13]).
وعموما ففكرة النظام العام فكرة مرنة تختلف من دولة إلى أخرى وتعد وثيقة الصلة بمصالح الدولة وتبقى لهذه الفكرة أهميتها التي لا يمكن تجاوزها أو تخطيها بفعل الإرادة المنفردة للأطراف، وبالتالي تؤخذ فكرة النظام العام بالمفهوم الذي يتماشى وهاجس حماية المصلحة الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية للمجتمع والأفراد.
ولذلك وبغية التأكد هل لمنازعات الملكية الفكرية ارتباط بالنظام العام لابد بداية من تحديد مختلف أنواع هذه المنازعات ليتسنى لنا فيما بعد معرفة إمكانية الفصل فيها عن طريق الوساطة.
يمكن تقسيم منازعات الملكية الفكرية إلى ثلاثة أنواع:
- منازعات إدارية: ويتعلق الأمر بقرار الرفض الذي لم يصدره المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بخصوص تسجيل طلبات حقوق الملكية الصناعية في إطار سلطه لمراقبة احترام هذه الطلبات للضوابط الشكلية أو لمخالفته لبعض المقتضيات الموضوعية التي نص عليها القانون، فهذا القرار باعتباره قرارا إداريا يقبل الطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة (المادة 15 من ق م ص)، التي هي المحكمة الإدارية بالدار البيضاء التي يقع في دائرة نفوذها مقر المكتب.
- منازعات مدنية: رتب التشريع المغربي على غرار باقي التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية جزاء مدنيا على الاعتداء الواقع على أي حق من حقوق الملكية الفكرية إذا ثبت مسؤولية فاعله عن الضرر وصح إسناد الخطأ إليه يستوي في ذلك أن تكون المسؤولية عقدية أم تقصيرية (دعوى التزييف). هذا ولا تقتصر المنازعات المدنية على الدعاوى السابقة بل تتعداها إلى المنازعات الناشئة عن عقود استغلال وترخيص وبيع ورهن أحد حقوق الملكية الفكرية (الدعاوى الناشئة عن عقود استغلال حق من حقوق الملكية الفكرية). وكذلك حين يستخدم التاجر لوسائل منافية لمبادئ الشرف والاستقامة التجارية عن طريق استعمال الغش والخداع والتضليل في مزاحمة غيره من التجار على اجتذاب الزبائن على نحو يؤدي إلى إلحاق ضرر بأحدهم أو ببعضهم (دعوى المنافسة غير المشروعة).
ولذلك يمكن تقسيم المنازعات المدنية إلى ثلاث دعاوى وهي كالآتي:
- دعوى التزييف أو التقليد المدنية الناتجة عن اغتصاب حق من حقوق الملكية الفكرية،
- دعوى المنافسة غير المشروعة،
- الدعاوى الناشئة عن عقود استغلال حق من حقوق الملكية الفكرية.
- منازعات جنائية: لم يكتف المشرع بالحماية المدنية بل أضفى على هذه الحقوق حماية جنائية ليجعلها أكثر أمنا وبمنأى عن أي اعتداء، وحتى لا تبقى المقتضيات المتعلقة بها حبرا على ورق ذلك أن العقوبة الجنائية تعد أداة قوية لردع المعتدي.
لكن ما ينبغي إثارته بخصوص الحماية الجنائية أن المشرع المغربي لم يعطي للنيابة العامة الحق في أن تقوم تلقائيا وبدون تقديم شكاية من جهة خاصة أو من صاحب الحق بمتابعة كل مساس بحقوق الملكية الفكرية، وإنما أقام تفرقة بين هذه الحقوق ولم يجعلها على شاكلة واحدة، ففرق بين حقوق الملكية الصناعية وبين حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
* ففيما يتعلق بحقوق الملكية الصناعية فالمادة 205 لا تجيز إقامة الدعوى العمومية إلا بشكوى من الطرف المتضرر يقدمها إلى النيابة العامة المختصة بتلقي الشكايات، إذن فالشكوى شرط لازم لإقامة الدعوى العمومية في هذه الجرائم، لكن المشرع أجاز استثناء للنيابة العامة في حالات عددها على سبيل الحصر أن تأمر تلقائيا بمتابعات ضد كل استعمال أو نشر حق من حقوق الملكية الصناعية مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، أو كل مساس بالعلامة التجارية المسجلة في قانون 05-31.
* أما فيما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فقد أعطى المشرع الحق للنيابة العامة ودون تقديم شكاية من أي جهة خاصة أو من صاحب الحق أن تأمر تلقائيا بمتابعات ضد كل مساس بهذه الحقوق (المادة 65.2).
بعدما قمنا بتحديد مختلف أنواع منازعات الملكية الفكرية يمكن أن ننتقل إلى السؤال المحوري والمتعلق بمدى قابلية هذه المنازعات للوساطة أم أن هذه المنازعات تبقى حقول ممنوع على الوسائل الودية ومنها الوساطة التجول فيها؟
وبذلك وحسب تحديدنا السابق لمنازعات الملكية الفكرية المومأ إليها أعلاه نصل إلى أن:
- المنازعات الإدارية: هي من الأمور التي تدخل في إطار النظام العام ولذلك تستثنى من الوساطة،
- المنازعات المدنية: ليس هناك ما يمنع من إخضاعها للوساطة بل إن حلها عن طريق الوساطة فيه مزايا عديدة سنحاول إبرازها في المطلب الموالي،
- المنازعات الجنائية: إذا كان تحريك المتابعة يتوقف على شكاية المتضرر فلا ضير عليها أن تم إخضاعها للوساطة ويكون اتفاق الوساطة جائز ومعطل للدعوى العمومية، أما إذا كانت النيابة العامة تحرك المتابعة تلقائيا ودون حاجة لشكاية المتضرر فهنا يصعب إخضاع هذه المنازعات للوساطة ففكرة النظام العام تبرز هنا في الأفق ولا يمكن أن يكون تحديد الجرائم والعقوبات والأشخاص المسؤولين عنها موضوع اتفاق وساطة أو تحكيم وذلك للأسباب الآتية:
أن النيابة العامة تمثل المجتمع وسلطات الدولة وكذا حقها في العقاب المنع لا يسري على الوسطاء أو المحكمين فقط بل يتعداهم إلى المحاكم المدنية التي لا يمكنها أن ثبت في المسائل الجنائية.
من غير المقبول والمنطقي أن يقضي الوسيط وهو شخص خاص بعقوبة جنائية.
بعدما قمنا باستعراض مدى قابلية هذه المنازعات للوساطة لا بد أن ندلي بتجارب الدول المقارنة على اعتبار أن المقارنة مفيدة في هذا المجال ولبيان أن العقبات والحواجز التي كانت تعترض الوساطة والتحكيم في منازعات الملكية الفكرية آخذة في الزوال والتساقط.
- التجربة الفرنسية:
ففي إطار تحكيمات غرفة التجارة الدولية بباريس وفي سنة 1993 عرض نزاع على هذه المحكمة أثار حينذاك المدعى عليه بصفته يتمتع بحق استغلال على براءة اختراع عدم قابلية النزاع للتحكيم وفقا لقانون براءات الاختراع الفرنسي الصادر سنة 1968 وطالب بكون المحاكم القضائية الفرنسية هي صاحبة الاختصاص الحصري، فرد عليه الحكم التحكيمي دفعه على اعتبار أن: “القاضي الفرنسي مختص وحده بالنظر في صحة منازعات صحة وإبطال براءة الاختراع، ولكن المحكم يبقى مختصا لحسم خلافات استثمار براءة الاختراع “. ولا حظ المحكم أن النزاع المعروض عليه هو نزاع يتعلق بفسخ عقد استغلال استئثاري على براءة اختراع.
وفي دعوى أخرى عرضت أمام نفس الغرفة طالب فيها المدعي بصفته مالك براءة اختراع، مستغل هذه الأخيرة بتعويضات كبيرة نتيجة خطأ هذا الأخير بسبب عدم دفعه الرسوم السنوية المترتبة عن استغلال هذا الحق، وهو خطأ أقضى إلى سقوط الحق بالبراءة ذاتها، مما يجعل المحاكم القضائية وحدها صاحبة الاختصاص، فأجابته المحكمة بعدم اختصاصها البث في هذا النزاع معتبرة أن الاختصاص ينعقد للغرفة على أساس شرط التحكيم المضمن في العقد أولا، وعلى أساس أن النزاع ليس متعلقا بصحة براءة الاختراع وإنما يدور حول استغلالها ثانيا وهو ما لا يتنافى وطبيعة الوسائل الودية مما يعطي الحق للمحكم بالسير في إجراءات هذا التحكيم ([14]).
وفي حكم آخر صدر في 24 مارس 1994 عن محكمة استئناف باريس أكد فيه القضاء الفرنسي أن المبدأ العام الذي يمنح الاختصاص لقضاء الدولة لا يشكل أي عقبة أمام اللجوء إلى الوسائل الودية ماعدا في المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام، وبذلك فالمنازعات المتعلقة بعقود استغلال واستثمار البراءات سواء تعلق الأمر بتنفيذها أو تفسيرها فهي قابلة للتسوية بواسطة الوسائل الودية.
وفي نفس السياق يرى الفقه الفرنسي ممثلا في فيليب فوشار أن الاجتهاد الفرنسي الحديث أخد يفرق بين المنازعات التعاقدية العائدة لاستغلال واستثمار حقوق الملكية الفكرية ويعتبرها قابلة للوساطة أو التحكيم، وبين المنازعات المتعلقة بصحة هذه الحقوق والتي تعد من الاختصاص الحصري للقضاء وتعتبر بذلك غير قابلة للوساطة.
ومجمل القول نصل إلى أن الأحكام السابقة تعطي صورة واضحة لوضع الاجتهاد القضائي الفرنسي حول قابلية عقود استغلال واستثمار حقوق الملكية الفكرية وأن هذه العقود تنتج كافة آثارها ومنها اللجوء إلى الوساطة.
- التجربة السويسرية:
يعتبر القانون السويسري من بين القوانين الرائدة في مجال فتح الباب على مصراعيها لقبول الوسائل الودية ومنها التحكيم والوساطة في منازعات الملكية الفكرية (المادة 177)، فقابلية هذه المنازعات لا تطرح إلا حين يطرح أحد الأطراف موضوع صحة الحق، وحتى في هذا الإطار يعطي النظام القانوني السويسري للوسطاء أو المحكمين الحق في إبطال سند ملكية هذا الحق إذ يمكن أن يكون أساسا لشطب وبطلان هذا الحق ([15]).
أما إذا عدنا إلى القانون الألماني والإيطالي فنجدهما لا يذهبان موقف القانون السويسري في منازعات إبطال حق من حقوق الملكية الفكرية التي تبقى من اختصاص القضاء وحده باعتبارها غير قابلة للمصالحة.
- التجربة الأمريكية:
منذ صدور حكم ميتسوبيشي سنة 1985 عن المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية فإن أبوب الوسائل الودية فتح أمام منازعات الملكية الفكرية. فموضوع قابلية هذه المنازعات حسم على صعيد الاجتهاد القضائي ثم بعد ذلك أكده المشرع الفدرالي بصدور قانون البراءات وأجاز صراحة إخضاع هذه المنازعات للتسوية عبر الوسائل الودية بما في ذلك المنازعات العائدة لصحة البراءة وتقليدها.
بل أكثر من هذا ذهبت المحكمة العليا الأمريكية وأجازت للمحكم سلطة فرض عقوبات شبه جزائية في مادة المنافسة، ومنحته الحكم على أحد الأطراف الذي استعمل تصرفا خداعيا أو احتياليا معاقب عليه قانونا فرض عقوبة التعويض المضاعف ثلاث مرات استنادا إلى إرادة الأطراف التي اتجهت إلى منح المحكم مثل هذه السلطة وذلك في قرارها الصادر سنة 1995 ([16]).
المطلب الثاني: مدى فاعلية الوساطة في حل منازعات الملكية الفكرية
يلقى نظام الوسائل الودية لفض المنازعات ومنها الوساطة هجوما يبلغ حد العنف أحيانا وخاصة في الدول النامية، فيرى البعض أن الوسائل الودية (بمفهومها التقليدي) وان كانت أسبق في الظهور من القضاء، فإن مرجع ذلك يتمثل في تأخر ظهور الدولة بسلطاتها الثلاث، فالقضاء هو سلطة من سلطات الدولة تحقق من خلالها وظيفة إقامة العدالة، وهي وظيفة لا يصح أن يترك أمرها للأفراد، والا سادت الفوضى وضاعت حقوق الضعفاء.
فنظام الوسائل الودية إذا كان ضروريا فهو شر لا بد منه لذلك يجب أن يظل له طابع الاستثناء، فكل القواعد والأحكام التي يكرسها هذا النظام هي من صنع الدول المتقدمة، بل أسهمت وتسهم في تكوين أدبياتها الشركات المتعددة الجنسيات، ولا يحكمها في ذلك إلا تحقيق مصالحها دون اعتداد بمصالح الدول النامية، فنظام الوسائل الودية هو آلية من آليات النظام العالمي الجديد يستخدمها لضمان ريادة وزعامة دول الشمال المتقدم وبقاء تخلف وتبعية الجنوب المتخلف، فالمقصود بهذا النظام هو منع القضاء الوطني من النظر في منازعات الملكية الفكرية فهو بمثابة ” طوق النجاة ” الذي يمكن الشركات العالمية المالكة لمعظم هذه الحقوق من بسط سيطرتها وتحصين نفسها ضد نزعات القاضي الوطني وتشدد القوانين في دول العالم الثالث.
لكن هذا الرأي لا يخلو من المبالغة، فالنظرة الموضوعية تكشف عن أن بطء إجراءات التقاضي وتعدد درجاته وتعقد مساطره وارتفاع تكاليفه في الدول المتقدمة بوجه خاص، يجعل الوسائل الودية أكثر ملائمة، ففتح باب الوساطة يسهم في حل مشكلة منازعات الملكية الفكرية خاصة مع توقع ازدياد الوعي بهذا النظام ومزاياه التي تكمن في الآتي:
السمة الدولية لمنازعات الملكية الفكرية
تميل منازعات الملكية الفكرية في غالبيتها إلى السمة الدولية بحيث يجري تصنيع منتج معين في بلد تحت علامة تجارية، ويتم وضع نموذجه أو رسومه في دولة ما، وتعتمد فيه مبتكرات براءة اختراع مسجلة في دولة أخرى، وهذا حال أغلب حقوق الملكية الفكرية أو بالأخص الصناعية، فنزاع من هذا القبيل يطرح أكثر من إشكال فأين يجب أن تقام الدعوى؟ وفي أي بلد؟ ومن هم القضاة الذين سينظرون في النزاع ووفقا لأي نظام قانوني؟ وكم سيدوم حل هذا النزاع؟
أليست بالفعل حقوق الملكية الفكرية في منازعاتها الدولية مهددة بالضياع إذا أقفل باب الوسائل الودية لفض المنازعات وخاصة الوساطة. فالقانون يتطلبها والعدالة تقتضيها والمصلحة العامة تستوجبها ويجد أطراف النزاع في الوساطة خيار أفضل وفيه نستغني عن الإشكالات القانونية المثارة أمام القضاء.
- ضمان استمرارية العلاقات التجارية:
تنشأ منازعات الملكية الفكرية عادة بين شركات كبيرة وهذه الشركات في معظم الأوقات ترتبط مع بعضها البعض بعلاقات تجارية مستمرة، وان أهمية استمرار هذه العلاقات بين الأطراف تكون محور هام، لذلك فهناك حرص شديد للوصول إلى تسويات ودية والوساطة من الممكن أن تقدم نهجا تعاونيا وديا لتسوية هذه الخلافات إلى جانب تقييم الاعتبارات التجارية عوض القانونية فالأولوية في التجارة للمصالح الاقتصادية وليس للقواعد القانونية كما هو الحال في منازعات عقود نقل التكنولوجيا وعقود تراخيص المنصبة على حقوق الملكية الفكرية.
- ضمان السرية:
إن قضايا الملكية الفكرية تعتمد بشكل رئيسي على السرية التامة فهذه الأخيرة غاية في الأهمية بالنسبة لقضايا الملكية الفكرية، فالأطراف غالبا ما يودون الحفاظ على عدم إفشاء موضوع النزاع لئلا يؤثر ذلك على سمعتهم التجارية أو سمعة المنتج، فالمستثمرون لا يسعون للحصول على تراخيص استغلال أثير نزاع حولها أو أثير تشويش حول المنتج الذي تمثله. هذا بالإضافة على أن عرض مثل هذه المنازعات على القضاء يقتضي بالضرورة التعرض إلى بعض الجوانب التي قد تعتبر من الأسرار التي يحرص مالك الاختراع أو العلامة التجارية على عدم اطلاع الغير عليها، فمبدأ علنية الجلسات أمام القضاء يقوض هذه السرية، وبالتالي تكون الوساطة أضمن وأفضل لتفادي أي كشف للأسرار.
وقد كرس المشرع المغربي هذا المبدأ في الفصل 66-327: “يلتزم الوسيط بوجوب كتمان السر المهني بالنسبة إلى الأغيار وفق المقتضيات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المتعلقة بكتمان السر المهني….”
- ضمان النظر في منازعات الملكية الفكرية من قبل خبراء:
إن منازعات الملكية الفكرية تكون عادة معقدة وتحتوي على مستوى عال من التكنولوجيا المتطورة مما يجعلها معقدة الحل وتحتاج في هذه الحالات لتدخل خبراء في مجال المنازعة ذاتها، خصوصا وان هذه الخبرات ليست متوفرة لدى أجهزة القضاء الوطني، حيث لحد الآن لا نتوفر على قضاء متخصص في الملكية الفكرية، وبالتالي فمن خلال الوساطة يستطيع أطراف النزاع التأكد من أن قضيتهم ستسمع من قبل وسيط ذوي خبرة في مجال المنازعة موضوع الدعوى.
- ضمان السرعة واختصار الوقت:
يعد عامل الوقت من العوامل المهمة في منازعات الملكية الفكرية لارتباط هذه الأخيرة بالتطور التكنولوجي المتسارع ولذلك فلجوء الأطراف إلى القضاء الوطني قد يؤخر البث في النزاع ويستغرق وقتا طويلا نظرا لبطء إجراءات التقاضي وتعقد المساطر والصعوبة في تنفيذ الأحكام بالإضافة إلى كثرة طرق الطعن، وفي انتظار الفصل في النزاع قد تصبح التكنولوجيا المتنازع عليها متهالكة أو متجاوزة إن صح التعبير، وبالتالي تفقد قيمتها لذلك يجد الأطراف في الوساطة اختصار الكثير من الوقت والجهد والنفقات من خلال إنهاء الدعاوى في مراحلها الأولى، وهذا ما نص عليه المشرع المغربي في المادة 327-65 حيث لا تتجاوز مدة الوساطة مبدئيا ثلاثة أشهر إلا إذا اتفق الأطراف على تمديدها.
- ضمان محدودية التكاليف:
إن تسوية منازعات الملكية الفكرية عن طرقي القضاء العادي تكون باهظة التكاليف بشكل عام وخاصة في الدول التي تفرض رسوم عالية للتقاضي أمام محاكمها، أو تلك التي تكون فيها أتعاب المحامين مرتفعة، ناهيك أن هذه الرسوم ترتفع كلما تعقدت الإجراءات والخبرات عندما يتعلق النزاع بأمور ذات تقنية عالية في حين يكون إتباع طريق الوساطة أقل كلفة من التقاضي.
- خلق بيئة استثمارية جاذبة.
- الحلول الخلاقة التي يمكن التوصل إليها:
تساعد جلسات نظام الوساطة على تجاوز العقبات وتوفير الحلول الخلافة والإبداعية لحل النزاع، فلقد عرضت الوساطة أفكارا جديدة لحل الخلافات التجارية تعطي فيها الأولوية لإعداد مشترك للقرارات الضرورية في إعادة تنظيم هذه العلاقات أكثر من الاهتمام بالمطالبة بالحقوق الفردية. كما يمثل نظام الوساطة ضمانا له مفعول أكثر من قرار المحكمة، لأنها تكون مبنية على الواقع الحقيقي للأحداث، بينما يشوه هذا الواقع عندما يعرض أمام القاضي، لذا يمكننا القول بأن هذا النظام أقرب إلى الواقع من القضاء.
- المرونة:
تتسم إجراءات هذا النظام بالمرونة لعدم وجود إجراءات وقواعد مرسومة محددة، وهو ما من شأنه أن يسمح للأطراف بحل نزاعاتهم على المقاس الذي يرغبون فيه.
- تحقيق مكاسب مشتركة لطرفي النزاع:
فالتسوية النهائية لهذا لنظام الوساطة قائمة على حل مرضى لطرفي النزاع.
- تنفيذ اتفاقية التسوية رضائيا:
لما كانت اتفاقية التسوية في الوساطة من صنع أطراف النزاع فإن تنفيذها على الأغلب سيتم برضاهم بعكس حكم القضاء الذي يتم تنفيذه جبرا.
بما أن موضوعات الملكية الفكرية تعتبر كما أشرنا في المقدمة من المواضيع القانونية الحديثة فإن التشريعات المتعلقة بها مازالت بحاجة إلى الصقل والتطوير سواء في الدول التي تعتمد القانون المكتوب أو تلك التي تعتمد نظام السوابق القضائية، لذلك تكون الوساطة وسيلة مناسبة لتنظيم مثل هذه المجالات في انتظار إيجاد قضاء متخصص.
في الحقيقة أصبح التخلي عن حل منازعات الملكية الفكرية عن طريق القضاء العادي أمرا مطوبا وضرورة ملحة، فالدعوى في نهاية المطاف هي معركة فيها غالب ومغلوب، أما روح الوساطة ففيها رابحان معا، لكن إذا كانت الحجج التي سقناها في هذا المطلب ترجح كفة الوساطة على كفة القضاء العادي، إلا أنه بالطبع في أحيان أخرى فاعتبارات عدة قد تجعل الأطراف ينشدون نار المحكمة ويفضلونها على جنة اللجوء إلى الوساطة خصوصا في الحالة التي تكون فيها مصلحة أحد الأطراف تقتضي الحصول على حكم المحكمة ليشهره في وجه كل من سولت له نفسه الاعتداء على حقه الفكري، أو في الحالة التي يكون فيها أحد الطرفين غير متعاونا تعاونا كاملا كما يحدث عادة عند تواجد اختلال التوازن العقدي بين الأطراف كما هو الشأن في عقود نقل التكنولوجيا حيث يسعى أحد الأطراف إلى ترسيخ سابقة قانونية تولد الحق.
خاتمة:
إن الإدراك الكامل لمزايا الوساطة يستلزم ثقافة قانونية منفتحة، فالرهان مقبول، ونجاح التجربة رهين بتوعية الفاعلين في الحقل القضائي والقانوني والمجتمع المدني، والمشاركة الإيجابية لوسائل الإعلام وتوافقها مع التقاليد المحلية الخاصة. وهو ما ينقلنا من القانون المفروض إلى القانون القابل للمفاوضة، وبذلك ننتقل من عدالة صارمة إلى عدالة أكثر ليونة وذلك عن طريق تفعيل تطبيق أسلوب الوساطة باتخاذ مجموعة من الإجراءات:
- نشر وترسيخ ثقافة هذا النظام نظريا وممارسة،
- إيجاد مؤسسات أو أشخاص أكفاء ومؤهلين للقيام بهذا النظام،
- اقتناع الأطراف بجدواه،
- المساهمة في إنعاش الوسائل الودية لفض المنازعات،
- المساهمة في خلق جو من الثقة والاطمئنان الملائم لتحريك الادخار الوطني وجلب الاستثمار الأجنبي عن طريق فض المنازعات بالوساطة،
- المساهمة في مسيرة بناء التنمية الشاملة والجهوية والحكامة الجيدة عبر إنعاش الوسائل الودية لفض النازعات،
- نسج علاقات عمل وشراكات بين الجامعيين ورجال الأعمال والمستثمرين وأسرة القضاء.
ويتطلب إنجاح هذا النظام تحقيق مجموعة من الضمانات منها:
- ضمان النزاهة الذي يتطلب احترام موافقة الأطراف المتنازعة،
- ضمان السرية،
- ضمان الحياد واستقلالية الوسيط،
- ضمان أشكال الاتفاق.
[1] هذا وقد ورد الحث على الصلح في العديد من الآيات القرآنية ومنها قوله تعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ” الآية 223 من سورة البقرة.
[2] للمزيد من التفصيل حول التطور التاريخي للوسائل البديلة راجع:
عبد الحميد الأحدب، منازعات الملكية الفكرية، ورقة عمل مقدمة لمركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي في ندوة حول “التراخيص في مجال الملكية الفكرية وتسوية المنازعات الناشئة عنها” 9 -20 مارس 1998
[3] هناك من يعرفها بكونها وسائل أو عمليات مختلفة تستخدم لحل المشكلات أو المنازعات خارج نطاق المحاكم والهيئات القضائية الرسمية.
[4] ينص الفصل 327-55من قانون المسطرة المدنية: “يجوز للأطراف لأجل تجنب أو تسوية نزاع، الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي النزاع “.
وفي هذا المعنى يقول الأستاذ Fouchard:
“La mission du conciliateur se limite à tenter de concilier les parties, ou à s’efforcer de les amener à une solution mutuellement acceptable. Les propositions ou recommandations qu’il leur présente après l’instruction de l’affaire n’ont aucun caractère obligatoire, elles ne l’acquièrent que si et lorsque les parties les ont acceptées ” FOUCHARD (ph) L’arbitrage judiciaire ; in ; Etudes offertes a pierre BELLETT ; Litec ; paris 1991 ; p 167.
[5] وان كان البعض يرى أنه يمتنع على الوسيط حتى القيام بطرح حلول بديلة على الأطراف، إذ أن دوره في هذه الحالة ينقلب لدور الموفق وتنقلب العملية إلى التوفيق (Conciliation).
[6] من الملفت للنظر أن الوساطة تنجح في حل حوالي %75 إلى 90% من الخلافات التي يتفق الأطراف على حلها باستعمال هذه الآلية، فهي الأساس الذي يقوم عليه نظام (ADR) في التجارة الدولية، فهي الوسيلة أكثر في نصف العقود التجارية الدولية الكبيرة مثل عقود الإنشاءات الدولية.
7. وتتخذ الوساطة أشكالا عديدة في القوانين المقارنة عكس التشريع المغربي فهناك: الوساطة البسيطة (Simple) mediation وهي التي تقترب من نظام التوفيق في وجود شخص يسعى إلى التقريب بين وجهات نظر المتنازعين. وهناك الوساطة تحت شكل قضاء صوري وهي التي يتم فيها تشكيل هيئة يرأسها الوسيط تضم وكلاء عن أطراف النزاع وذلك للوصول إلى حد مقبول من الطرفين. وهناك الوساطة الاستشارية (Mediation-Consultation) وهي التي يطب فيها أطراف النزاع من محام أو خبير استشارته أولا في موضع النزاع ثم يطلبون منه بعد ذلك تدخله كوسيط لحل النزاع. وهناك وساطة التحكيم (Mediation- Arbitration) وهي التي يتفق فيها الأطراف على قيام الوسيط بمهمة التحكيم إذا فشلت مهمته في الوساطة، وهناك أخيرا الوساطة القضائية (Judicial- Mediation) وهي المعمول بها في النظم الانجلوسكسونية حيث تقوم المحاكم قبل الفصل في النزاع بعرض اقتراح على الأطراف باللجوء بداية إلى الوساطة، وذلك كما هو الحال في النظام المعروف باسم (Summary Jury Trial) حيث يقوم المحلف المدني (Civil Jury) قبل الجلسة الرسمية بشرح مختصر للأطراف عن الموقف في الدعوى، ويتوصل معهم إلى إصدار حكم في شكل رأي (Advisory Verdict) يكون بمثابة الأساس الذي تقوم عليه المفاوضات في الوساطة.
[7] وان كان البعض يرى أنه يمتنع على الوسيط حتى القيام بطرح حلول بديلة على الأطراف، إذ أن دوره في هذه الحالة ينقلب لدور الموفق وتنقلب العملية إلى التوفيق (Conciliation). انظر نحو دراسة مفصلة للصور المختلفة للوساطة:
Jean- claude Goldsmith, “les modes de règlement amiable des différends.” Rdal.1996, p.221
[8] هكذا أقرت منظمة التجارة العالمية آلية لفض النزاعات التي قد تحدت بين الدول تعتمد على مبدأ المصالحة الدولية كآلية أساسية ينبغي اللجوء إليها أولا، ولا يتم اللجوء إلى التحكيم إلا بعد إخفاق المشاورات، كذلك أقرت المادة 67 من الشروط العامة للاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين المعروف باسم -fidec – حيث تنص على اللجوء إلى الوساطة قبل اتخاذ طريق التحكيم.
[9] تفيد الإحصائيات أن 6% من حجم التجارة العالمية يعتمد على التقليد والغش والقرصنة، كما أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ذلك ما بين 20 إلى 60 مليار سنويا.
[10] مصطفى محمد عز العرب، اتفاقيات التربس: آليات الحماية وبعض معارضات الدول النامية، المرجع السابق، ص 209.
[11] من بين الأمور التي اهتمت بها جولات تعديل اتفاقية “الجات” إعادة النظر في نظام فض المنازعات بين الدول الذي كانت قد أرسته اتفاقية اللجان 1947 فكان من تم من بين الاتفاقيات التي ألحقت بمعاهدة مراكش مذكرة الاتفاق المتعلقة بالأحكام والمساطر المطبقة على النزاعات وهي مسطرة تنطبق على كافة الاتفاقات المنبثقة عن تلك المعاهدة.
[12] -Méorandum d’accord concernant les règles et procédures régissant les différentes
بالفرنسية
– Understanding on Rules and Procedures Governing the settlement of Disputes
بالإنجليزية
[13] د، عبد الله درميش، التحكيم في نزاعات الشغل، مجلة المحاكم المغربية، عدد 84 ص 39.
[14] Bulletin cour Internationale d’arbitrage CCI oct. 1993 VOL 4 N
[15] د، عبد الحميد الأحدب، دور التحكيم في فك منازعات الملكية الفكرية، ص 10.
[16] د، محمد أبو العينين، قابلية المنازعات للتحكيم، سلسلة دفاتر المجلس الأعلى للتحكيم التجاري الداخلي والدولي عدد 2005.6 – ص 90.